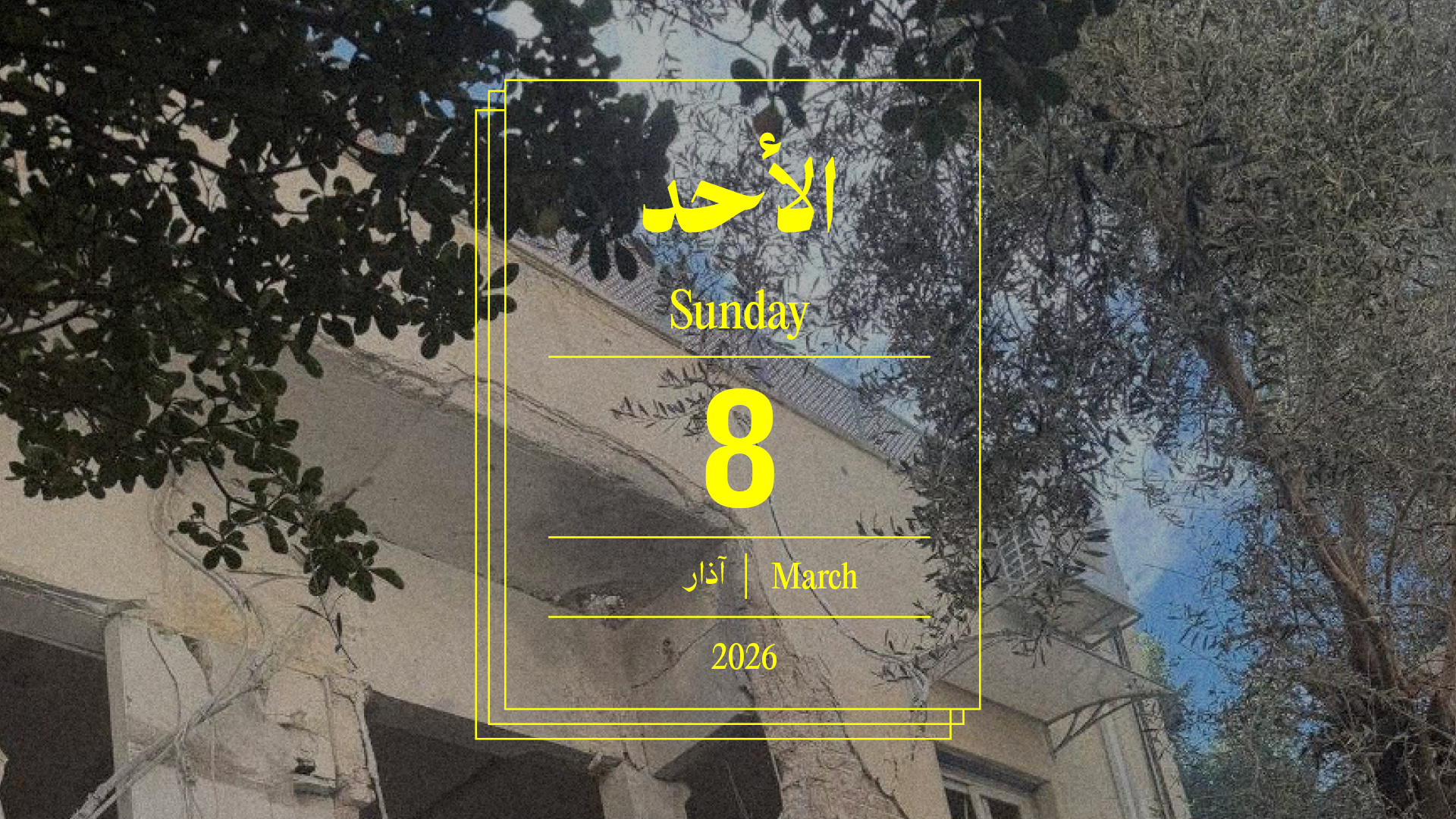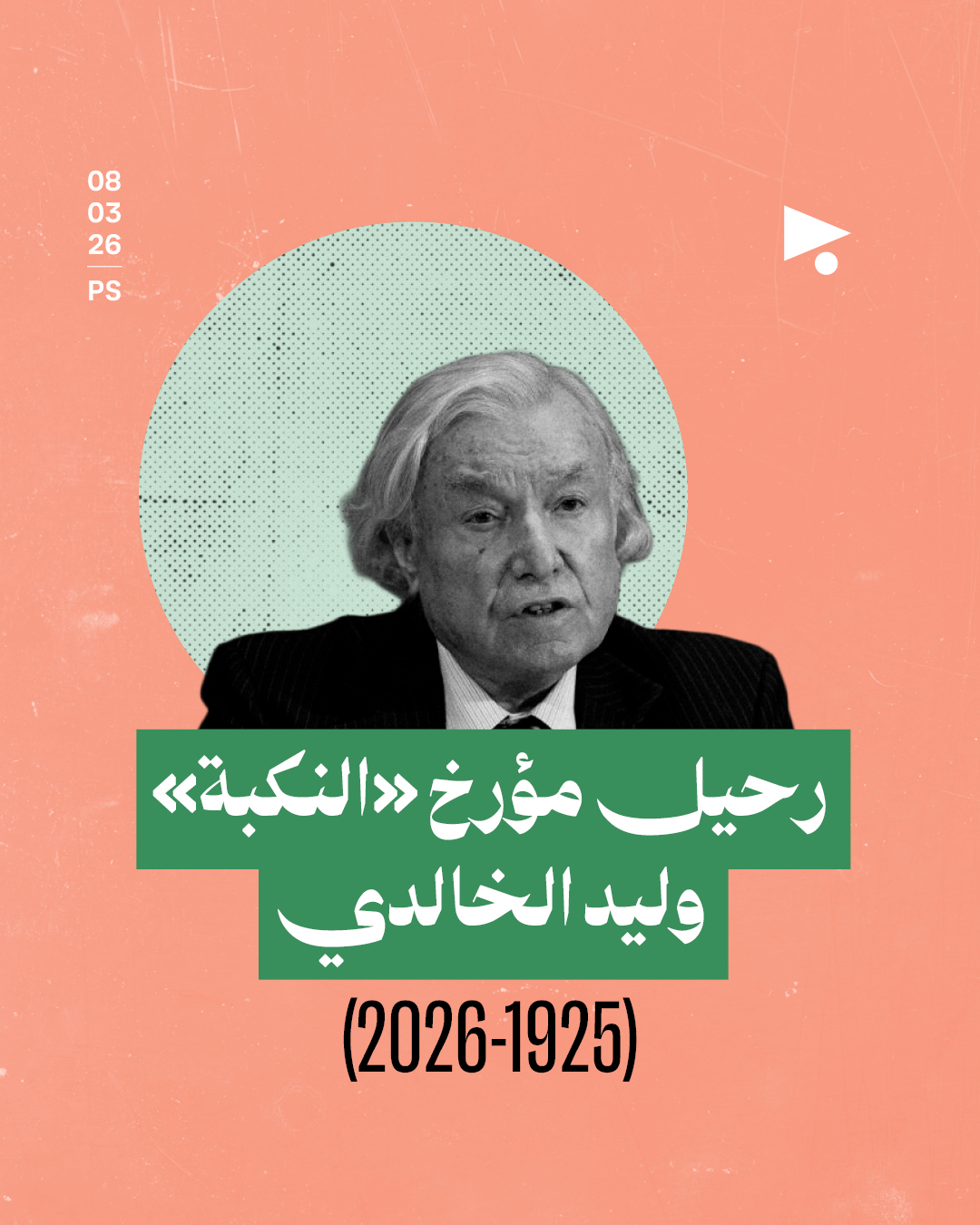يتناول الفيلم كارثة الحرب وما بعدها، إلا أنه لا يزال يُضفي معنى على زمن الكارثة المتجدّد، بعد ستّ سنوات على كارثة 2019 الاقتصادية وتبعاتها. فها نحن في بيروت 2026 حيث أشباح الكارثة الأخيرة تتزاحم مع أشباح الكارثة التي سبقتها، فنعيد طرح السؤال نفسه: من نكون بعد كل هذا الفقد؟ وكيف نستعيد ذواتنا من حطام الماضي، القريب والبعيد، وربما الآتي؟
قد ما في أشباح بالذاكرة / ضاقت حارة الأحياء
— الراس
ما معنى أن نتبع شبحًا؟ وماذا لو كان ذلك يعني، في الحقيقة، أن يكون هو الذي يتبعنا دائمًا، وربما يضطهدنا بفعل المطاردة نفسها التي نقوم بها نحوه؟
— جاك دريدا، Spectres de Marx
هل كان خليل (عوني قواص) هو من سرق الخزنة التي خبّأت فيها مجموعة من الأصدقاء غنيمة سطوهم على مصارف سعياً لتمويل نشاطاتهم الثورية؟ لا يتمحور فيلم أشباح بيروت (1998) لغسان سلهب على هذا السؤال، إلا أن الإجابة عليه تصبح هاجساً يُقلق الأصدقاء وهم يطاردون رجلاً يشبّهونه بصديقهم خليل الذي ظنّوه ميتاً. كان الأصدقاء قد فقدوا محتويات الخزنة مع اختفاء خليل عقب اشتباكات دامية. أما وقد رأوا طيف صديقهم الميت، صار لغز اختفاء الخزنة أكثر الحاحاً، أكثر ارتباطاً بذلك الميت-الحيّ الذي يطوف في بيروت الحرب الأهلية.
في الفيلم زمنان، زمن السنة الأخيرة للحرب، وزمن السنوات الأولى لفترة «ما بعد» الحرب. في نهاية الثمانينيات، كانت الحرب قد مرّت بكل أطوارها: من حرب ركيزتها إيديولوجية (يمين/يسار، لبناني/عروبي، انعزالي/فلسطيني)، إلى أخرى تلاشت فيها الإيديولوجيا فتحوّلت، تحديداً في بيروت الغربية، إلى «حروب صغيرة» لزعامات وشوارع وميليشيات يسارية وإسلامية وطائفية لم تعد تعرف تماماً لماذا تتقاتل، وباسم ماذا. هو زمن بطيء، يحاول ساكنوه أن يتحايلوا عليه بلعب الطاولة في بهو فندق عريق لم يعد يدخله أيّ سائح، بقدر ما هو زمن متسارع، يحاول ساكنوه أن يلحقوا به وهم يطاردون خليل قبل أن يشلّ حركتهم دويّ انفجار ويلزمهم بالبطء. هو زمن مكرّر، يعود على الإيقاع نفسه، إيقاع التيار الكهربائي الذي ينقطع فيعلق الناس في المصعد وفي الظلمة. ينطلق الفيلم من لحظة إدراك الشخصيات بمعالم زمنهم هذا وبتشرذمهم فيه، أي لحظة بدأوا يشعرون بشرخٍ بين آمالهم الثورية الماضية وما آلت إليه الحرب، لا سيما وأنهم لم يتعافوا بعد من فقدان صديقهم خليل وفقدان الخزنة التي تحوي غنيمتهم.
الخسارات شبحاً
لكن ما قيمة خزنةٍ صغيرة قياساً بسلسلة الخسائر الكبرى التي تكبّدها أهل المدينة؟ لا تكمن أهمية تلك الخزنة في ما تحويه من مال وحسب، بل في ما يدلّ عليه ذلك المال، بوصفه نتاج العمل الثوري (قضية، ثم هدف، ثم تخطيط، ثم تنظيم، ثم نهب) وشرطاً لتمويله ولاستمراريّته في المستقبل. لهذا وُضع المال في خزنة، في مساحة مغلقة ومعزولة، تحجّرت مع الوقت، فصارت في سنوات الحرب الأخيرة تحاكي ما حلّ بالعمل الثوري نفسه: كيانٌ غير قابلٍ للحياة لم تتقبّل المجموعة موته بعد.
تُحيلنا تلك الخزنة إلى بطن الكنائس والمقابر، أي السرداب الذي يحوي التوابيت (la crypte) والمصمّم لتخليد الجثامين، جثامين الأموات الذين يحتلّون مساحةً برزخية بين الحياة والموت. ينظر دريدا إلى تلك البنية الهندسية، فيلحظ كيف أنها تحاكي بنية خفيّة تحتلّ لاوعي الذاتِ على شكل فَقْد أو سرّ لم يكتمل الحداد عليه. يتحوّل المفقود بدوره، كما الجثمان في السرداب، إلى «حي-ميت»، يذكّر الذات بعجزها عن الحداد وينخرها بفعل عنفه المكبوت. فقدت المجموعة نتاج عملها الثوري وشرط إستمراريته من دون أن تتمّ الحداد عليه، فأبقته حيّاً-ميتاً داخل خزنة عادت واختفت بدورها. هكذا صار الماضي الثوري المحكوم بالنقصان لصيقاً بخليل العائد إلى بيروت.
وما الشبح إن لم يكن عائداً؟ يعود خليل من موته المؤكّد، فتبدأ حياته الشبحيّة من لحظة عودته، دون أن تنتهي عندها. فسِمَة الأشباح أنهم يعودون بعد غياب، ثمّ يغيبون قبل أن يظهروا مجدّداً، إلى ما لا نهاية. يغيب الشبح، وعندما يعود، يحتلّ حيّزاً قد تعرّض لصدمة أو هجران، كقصر قديم شهد على جريمة، كبَيْت مهجور شهد على احتراق ساكنيه، أو ربما كمدينة منقسمة على نفسها، شهدت على حطام مستقبل ساكنيها. وكما تفعل الأشباح، يُخيف خليل كل الذين ظنّوه ميتاً.

يبحث الرفاق عن صديقهم المناضل الذي اختفى في معركة دامية، على عتبة إدراكهم لخساراتهم السياسية. تحيلنا هذه الصيغة السردية إلى جبرا إبراهيم جبرا في شخصية وليد مسعود، المثقف الفلسطيني المنفي والذي كان، كما خليل، يقود سيارة «أمركاني» قبل أن يختفي تماماً في مساحة برزخية بين حدود العراق وسوريا، ما جعل أصدقاءه يبحثون عنه أو عن جثته، مهجوسين بكل الأسئلة الذاتية التي طرحها حضوره كما غيابه. «عينك تشوف كيف زرعنا الصور على الحيطان»، يقول أحد أصدقاء خليل معاتباً، بإيماءة إلى خليل أحمد جابر في الوجوه البيضاء لالياس خوري، الذي امتلأت المدينة بملصقات ابنه الشهيد قبل أن تبتلعه بدورها. عودة خليل، كشبح موجود وغير موجود، تحيل أيضاً إلى رواية عزيزي السيّد كواباتا لرشيد الضعيف، حين التقى رشيد مع نهاية الحرب الأهلية بشخص ربّما كان رشيد نفسه، ليفتح هذا اللقاء أسئلة عن الماضي النضالي ومراجعاته. لكن، بالرغم من التقاطعات السردية مع ثنائية الفقد والتحرّي التي أطّرت سرديات الحرب الأهلية، ينطلق فيلم سلهب من السؤال الذي ينتهي عنده جبرا وخوري والضعيف: ماذا لو عاد حقاً من ظننّاه ميتاً؟ ومن نحن بعد كل ذلك الفقدان؟
تحوّل الحداد غير المكتمل لدى أصدقاء خليل إلى حزن مستدخل بات ميلانكولياً، ما جعل الأصدقاء منسحبين من الحياة. فهم، أسوة بخليل، ليسوا أحياءً تماماً، ولا هم أموات — فهذا مكتئب، وهذه عصبية، وذلك مكسور. إلا أن النبض سيعود إليهم لحظة لقائهم الشبح العائد. تبدو في الفيلم لحظة لقائهم بالشبح وكأنها لحظة سابقة للخطاب، لحظة تعجز اللغة عن تمثيلها، فتتجلّى حالاتٍ انفعالية، منها الدهشة والغضب والحزن والخوف والارتياب. يقترب عمر (يونس عودة) ليشمّ خليل، كي يتأكّد أنه ليس خيالاً)، فتتكثّف الأسئلة: ما سرّ عودته؟ وهل سيختفي مجدداً؟
يتكثف وجع الخسارات في الفيلم شاعريةً، شاعرية الخسارة كمفهوم مجرّد، والخسارة كتجربة جمعية، والخسارة كتجربة حميمية، إن كان في الصورة أو في الحوارات المتقطعة، المبتورة. يكفي مثلاً أن تنظري إلى كادر واحد، كمشهد عمر جالساً على سرير خليل في الفندق، كي تغوصي في مستويات الكادر الشعورية: فأنتِ لن تري عمر، بل مجرد انعاكس لصورته على زجاج شرفة الفندق؛ كما أنك لن تري الانعكاس واضحاً بسبب ظلال البحر المتداخلة مع ظله؛ كما أنك لن تري الظلّ كاملاً لأن انعكاسه يقطعه حديد باب الشرفة التي تطل على البحر. هي مستويات شعورية وجمالية مركبة، متراصة، متحاورة، ستعبث بانسيابها إعلانات التلفزيون التي تصدح على إيقاع الرصاص والقصف في الشارع، فيما يجلس صائد الشبح كي يرتاح قليلاً. كل ذلك في في كادر واحد.
ينظر خليل إلى أصدقائه وإلى المدينة المشتعلة، وإلينا نحن، إلا أنه لا يقول الكثير. بعبارة دريدا، ينظر إلينا (nous regarde)، بالمعنيَيْن اللذين تحملهما الكلمة الفرنسية: هو يرانا وهو يخصّنا، أي أنه يحمل سرّاً لنا وعنّا ويدعونا لتتبُّعه (وكأن كاميرا سلهب تشرّبت دريدا في رؤيته لأطياف ماركس ولقراءته لسرداب أبراهام وتوروك). هل لذلك لا يزال الأصدقاء يلاحقون ذلك الشبح؟
الوقوف عند الحطام
يقاطع الزمن الثاني الزمن الأول ويتقاطع معه فيحيلنا إلى منتصف التسعينيات، أي إلى زمن تصوير الفيلم. يرتكز هذا المستوى الزمني إلى سلسلة من المونولوجات يجيب فيها كل من الذين مثّلوا دور الأصدقاء على أسئلة ذاتية حول خياراتهم وآمالهم السابقة كأشخاص حقيقيين انطلاقاً من سؤال سلهب الذي لا نسمع صوته «أين أنت اليوم؟»، وكأنّ المضمر هو سؤال أكثر إيلاماً: من أنت بعد الكارثة؟
فالحرب الأهلية أطاحت بالجميع من دون أن تستثني أحداً. تحوّلت من نزاع لربما كان بالإمكان عقلنته إيديولوجياً إلى آخر قادته عصبيات طائفية أفضت إلى إعادة ترتيب خطوط الصدع الإيديولوجية السابقة للحرب أو إلى تعطيلها كاملة. وبالتالي، فالأصدقاء الذين يعرّفون عن أنفسهم بأنهم «لعبوا دور الثوريين»، لا بدّ أن يكونوا قد وجدوا أنفسهم أمام خسارة مزدوجة بعد نهاية الحرب: من جهة، خسروا إمكانية تحقيق رؤيتهم الثورية، لا بل أدركوا أن تلك الرؤى لطالما كانت واهنة أمام النظام الطائفي؛ ومن جهة أخرى، فقدوا موقعهم في العمل الثوري وهم يشاهدون الأحزاب والمنظمات اليسارية تتآكل وتتآلف مع النظام اللبناني الجديد. فقد جاء زمنُ الطائف وهيمنةُ المنظومة الحريرية التي صادرت السياسة كما التاريخ تحت شعار «بيروت مدينة عريقة للمستقبل». صارت لحظة تعليق الحرب، إذاً، لحظة الانكفاء على الذات والتأمّل بالأسباب التي أدّت إلى تلك الخسارة الفردية والجماعية.
يتحدّث الممثلون عمّا باتوا يدركونه في زمن «ما-بعد» الحرب الأهلية اللبنانية، وهو أن حاضرهم مسكون بماضٍ من العنف لم تُختَم جراحه بعد. يصف كل منهم بكلماته زمن ما بعد الحرب الأهلية على أنه زمن الحطام — حطام المدينة، حطام العلاقات، حطام المستقبل الذي باتوا على يقين في بيروت التسعينيات، بأنه لن يأتي، وذلك أمام عين غسان سلهب المحدِّقة، المُنصِتة، المتعاطفة، الشاعرية. يمكنك، مثلاً، أن تعيدي ترتيب جمل من مشاهد البوح، فتؤلّفي قصيدة ستعيدين كتابتها مرّات عدة وقراءتها كل مرة بشكل مختلف.

نشاهد لحظات البوح تلك وندرك ما حلّ بصيّادي الأشباح الذين كانوا يطاردون خليل: ظنّوا أنهم يلاحقون خليل بوصفه جرحاً من الماضي يجب السيطرة عليه وإغلاق بابه، فيتبيّن أن شبح خليل، أي الخسارة التي لم يكتمل حدادهم عليها بعد، هو الذي يسكنهم. أصبحوا ضحية هذا الماضي الناقص والمبتور الذي بات هو من يطاردهم حتى بعد انتهاء الحرب. «وقت نسمع خبطة الباب، مننط»، يقول أحمد علي الزين، فيما تقول دارينا الجندي «مشكلتنا إنه بدنا ننطلق عن جديد، نخلق عن جديد، رغم إنه نحنا مش حقيقة ميتين. نحنا عمنموت».
من هم «أشباح بيروت» إذاً، إن لم يكونوا أولئك الأحياء-الميتين المطلوب منهم أن يعودوا إلى المدينة وكأن حرباً انتهت، وكأن فقداناً لم يكن؟
وعادت الأشباح
سندرك أن خليل عاد إلى بيروت في مهمة معقدة: يريد أن يشطب اسمه من سجل الأموات ويعيد نفسه إلى سجل الأحياء، بمعنى أنه يعيد كتابة حياته بالمعنيَيْن الحرفي والرمزي بعد أن كان قد محاها طوعاً وإصراراً. تنزاح هوية الشخصيات من أموات إلى أحياء، ومن صائدي أشباح إلى مطاردين بدورهم، فتشكّل منطلقاً لطرح مسألة كتابة الذات وإعادة كتابتها لدى سلهب.
يكتب سلهب الذات بواسطة البوح والحميمية. في الزمن الثاني من الفيلم، يرتكز سلهب إلى المونولوجات الطويلة التي تركن فيها الشخصيات إلى هشاشتها في وصفها للتنافر المعرفي بين ما يقال لها عن زمن السلم، وما تختبره من عنف رمزي في زمن تعليق الحرب؛ كيف بات عليها أن تتصوّر مستقبلها فيما ذاكرتها لا تزال مفقودة؛ كيف صارت مدعوّةً أن تنظر إلى المستقبل فيما أشباح الماضي تلاحقها. الشخصية الوحيدة التي تفضّل الصمت هي خليل-الشبح، ربما لأن سلهب قال كل ما عنده في الفيلم نفسه، بكل تلك الشاعرية، بكل تلك الحميمية. فسلهب، كما كتب في المنشور الذي وزّعه قبيل عرض فيلمه، «كان يبحث في كلماتهم عن كلماته».
يتناول الفيلم الحرب، إلا أنه لا يكتفي بها. هو فيلم عن الحميمية — كيف تتجلّى في الرغبة، في الأخوّة، في الصداقة، في الحب، في الخيبة، في قلق النهايات، ولكن أيضاً في الوسواس. يتخبّط رفاق خليل كما الناس المحيطون به من أصحاب المحال، عمال الفندق، المقاتلين الذين يحومون في الحي، كلهم تجتاحهم البارانويا تجاه ذلك العائد، إلا هناء (دارينا الجندي). فالمصوّرة الحربية التي اعتادت على مطاردة أشباح مدينتها، لم تُبدِ لا دهشةً ولا ارتياباً من الشبح العائد. تقول: «هو بالنسبة إلي، الإنسان الأقرب والأبعد». هل هو الأقرب والأبعد لأن العلاقة التي تربطهما، هي على هذا القدْر من الحميمية، علاقة مشروطة بقَدَر الفقدان وحتمية العودة دوماً؟ فماذا لو لم تكن هناء حبيبة خليل السابقة، بل أخته؟ كيف سنعيد قراءة الحميمية، والخسارة، لا بل الوجع الخالي من الانفعال الذي لا يزال يجمعهما؟
وما الوجع إن لم يكن عصيّاً على التمثيل؟ أن تكوني موجوعة يعني أن تتخبّطي في التعبير عن وجعك، أن تهزأي من محاولات تمثيلك، أن تدلّي على استحالته، مهما أغوتك ضرورته. تعمل هناء مصورةً حربية، تنقل صورة الحرب بعدستها: تلتقط بيروت عن قرب، من أزقتها المدمّرة ووجوه سكانها المختبئين في ملجأ الحي، من بين دويّ انفجاراتها الذي يرصده سلهب في الخلفية وكأنه ساوند تراك الفيلم (والذي يتنافر بدوره مع موسيقى اختارها سلهب بحساسية، وكأنها ساوند تراك حياته). ها هي هناء تناور. تقفز فوق حواجز الميليشيات جنوباً لتلتقط أفق مدينة يلفّها الضباب، مدينة لا تزال ترفض أن يمثّلها أحد. ترسل فيديوهاتها مترجمةً إلى عالم خارجي (أوروبي، أبيض) فقدَ معناه، بل فقدَ قدرته على تقديم معنى لكل ما يحدث. تتساءل هناء عن جدوى نقل الصورة، عن جدوى تمثيل مدينة باتت مسكونة، عن جدوى طرح أسئلة قديمة في زمن معلّق.

هكذا يكون سلهب قد ساهم في منتصف التسعينيات في تأسيس خطاب نقديّ مضادّ، أو على حدّ قول محمد سويد، في أن يكون «السينما وشبحها في آنٍ واحد». فالممارسات التي كانت قد حجّرت العمل الثوري، صارت في الفيلم عوارض خطاب سياسي بائد؛ والخطاب الإيديولوجي الجديد الذي يبشّر بنهاية الزمن الثوري، بدا وكأنه ولد فارغاً. فصار تحجير الإيديولوجيا وتفريغها معاً هدفاً للنقد لدى سلهب الذي يقدّم في الفيلم رؤية مغايرة للسياسي. يكمن السياسي في «أشباح بيروت» تحديداً في خلخلة التسلسل البياني للزمن، في مقاومة تحجير الإيديولوجيا كما في رفض تفريغها، حاملاً بُعداً حميمياً يتوازى فيه الشخصيُّ والسياسيَّ، أو بالأحرى يتّضح فيه مكمن السياسي من خلال العمل على كتابة الذات.
كان «أشباح بيروت» معاصراً في التسعينيات، وما زال معاصراً اليوم. عاد إلينا الفيلم بصيغة رقمية في برمجة سينمائية لنور عويضة بمشاركة أناييس فارين ومهدي عواضة، بعد ثلاثة عقود على انتهاء الحرب. يتناول الفيلم كارثة الحرب وما بعدها، إلا أنه لا يزال يُضفي معنى على زمن الكارثة المتجدّد، بعد ستّ سنوات على كارثة 2019 الاقتصادية وتبعاتها. فها نحن في بيروت 2026 حيث أشباح الكارثة الأخيرة تتزاحم مع أشباح الكارثة التي سبقتها، فنعيد طرح السؤال نفسه: من نكون بعد كل هذا الفقد؟ وكيف نستعيد ذواتنا من حطام الماضي، القريب والبعيد، وربما الآتي؟
بين الكارثة الأولى والثانية، ثلاثون عامًا من الأسئلة المتكررة، ولكن أيضاً ثلاثون عاماً من السينما التي تتناول الحرب الأهلية. يمكننا قراءة فيلم سلهب على أنه مقالة بمعنى essai، عن إمكانية تمثيل الكارثة بمعناها المجرد، تمثيل بيروت زمن الكارثة، تمثيل أشباح بيروت زمن الكارثة، تمثيل الذين لا تزال أشباح بيروت زمن الكارثة تطاردهم اليوم. يعود الفيلم من منتصف التسعينيات ليطارد السينما اللبنانية التي اعتادت، إمّاً مللاً أو استخفافاً، على تحجير تجربة المدينة مع العنف من خلال تفادي الأسئلة الصعبة وتلقيننا إجابات جاهزة عن أسئلة الذاكرة والفقد وأهمية التعايش بين الطوائف. يعود إلينا اليوم شبحاً يسكن المساحات المأزومة والمهجورة من الخطاب النقدي عن بيروت. فالفيلم، كما ينصّ عنوانه، ما هو إلا شبح من أشباح المدينة.