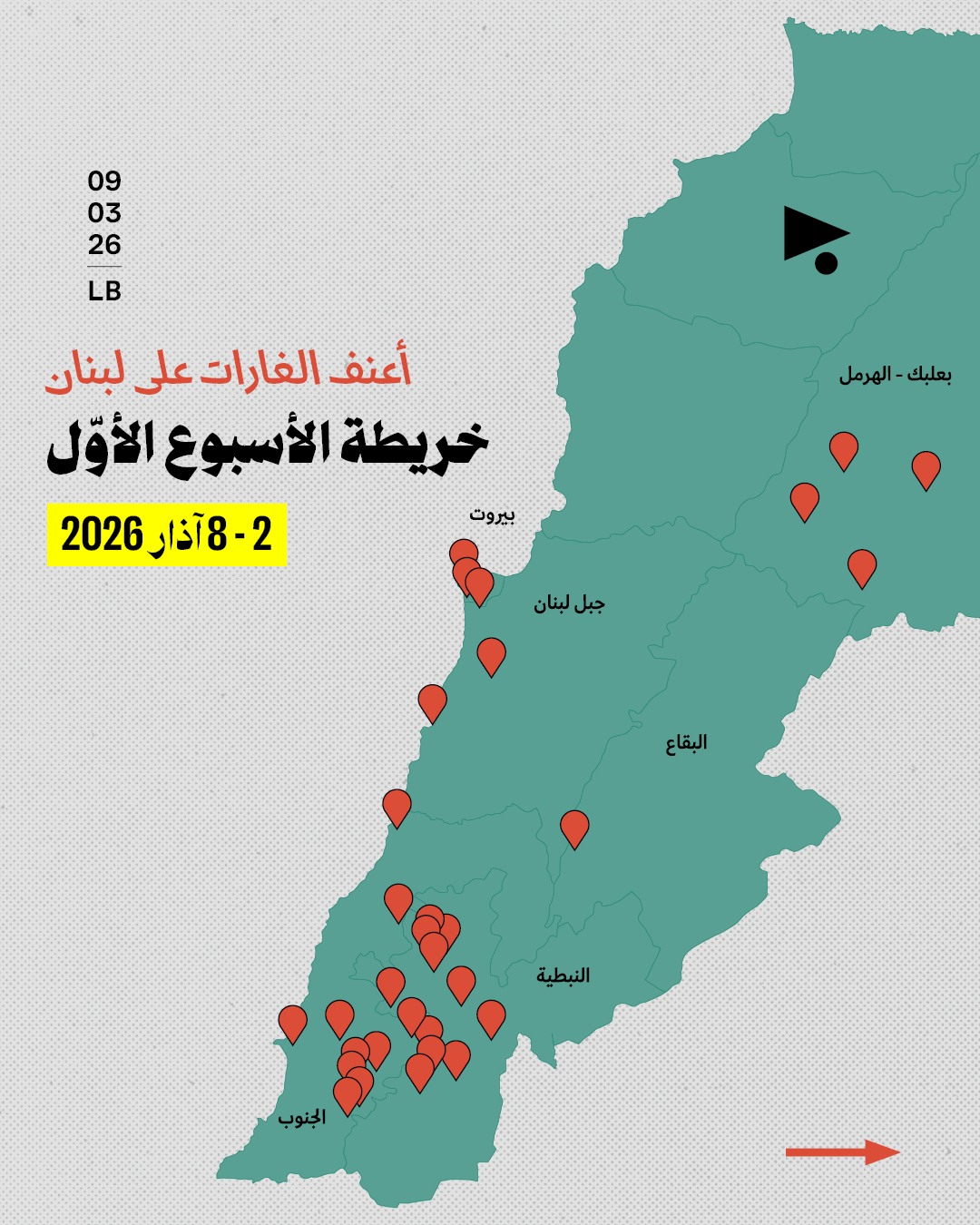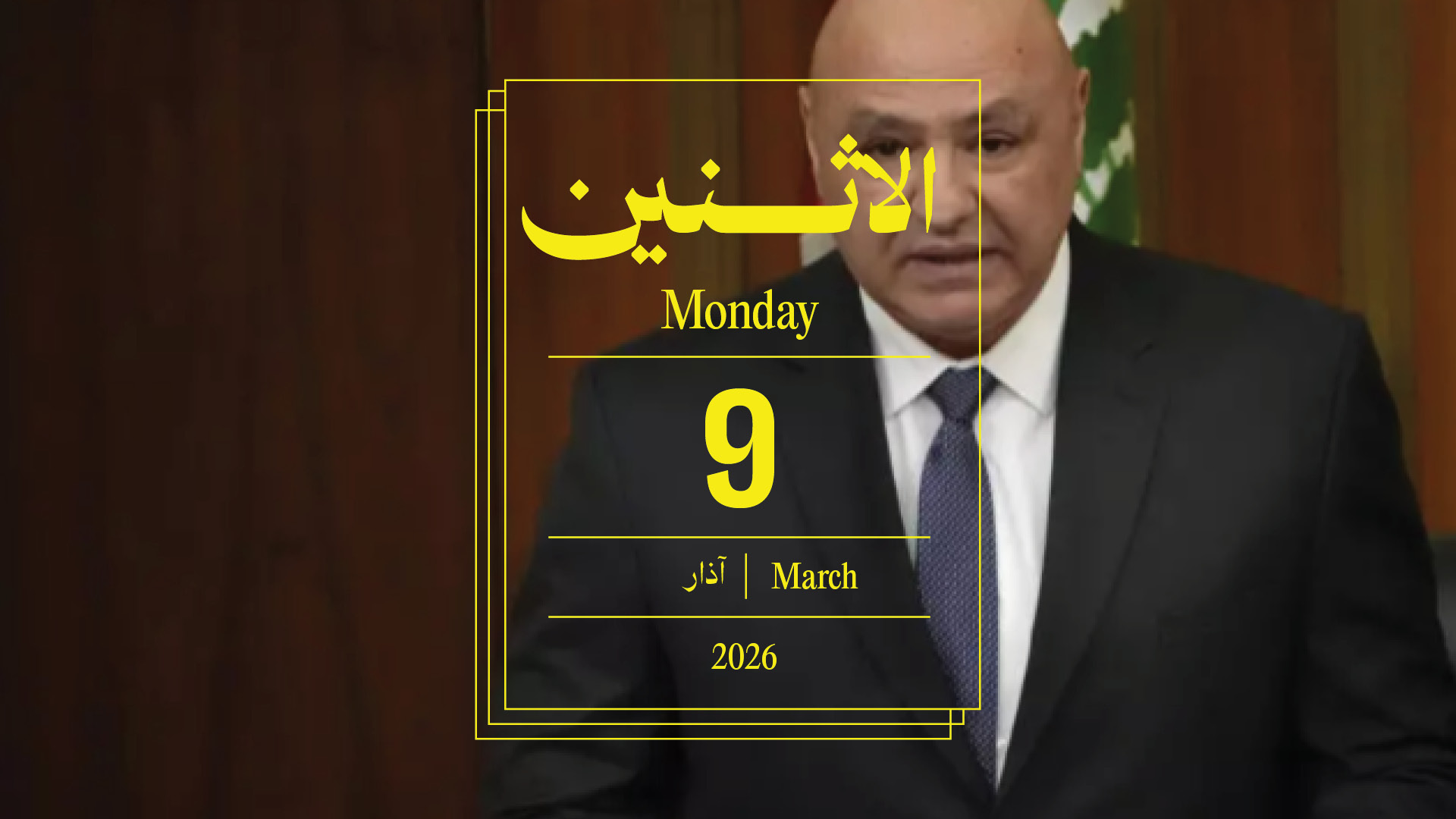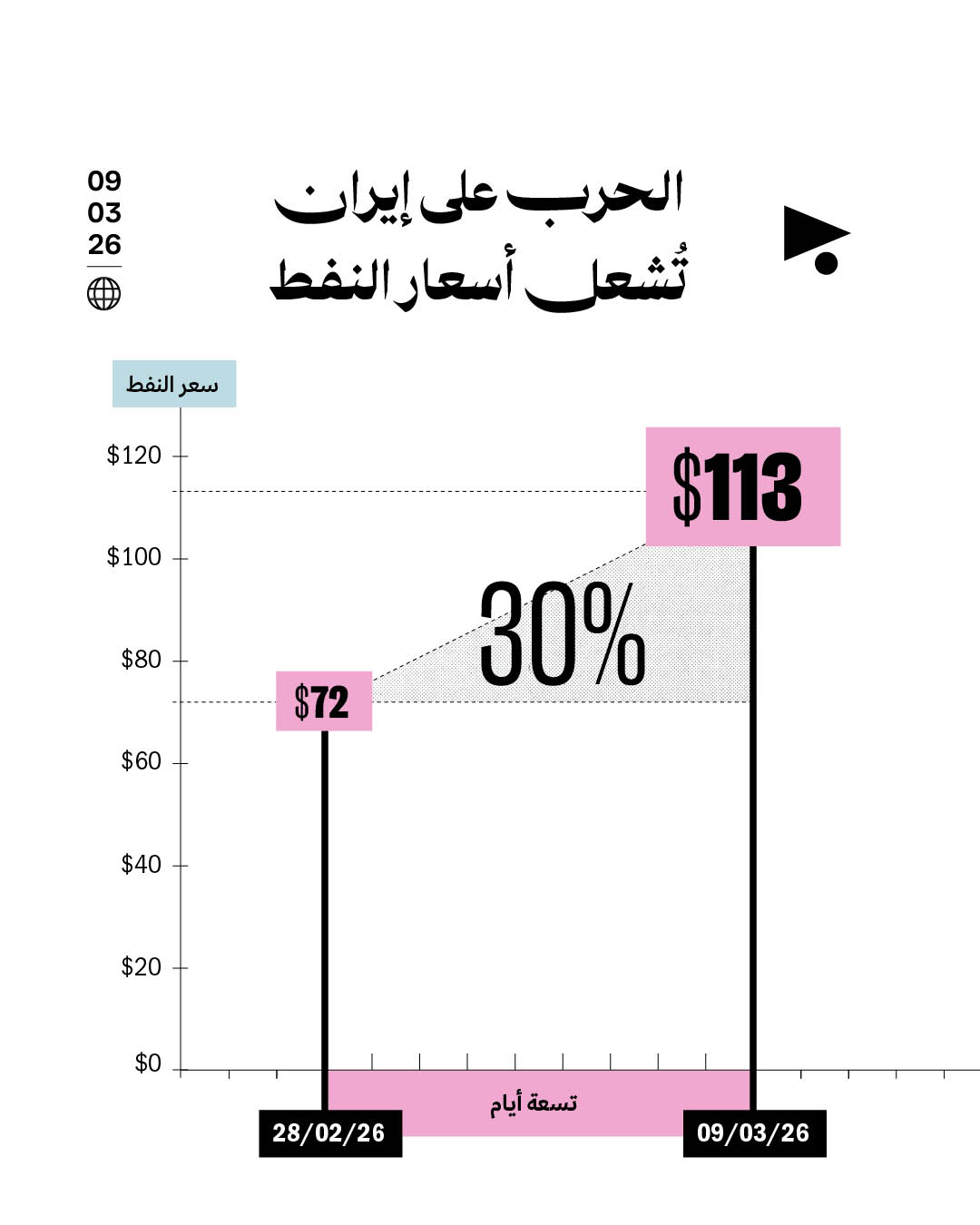عدتُ إلى بيروت بعد غيابٍ دام أسابيع ثلاثة، أمضيتها في إحدى قرى جبل لبنان هرباً من الحرب. عدتُ إليها متوقِّعاً أن أجدها قد تغيَّرت كثيراً: فما سمعته ممَّن بقوا فيها كان يشي بأنّني بالكاد سأعود قادراً على التعرّف إليها. لكن باستثناء الازدياد الهائل في أعداد السيارات والبشر، وجدت أنّها لا تزال على حالها: إنّها بيروت التي أعرفها جيّداً.
لازمني هذا الشعور أسبوعاً من الزمن إلى أن أحسستُ مرّة، وأنا أمشي في أحد الشوارع، بأنّ الفضاء لم يعد يتّسع لكل ما يحتويه، بأنّه موشك على التمزّق أو الانفجار. ليس في ما أقوله مبالغة أو مجاز، فهذا بالضبط ما أحسسْتُه: بأنّ الفضاء في حدّ ذاته، هذا الشيء البالغ التجريد، والذي لا نستطيع رؤيته ولا لمسه (مثله مثل الزمن)، ولكنّه يحتوي على كلّ ما يُرى ويُلمس... أحسسْتُ بأنّه بات كائناً حيّاً، ينبض مثل قلبٍ، وبأنّني في داخله، أنا وهذا الكمّ الهائل من السيارات والبشر الذي بدا لي أنّني أبصره للمرّة الأولى منذ عودتي إلى المدينة... أحسسْتُ بأنّ الفضاءَ كائنٌ حيٌّ ينبض من الألم، متخماً بما ابتلعه من لحمٍ بشريٍّ ومعدنٍ، وبأنّه قد ينفجر في أيّ لحظة.
أدركتُ فجأةً كمّ أنّ المشي في الشوارع بات صعباً. كيف لم أنتبه إلى ذلك قبل هذه اللحظة؟ كيف استلزمني ذلك أسبوعاً كاملاً؟ كنت بالطبع قد انتبهت إلى زحمة السير الخانقة، المستمرّة من الصباح حتّى المساء، فتجنّبت التنقّل بالسيارات ولم أقصد أيّ مكان، منذ عودتي إلى بيروت، إلّا سيراً على الأقدام. وكنتُ أستغرب كيف أنّ معظم الناس لا يفعلون مثلي، إذا كانت تنقّلاتهم محصورة داخل بيروت. ما تراهم يفعلون في داخل هذه السيارات الجامدة في مكانها كما لو أنّها مثبّتة في الأرض؟ كنتُ أتساءل. إلى أن أدركت أنّ التنقّل بالسيارة، ولو أنّه صار أبطأ من السير على الأقدام، لعلّه يُتلف الأعصاب بدرجة أقلّ. ففي السيارة، ولو كانت مثبّتة في الأرض، ثمّة مساحة لك، ولو كانت ضيّقة. ثمّة أيضاً ما يحميك ممّا هو في الخارج، حاجزٌ بينك وبين ذاك الفضاء الذي لم يعد يتّسع لشيء.
أمّا السير على الأقدام، فيحيلك أحدَ مكوّنات هذا الفضاء الموشك على الانفجار. لا مساحة لك في هذا الفضاء، ذاك أنّ كلَّ شيء قد التحم بكلّ شيء. كتلةٌ واحدة منصهرة من اللحم والمعدن، والصراخ والضجيج والجلبة، وعنين المسيرات. بالكاد تستطيع أن تخطو خطوةً من دون أن تصطدم بلحمٍ بشريّ أو بمعدنِ سيارة مركونة على حافّة الرصيف أو حتّى عليه، أومثبَّتة في الأرض في وسط الشارع، جامدةً لا تتزحزح من مكانها. أمّا الأفكار التي قد تتوارد إلى ذهنك بينما تصطدم بهذا المعدن أو ذاك اللحم، فهي ليست أفكارك بالفعل، ذاك أنّها تتكوّن من خليطِ ضجيجٍ وجلبةٍ وصراخٍ وعنين.
لا مكان لأحدٍ في هذه المدينة. ذاك أنّ لا أحد فيها بقي ممتلكاً جسده أو حتّى أفكاره. الجميع ذابوا في الجميع وانصهروا في معدن السيارات، من شدّة ما حُشروا في فضاءٍ ما عاد يتّسع لشيء. والغريب أنّ هذا الفضاء لم يتشظّى بعدُ. لكنّ هذا كلّه ليس سوى لحظةِ يقظةٍ قصيرة سرعان ما تنقضي، فتكمل طريقك– سيراً على الأقدام أو بالسيّارة– كأنّ شيئاً لم يكن، وكأنّك لا تزال كائناً بشريّاً طبيعيّاً يمتلك جسداً وأفكاراً.
لكنّك تصل إلى المنزل مُنهَكاً، حتّى لو لم تكن قد أمضيت سوى نصف ساعة في الخارج. في كلّ مرّة ترجع فيها إلى المنزل، تجد نفسك مُنهَكاً، مهما قصُر الوقت الذي أمضيته في الخارج. تعتاد اكتظاظ الشوارع، أيْ لا تعود تلحظه باستمرار، ولا تعود تشعر أنّ الفضاء موشك على الانفجار– أو الأحرى أنّ ذهنك هو الذي يعتاد ذلك، غير أنّ جسدك لا ينفكّ يرجع إلى المنزل مرهَقاً في كلّ مرّة. كأنّه كان يكافح، هناك في الخارج، ليحتلّ مساحةً ضئيلة بالكاد تكفيه. كأنّ الخارج لم يعد فضاءً مفتوحاً، بل أصبح نوعاً من أنواع الداخل: كحجرة ضيّقة كُدِّس فيها كمٌّ من الأجساد يفوق قدرة استيعابها.
لذلك تروح تتجنّب الخروج من المنزل. فقد بات المنزل هو الفضاء الواسع الرحب. بات ينوب مكان الخارج، إذ يمنحك شعوراً بأنّ جسدك لديه ما يكفي من المساحة للتحرّك بحريّة. أمّا النزهة الوحيدة التي بقيت مُتاحةً لك، فهي على شرفتك، تذرعها جيئةً وذهاباً فيما تدخّن سيجارة.
هكذا أكون قد عدت إلى بيروت فلم أعثر عليها. فهي لم تعد مدينة، بل صارت ملجأً ضخماً مكتظّاً بالهاربين من الدمار والموت.