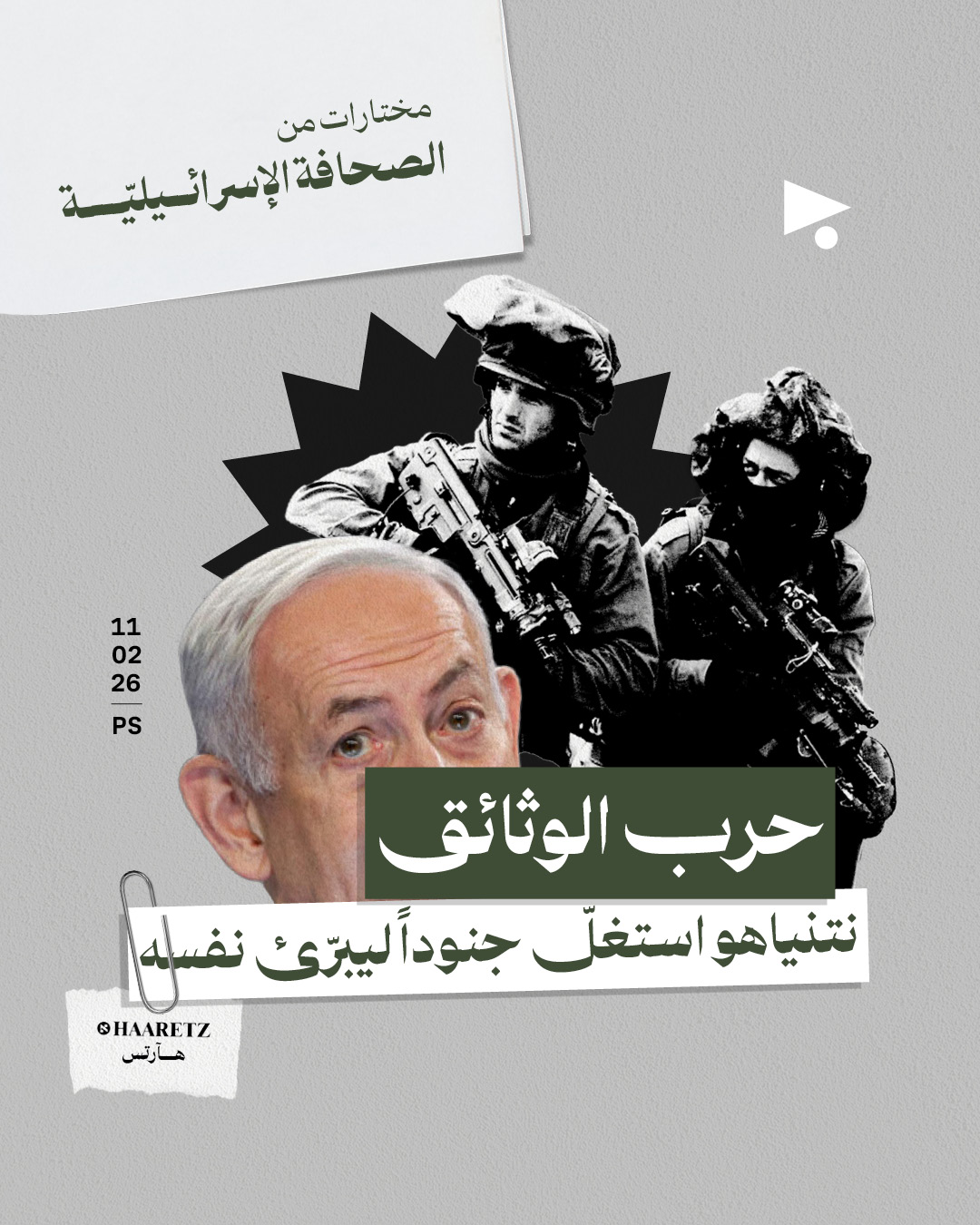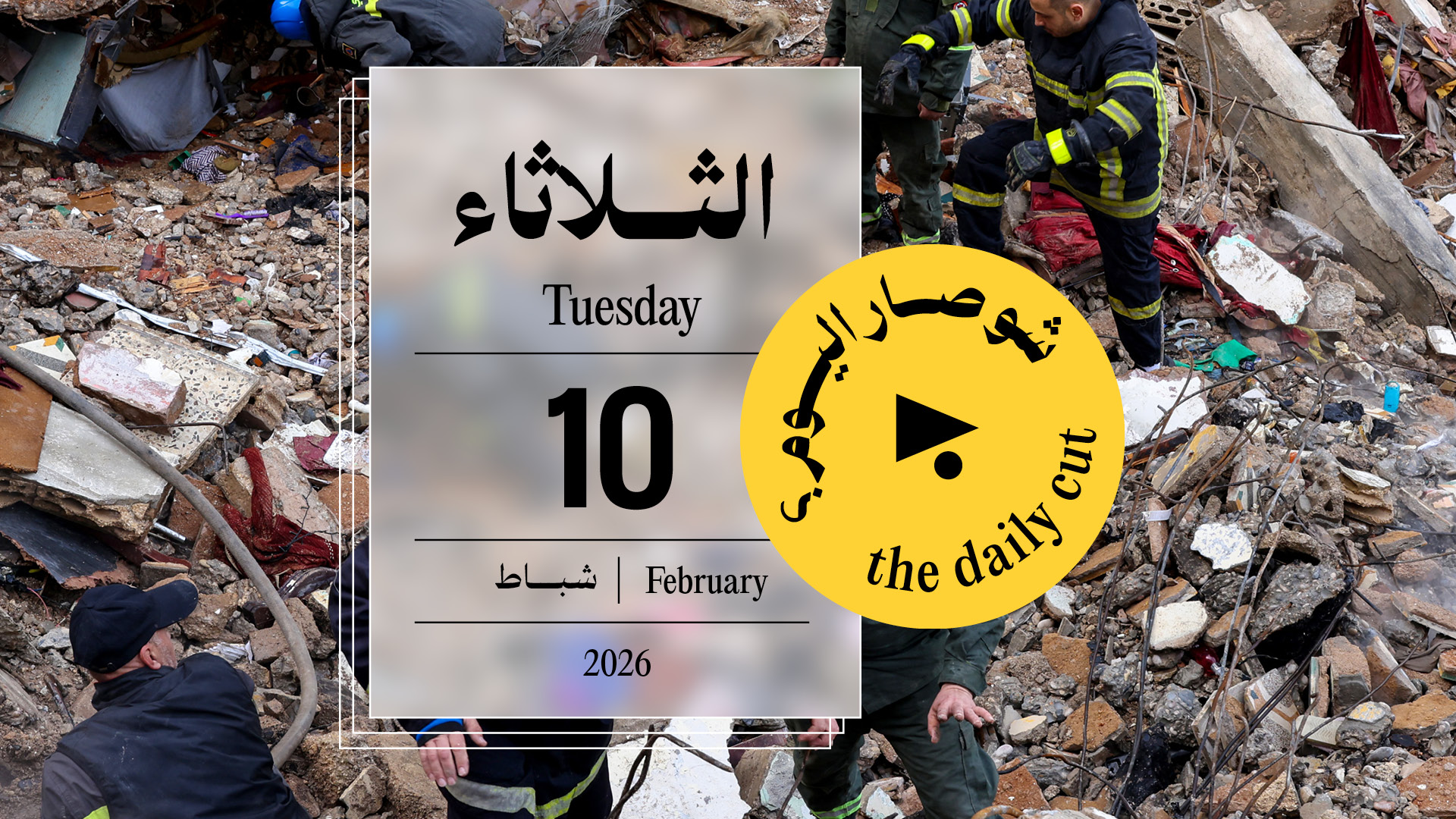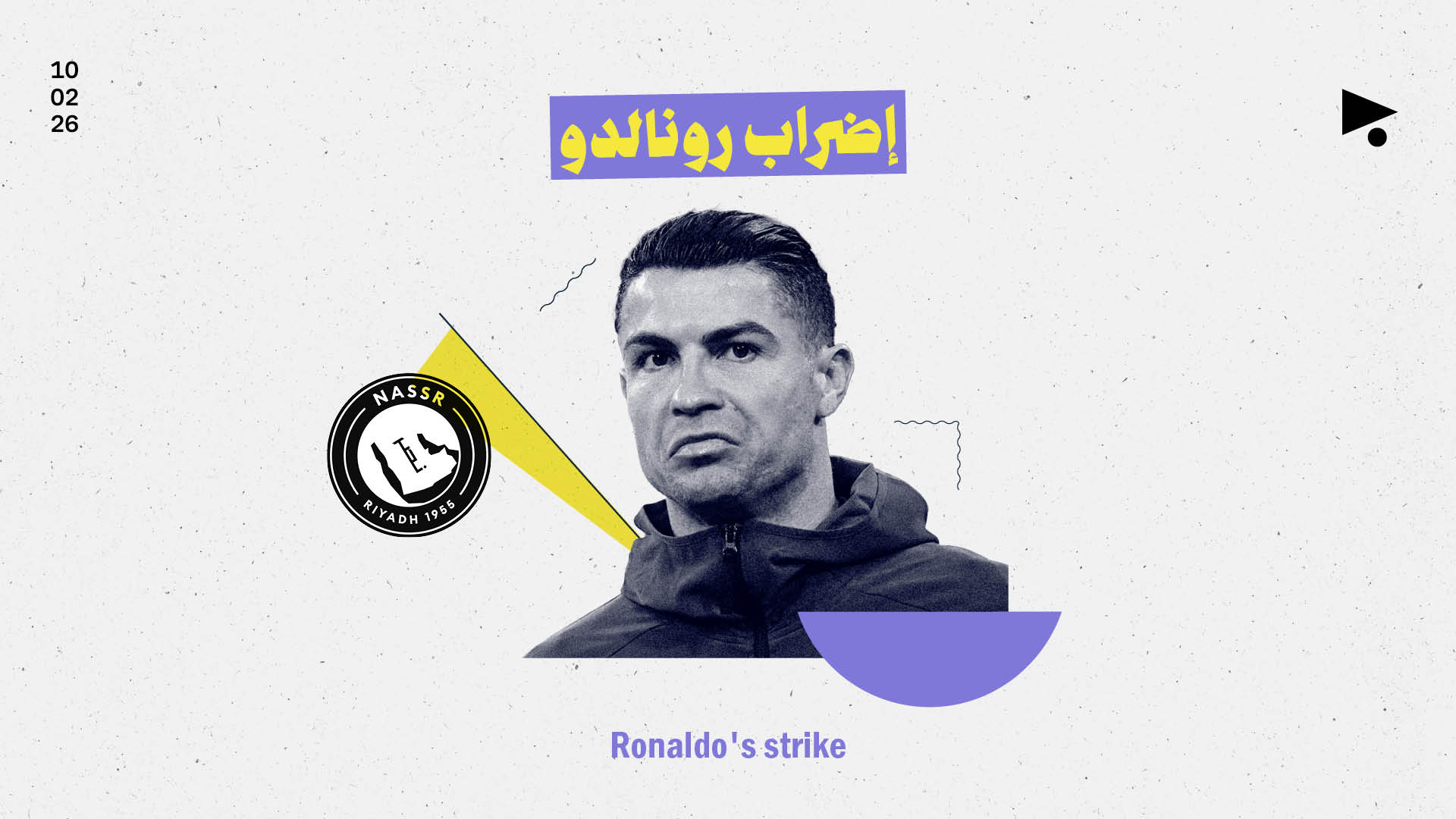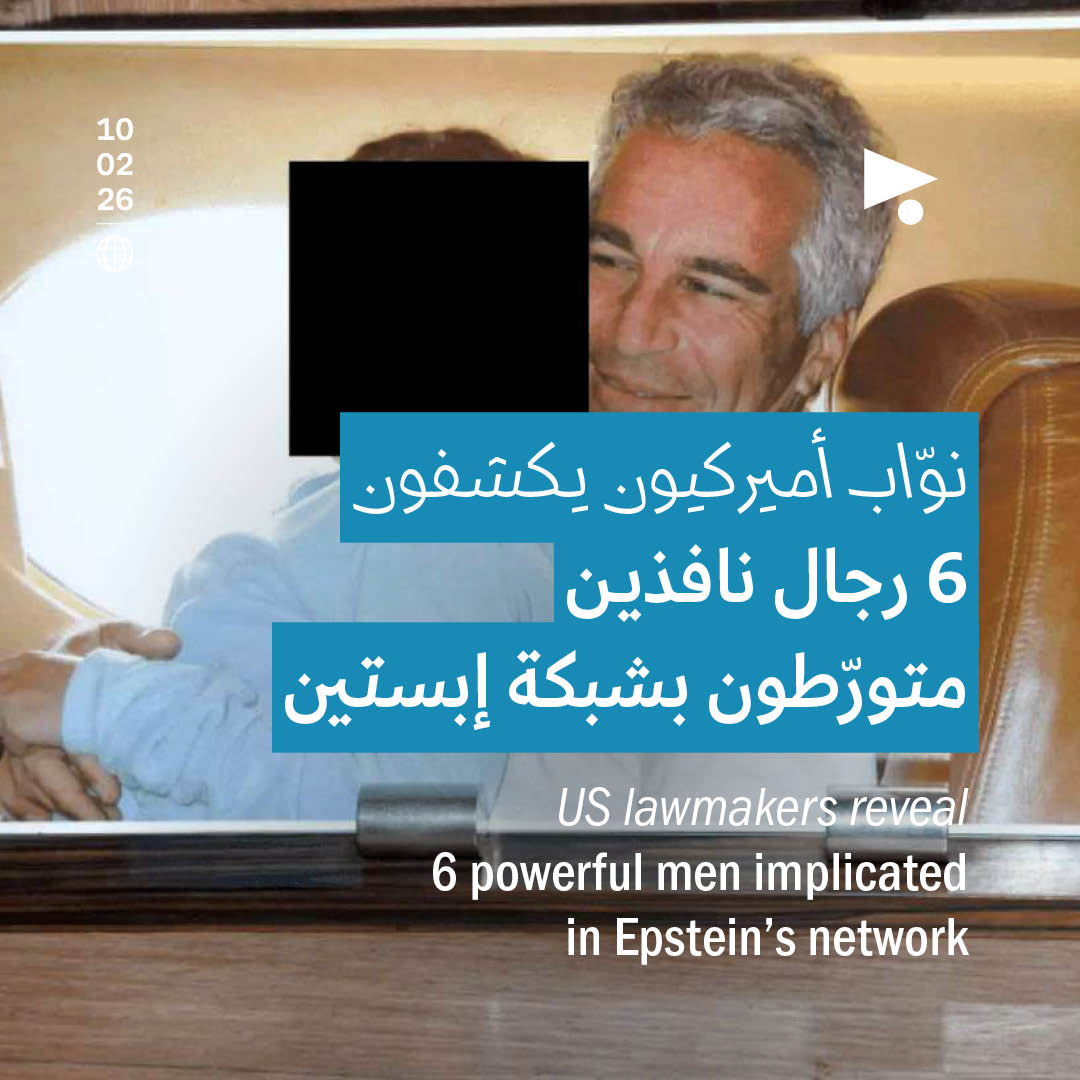في السادس والعشرين من كانون الأول الماضي، لقيت عبير رحال حتفها بعدما أطلق عليها زوجها خليل مسعود النار في بلدة شحيم، جنوب لبنان، وذلك أمام المحكمة الشرعية التي كانت تنظر في طلب عبير الطلاق. انتحر خليل بعد ساعات قليلة داخل سيارته بعدما سجّل فيديو نشره على حسابه على فيسبوك يبرّر فيه فعلته. هنا قراءة في الجريمة، وفي ردود الفعل التي استدعتها، تنطلق منها لتضيء على نمط معاصر من العنف ضد النساء يتقاطع عنده الاضطراب النفسي بالبنية الاجتماعية الحاضنة والمشرعنة له، وتسائل ما يكشفه النقاش حول توصيفه وتسميته.
في كل مرة تقع فيها جريمة قتل ضد النساء، يتكرّر التعليق نفسه بأشكال ونبرات مختلفة: لا بدّ أن القاتل مريض نفسيّاً. يأتي التعليق غالباً على شكل توكيد حاسم، لا على شكل سؤال هدفه السعي إلى فهم أعمق لهذا النوع من الجرائم، وغالباً ما يُضمر تبرئةً للمجتمع من مسؤوليته البنيوية. لكنّ الفصل التام بين «الفردي النفسي» و«الجماعي البنيوي» لا يكفي لفهم هذا النوع من الجرائم.
يصبح المرض النفسي أداةً لفهم كيف تنتج السلطة الذكورية أنماطاً من الأعطاب النفسية تحوّل الامتياز إلى استحقاق وجودي، ورغبة المرأة بالانفصال إلى تهديد لكيان الرجل نفسه.فالتفسير النفسي لا يُلغي بالضرورة البعد الجندري. وفي حالة خليل مسعود، لا يبدو العنف لحظة جنون مفاجئة، بل ذروة مسار قائم على السيطرة والعنف الأسري والإنكار الكامل لاستقلال الزوجة، وصولاً إلى محاولة قتلها المعنوي قبل قتلها الجسدي. إنها أزمة رمزية ونفسية في آنٍ، لا تعفي من المسؤولية، لكنها تضيء على جذور العنف التي غالباً ما تتخفّى وراء شعارات الشرف والمظلومية الذكورية. بهذا المعنى، يصبح المرض النفسي أداةً لفهم كيف تنتج السلطة الذكورية أنماطاً من الأعطاب النفسية تحوّل الامتياز إلى استحقاق وجودي، ورغبة المرأة بالانفصال إلى تهديد لكيان الرجل نفسه.
الثنائي بين المظهر العصري والخلفيّة التقليديّة
في الصور التي انتشرت لعبير رحال وزوجها قبل الجريمة، يظهر الثنائي في هيئة عصرية وحداثية: شابة تعمل في الإعلام، حاضرة في المجال العام، ذات حضور اجتماعي مستقلّ وكأنها تجسّد نموذج المرأة الحديثة في فضاء منفتح. غير أن الصورة التي يرسمها خليل مسعود عن نفسه وعن علاقته بزوجته في الفيديو الذي سجّله قبل مقتله تنتمي إلى عالم رمزيّ على النقيض تماماً. إذ يعكس خطابه منظومة قيم أبوية وتقليدية صارمة، حيث المرأة ملكٌ للرجل، وامتدادٌ لكيانه الاجتماعي، يستمدّ منها شرفه وكرامته، ويقيّم أخلاقها وحقها بالحياة من خلال مقدار خضوعها له.
يدوم التسجيل المصوّر قرابة عشرين دقيقة، يحاول خلالها خليل مسعود تبرير فعلته أخلاقياً وعاطفياً، في رغبة واضحة بالتحكم الكامل في السردية، حتى بعد موته، وبعد أن تكون عبير قد باتت عاجزة عن الدفاع عن نفسها أو تقديم سرديّتها الخاصة. عبر إشراك الجمهور كشهود على «معاناته» و«مظلمته»، يحاول أن يستبق الأحكام، ويضمن أن تُروى الحكاية من منظوره هو. يظهر ممتلئاً غضباً وخذلاناً، يحرّكه الشعور بالإهانة الشخصية والاجتماعية، فيكرّر عبارات مثل رأسي انكسر وما عاد فيي اتطلّع بعيون أهلي، مُقدّماً نفسه كضحية محاطة بالخيانة والغدر، لا من زوجته فقط، بل من جميع مَن حولها.
يلحّ خليل على تكرار اسم زوجته الكامل، «عبير رحال»، عشرات المرات، بشكل عصبيّ وعصابيّ. يصير هذا الاسم رمزاً للأهلية الكاملة والفعالية التامة التي أراد محوها بقتل صاحبتها. يُصرّ على أنه صاحب الفضل في نجاحها المهني (فتحتلها مكتب) ويقولها بأسلوب يشي بالامتلاك وكأن المرأة ومهنتها مشروع خاص به، وامتداد لنجاحه المهني والاجتماعي هو. وتتوالى الاتهامات: خيانة، علاقات متعدّدة، حبّ المال والشهرة... من دون أن يكون أيّ منها، في حدّ ذاته، جديداً عليه.
لحظة طلب الطلاق، ينكسر التوازن الرمزي الذي كان يضعه في موقع الهيمنة، ويصبح الانفصال تهديداً لموقعه الاجتماعي والمعنوي، ويفجّر أناه المجروحة.فالمعرفة السابقة بهذه الآثام المفترضة تبدو ثانوية في خطابه. ما يهمّ هو لحظة الانفصال وطلب الطلاق وممارسة عبير حقها في إنهاء العلاقة. هنا تختلّ الموازين: من علاقة منح وإيثار وتضحية من طرف واحد بحسب ما يصف، إلى علاقة لم تعد تتّسق مع منظومة القيم التي يتبنّاها. في لحظة طلب الطلاق، ينكسر التوازن الرمزي الذي كان يضعه في موقع الهيمنة، ويصبح الانفصال تهديداً لموقعه الاجتماعي والمعنوي، ويفجّر أناه المجروحة. هي إذاً هذه اللحظة ما يؤجج العنف، لا الآثام السابقة المفترضة: عبير تستوجب القتل لا لأنها «سيئة»، بل لأنها لم تعد قابلة للامتلاك. لأنها قالت «لا»، وقرّرت الخروج من علاقة قائمة على منطق الخضوع والسيطرة.

في مقابلة إذاعية، تروي والدة عبير أنّ ابنتها كانت تتعرّض للعنف الجسدي باستمرار من زوجها. تشير في حديثها إلى الفارق الزمني الضئيل بين كل طفل من أطفالها الثلاثة (لا يتعدّى السنة) وتؤكد أنه منعها من استخدام وسائل منع الحمل، وكان يضربها حين تطلب ذلك. تأتي شهادتها، إلى جانب ما يتبدّى من خطابه هو، لتؤكّد أن القتل لم يكن لحظة جنون أو «تخلٍّ»، بل الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات العنفية، المبنية على تصوّر متجذّر يرفض أن تكون للمرأة أي سيادة على جسدها أو على حياتها.
في مثل هذه المنظومة، تكون الرغبة بالاستقلال واستعادة الوصاية على الجسد تمرّداً يستوجب العقاب. ولا تعود جريمة القتل مجرّد فعل عنفي معزول، بل ذروة مأسويّة لنمط فكري وسلوكي قائم على إقصاء المرأة كذات مستقلة، وتحويلها إلى امتداد رمزي للرجل، حيث يصبح استقلالها خطراً وجودياً عليه.
هل المرض النفسي تبرير للجريمة؟
بعد انتشار الفيديو ومعه خبر الجريمة، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي كالعادة بمزيج من الاستنكار والتبرير. جزء كبير من التعليقات يشير إلى أنه رجل مريض، معتلّ نفسياً، مجنون... إلا أن اللافت في هذا السياق كان تواتر مصطلح «نرجسي» في تعليقات النساء تحديداً. وهو تعبير بات شائعاً في الفضاء الرقمي، إلى جانب مصطلحات مثل «علاقات سامة» و«غاسلايتينغ» وسواها لوصف أنماط من العنف العاطفي والنفسي، وتفسير سلوكيات مثل الغيرة والابتزاز العاطفي والتقليل من شأن الطرف الآخر باعتبارها أدوات للسيطرة على الشريك. في المقابل، ارتفعت أصوات لتحذّر من هذه اللغة وتعتبرها نوعاً من «التحليل الشعبي السطحي»، الذي يبرّئ المنظومة الأبوية ويطمس البعد الجندري للجريمة.
ما أريد أن أطرحه هنا يحاول تخطّي التعارض بين وجهتَيّ النظر هاتين.
من جهة، إنّ استدعاء المرض النفسي لتفسير الجريمة لا يتناقض بالضرورة مع فهم العنف الذكوري بوصفه بنية اجتماعية وسياسية مرتبطة بالأبوية. ذلك أن المرض النفسي يكون أحياناً ناتجاً عن هذه البنية ويدخل في فئة الاضطرابات المصنفة في خانة السوسيوباتولوجيا. وهو نوع من الاضطرابات النفسية والسلوكية الناتجة عن تركيبة اجتماعية مختلّة. لا تعفي السوسيوباتولوجيا من المسؤولية، بل تحاول ربط السلوك الفردي بسياق إنتاجه. وأعني بذلك، في حالة خليل مسعود، النظام الأبوي.
ومن جهة أخرى، هذا الانتشار لمصطلحات نفسية في الفضاءات الرقمية من قبل النساء للحديث عن تجاربهن العاطفية والعنف الذي يتسلل إلى العلاقات تحت أقنعة الحب والرعاية، لا يُمكن قراءته بتعالٍ نخبويّ واعتباره مجرد اختزال وتبسيط لمفاهيم علم النفس المؤسساتي، من دون الانتباه إلى ما تكشفه هذه الظاهرة عن ظهور وعي ثقافي جديد يُعيد تسمية أشكال من العنف غير الجسدي وغير المرئي. إن هذا الخطاب، وإن استخدم أحياناً المفاهيم النفسية بشكل فضفاض، إلا أنه يساهم في كشف العنف الرمزي والعاطفي، لا بل يشكّل نوعاً من التأريخ الشعبي النسوي للمعاناة، حيث تُصبح اللغة أداة للفهم والحماية والنجاة.
ماذا لو لم يكن هذا التفسير النفسي منافياً لفهم العنف الذكوري كبنية سلطوية؟ ماذا لو كانت هذه المفردات، المنتشرة اليوم في الفضاء الرقمي، لا تُمثّل مجرد استهلاك ساذج لمفاهيم رائجةلكن قبل أن أتابع، يهمّني أن أؤكد أنني لا أتناول هنا مسألة ما إذا كان خليل مسعود يعاني من اضطراب نرجسي بالمعنى العيادي للكلمة، وإن كان الفيديو يوحي، حتى لغير المتخصصين، بسمات اضطرابية محتملة، مثل البارانويا أو التمركز المرضي حول الذات. ما يعنيني في هذا السياق هو أن هذه المأساة، والطريقة التي تلقّاها بها الناس، والميل الواسع إلى تفسير هذا النوع من العنف من خلال مفاهيم نفسية مثل «النرجسية»، تفتح الباب أمام مقاربة تتجاوز الثنائية التقليدية بين التفسير الفردي المرَضي والتفسير البنيوي الاجتماعي.
السؤال هو إذن: ماذا لو لم يكن هذا التفسير النفسي منافياً لفهم العنف الذكوري كبنية سلطوية؟ ماذا لو كانت هذه المفردات، المنتشرة اليوم في الفضاء الرقمي، لا تُمثّل مجرد استهلاك ساذج لمفاهيم رائجة، بل تعبّر عن تحوّل عميق في الوعي النسوي تجاه أشكال جديدة من العنف العاطفي والنفسي؟ وهل يُمكن النظر إلى هذا النمط من الذكورة المَرَضية، التي قد لا تَقتل بالضرورة كما في حالة عبير رحال، بل تُحطّم ببطء، كوجه جديد للهيمنة الأبوية حين تفقد أدواتها التقليدية؟

هذا ما تحاول مقاربة «الانحراف النرجسي» كما اشتغل عليها عالم الاجتماع الفرنسي مارك جولي أن تضيئه، لا بوصفه اضطراباً نفسياً فردياً، بل عرضاً من أعراض سوسيوباتولوجيا ذكورية معاصرة نشأت عن تفكك شرعية الهيمنة الذكورية في زمن باتت فيه المساواة بين الرجل والمرأة مطلباً شرعياً ومُشرَّعاً أحياناً.
الانحراف النرجسي بوصفه سوسيوباتولوجيا جندريّة

في الكتاب الصادر في أيلول الماضي عن المركز الوطني للبحث العلمي في باريس، بعنوان «الانحراف النرجسي، دراسة سوسيولوجية» (La perversion narcissique: étude sociologique)، ينطلق مارك جولي من أعمال الطبيب النفسي الفرنسي بول-كلود راكامييه (1924-1996)، ليعيد تعريف الانحراف النرجسي ويضعه في قلب تحوّلات السلطة الذكورية. فالانحراف النرجسي، كما يراه، ليس خللاً فردياً فحسب كما وصفه راكامييه، بل نمط دفاعي اجتماعي، ينشأ حين تصبح الامتيازات الذكورية التقليدية مهدَّدة، ويُجسِّد أزمة البنية الأبوية أمام صعود قيم المساواة والاستقلالية.

بدأ راكامييه بتطوير المفهوم في أواخر السبعينيات ووضع خلاصة سنوات من البحث في كتاب صدر في 1992 وبات اليوم مرجعاً في مجاله هو «عبقرية البدايات: التحليل النفسي والاضطرابات الذُّهانية» (Le Génie des origines : Psychanalyse et psychoses). حدّد فيه الطبيب النفسي «الانحراف النرجسي» كآلية دفاعية لدى أشخاص لم ينجحوا في بناء ذات مستقلة، فراحوا يبحثون عن تثبيت أنفسهم من خلال السيطرة على الآخر ونفيه وإعادة تشكيل الواقع بحسب حاجاتهم النفسية العميقة.
بالنسبة لراكامييه، النرجسية المرضية ليست مجرّد تضخم للأنا كما يمكن أن يوحي اسمها، إنما هي فشل يعود إلى مراحل الطفولة المبكرة في بناء علاقة سليمة بالذات والآخَر. إنها ليست فائضاً من الثقة، بل آلية دفاعية لتعويض هشاشة بنيوية في الهوية تكوّنت بسبب علاقة ملتبسة مع الأم (يفنّد جولي موضوع مسؤولية الأم هذا ويضعه ضمن اتجاه عام في علم النفس تلك الفترة). هذه الهشاشة تجعل الشخص مهدداً بخطر الانهيار أو الانحلال الذهني، أو ما يسمى بالذُّهان (وهو اضطراب نفسي عميق تُعَد السكيزوفرينيا أو الفصام من أشهر أنواعه). لذا يطوّر هذا الشخص آلية دفاعية، نفسية وسلوكية، تحميه من الذُّهان أو من الاكتئاب وتقوم على الإنكار الكامل للآخر ككائن مستقل، وعلى إسقاط الذنب والضعف عليه، وعلى السيطرة على السردية والمعنى، وعلى بناء وهم ذاتي متماسك ومتفوّق. كل هذه الآليات تخلق بنية دفاعية صلبة، لكنها عدائية ومفترسة، تمنع صاحبها من الانهيار الداخلي عبر توجيه كل التوتر والتهديد إلى الخارج (الأخَر، المجتمع...). لكن هذه البنية الحمائية لا تكون من دون عواقب. فلكي يتفادى المنحرف النرجسي الانهيار، يُسقط الألم والخلل على الآخر، مما يؤدي إلى علاقات تدميرية مشحونة بالعنف الرمزي والعاطفي. هكذا ينجو المنحرف النرجسي من الاكتئاب، لكنه يتسبّب بمعاناة كبيرة لمن حوله.
من هنا، فالمنحرف النرجسي كما وصفه راكامييه ليس مريضاً تقليدياً، إنه بشكل ما «ناجٍ» من الذُّهان عن طريق بناء علاقة مدمّرة مع الآخَر قائمة على نفي هذا الآخَر وتضخيم ذاته، فتتحوّل علاقاته إلى حقل تحكّم وتلاعب نفسي. وفي الوقت الذي يحتفظ فيه هو بتماسكه، يتحمّل الآخَر عبء حماية توازن شخص لا يعترف بوجوده الكامل أصلاً.
ما الجديد الذي خَلُصَ إليه مارك جولي بالنسبة لأطروحة راكامييه؟
من خلال دراسة سوسيولوجية حول تلقّي المفهوم واستخدامه في الفضاء العام، أضاف جولي بعداً جندرياً على أطروحة راكامييه. فقرأ الانحراف النرجسي بوصفه أحد أشكال التأقلم الذي تقوم به الأبوية في زمن باتت المساواة عنوان العلاقة بين الزوجين.
يعتبر جولي أن هذه التركيبة النفسية التي وصفها راكامييه مرتبطة بالقدرة. أي أن يكون الشخص قادراً على تفعيل هذه الآليات ضمن سياق العلاقة. وهذه القدرة تجد في العلاقات العاطفية غير المتكافئة ضمن المنظومة الأبوية مجال تحققها الأمثل.
يشير «الهابيتوس الذكوري» إلى تلك المنظومة الداخلية التي تجعل بعض الرجال يتصرفون وكأن لهم سلطة طبيعية على شريكتهم، دون وعي أو تفكير نقدي، لأنهم نشأوا في بيئة تمنحهم هذا الامتيازوليشرح ذلك يستعين بمفهوم الهابيتوس لدى بيار بورديو. والهابيتوس هو مجموعة من الاستعدادات اللاواعية التي يكتسبها الفرد منذ الطفولة، نتيجة لتجربته الطبقية والعائلية والتربوية والجندرية، ويؤثر بشكل مباشر في طريقة إدراكه للعالم وتصرّفه داخله. في السياق الجندري، يشير «الهابيتوس الذكوري» إلى تلك المنظومة الداخلية التي تجعل بعض الرجال يتصرفون وكأن لهم سلطة طبيعية على شريكتهم، دون وعي أو تفكير نقدي، لأنهم نشأوا في بيئة تمنحهم هذا الامتياز. وعندما تتغيّر شروط العلاقة وتُفرَض المساواة، يصبح هؤلاء الرجال في مواجهة صراع داخلي، لأن التغيير يطال بنيتهم النفسية العميقة.
من هنا، يرى جولي أن بعض الرجال، ممن تربّوا على «هابيتوس» ذكوري يضمن لهم موقعاً رمزياً مستقرّاً بوصف الواحد منهم المالك والحامي وصاحب القرار، يجدون أنفسهم في حالة فقدان مرجعية حين ترفض الشريكة الخضوع أو تطالب بالمغادرة. وفي مواجهة هذه «الندّية المستجدة»، لا يعود أمامهم سوى تفعيل آليات نفسية مَرَضية تحاول استعادة السيطرة: الإنكار والتلاعب وإسقاط الذنب على الآخَر والتدمير العاطفي، وكل الآليات التي وصفها راكامييه في أبحاثه. هؤلاء الرجال يعرفون، بل ويتقنون، كيفية إعادة تنشيط ميول أو استجابات قد تكون دفينة أو غير واعية لدى بعض النساء، وهي استجابات مرتبطة بالخضوع أو الطاعة، قد تكون ناتجة عن تنشئة اجتماعية أو ثقافية سابقة. هدفهم هو إبطال أو إضعاف النزعة المتزايدة لدى النساء للمطالبة بالندّية والاعتراف الكامل بكونهنّ ذواتاً مستقلّة.
ويضيف جولي أن هذا النمط السلوكي لدى هؤلاء الرجال لا يحتاج إلى أعراض علنية ليكون فعّالاً. فبخلاف الصورة النمطية للقاتل الغاضب أو الرجل «المضطرب»، غالباً ما يكون المنحرف النرجسي في غاية «الطبيعية» و«النجاح»، لكنه يحمل داخله منظومة كاملة من السيطرة النفسية التي تحوّل العلاقة إلى حقل تلاعب وهيمنة خفيّة. إنه لا يقتل دائماً بشكل مباشر، بل يُدمّر الشريكة ببطء، عبر نفي رغباتها وتفكيك ثقتها بذاتها.
من هذا المنطلق، يظهر خطاب خليل مسعود كأحد التعبيرات القصوى عن فشل التكيّف مع المساواة المستجدّة بين الجنسين، وعن محاولة يائسة لاستعادة سلطة مفقودة من خلال التدمير المادي والرمزي للمرأة. وفي هذا، يتقاطع العنف الفردي مع موروث ثقافي وطبقي وجندري لا يزال يعتبر استقلال المرأة تهديداً لـ«الطبيعة» الاجتماعية. هكذا تتجلى أبعاد جديدة للانحراف النرجسي: الاحتقار المتخفي في صورة الحب، والتملّك المموَّه بالاهتمام، والسلطة المقنّعة بلبوس الرعاية. فلا يعود هذا الاضطراب خللاً نفسياً فقط بل مرضاً اجتماعياً ذكورياً معاصراً، ومرآة لفشل الذكورة التقليدية في التكيّف مع عالم لم يعد يتساهل مع سلطتها التلقائية.
حين تُعيد النساء تسمية الألم
في مواجهة سرديات التبرير والتشكيك، تتّجه نساء كثيرات اليوم إلى استخدام لغة مختلفة، هجينة ومباشرة، لا تستند بالضرورة إلى التحليل النفسي الأكاديمي، بل إلى تجربة شخصية مُتراكمة. مصطلحات مثل «النرجسي»، و«العلاقة السامة»، و«التلاعب النفسي«، و«الابتزاز العاطفي»، تتكرّر بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المنتديات النسوية الرقمية، بوصفها أدوات لفهم أشكال من العنف غير المرئي. البعض يرى في هذه اللغة تسطيحاً للمفاهيم ويضع استهلاكها بهذا الشكل ضمن علم النفس الشعبوي أو البوب سايكولوجي. لكنّ هذا الحكم الذي لا يخلو من التعالي كثيراً ما يُغفل سؤالاً جوهرياً: ماذا تقول هذه اللغة عن التحوّل في الوعي النسوي المعاصر؟

ترى الباحثة الأميركية لورين برلانت أن اللغة الرائجة لوصف المشاعر تكون أحياناً وسيلة لفهم الذات في عالم لا يتيح للنساء غالباً أدوات تحليل رسمية أو لغات مؤسساتية للتعبير عن معاناتهنّ. من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى شيوع مفردة «المنحرف النرجسي» في روايات نسائية عن العلاقات الزوجية أو العاطفية، لا بوصفه ابتذالاً للمفهوم الأصلي، بل استعادة نسوية له، أداة تسمح بتسمية الألم وتفكيك العنف البنيوي حين يتنكّر بصورة الحب أو الرعاية.
في السياقات العربية، حيث تتشابك البُنى الأبوية مع منطق الطاعة العائلية والسكوت الاجتماعي، تُواجه النساء صعوبة بالغة في تسمية العنف النفسي المُمَارس عليهنّ، خاصة عندما لا يتخذ هذا العنف شكلاً جسدياً صريحاً. في هذا الفراغ الدلالي، تبرز هذه التعابير بوصفها وسائل فعّالة في قول ما تعجز اللغة اليومية والتقليدية عن قوله. يمكن فهم هذه الظاهرة من خلال مفهوم «الموت البطيء» الذي صاغته برلانت، الذي يحيل إلى تلك الأشكال اليومية والمتكررة من الاستنزاف النفسي والعاطفي التي لا تُسجَّل كوقائع عنف صريح، بل يصير التطبيع معها كعادات أو كقدر اجتماعي، لا بل يجري رمنستها أحياناً. في هذا الإطار، لا تكون هذه المفردات مجرد استعارات من الحقل النفسي أو تسطيح لها، بل تتحوّل إلى استراتيجيات نسوية للمقاومة الرمزية، تُعيد تأطير التجربة الفردية بوصفها نتاجاً لشروط سياسية واجتماعية خانقة. فهي تكسر الصمت، وتُفكّك خطاب الإنكار والتطبيع، وتمنح النساء إمكانيات جديدة للتضامن والتساؤل والمساءلة. استخدام هذه المصطلحات ليس استلاباً لغوياً، ولا ابتذالاً للمفاهيم، بل هو إعادة تشكيل للغة تُقاوم بها النساء اختناقهنّ اليومي، في مجتمعات تحصر العنف في صورته الجسدية المباشرة، وتتعامى عن أشكاله النفسية المعمّقة والمُمنهجة.
في الاتجاه نفسه، يؤكّد مارك جولي أنّ التوظيف النسوي لمفهوم الانحراف النرجسي لم ينشأ داخل المؤسسات الأكاديمية، بل من شبكات التضامن النسائي التي تشكّلت لمواجهة العنف العاطفي الخفي، أي ذاك الذي لا يترك كدمات جسدية، بل يفتك بالذات ببطء.
بمعنى آخر، حين تقول امرأة إن شريكها «نرجسي» بالمعنى المَرَضي، فهي لا تطلق توصيفاً نفسياً دقيقاً، بل تُسمّي اختلالاً شعرت به، تحكّماً خفياً، إلغاءً متواصلاً لذاتها، محاولة منهجية لتفكيكها من الداخلويذهب جولي أبعد بعد. يردّ على حجة ابتذال المفاهيم النفسية بالإشارة إلى أن الابتذال الحقيقي لمفهوم الانحراف النرجسي لم يحدث حين استخدمته النساء، بل حين جُرّد من سياقه الجندري، وصار يُطبّق بشكل مفرط وعشوائي على النساء أيضاً، وعلى جميع أنواع العلاقات، بما يُفرغه من قوته التفسيرية والنقدية.
بمعنى آخر، حين تقول امرأة إن شريكها «نرجسي» بالمعنى المَرَضي، فهي لا تطلق توصيفاً نفسياً دقيقاً، بل تُسمّي اختلالاً شعرت به، تحكّماً خفياً، إلغاءً متواصلاً لذاتها، محاولة منهجية لتفكيكها من الداخل. قد لا تُصيب في المصطلح، لكنها تُصيب في التجربة. وهنا، تصبح اللغة أداةً دفاعية، نوعاً من التوثيق غير الرسمي للعنف الرمزي، وشكلاً من أشكال النجاة عبر التسمية، خاصّةً في ظلّ غياب الاعتراف الاجتماعي أو القانوني بهذه الأنماط من الأذى.
في العمق، هذه اللغة الشعبية النسوية ليست نقيضاً للتحليل النظري، بل امتداد له من موقع التجربة، تكشف عن وعي قيد التكوّن، يتلمّس أشكال الهيمنة الجديدة بأدوات لغوية قد تكون مرتجلة لكنها كاشفة.
الذكورة في تحوّلاتها: من الهيمنة الفجّة إلى الاختلال المراوغ
في عالم تتآكل فيه مشروعية السلطة الذكورية التقليدية، لا تتراجع هذه السلطة بهدوء، بل تُبدّل جلدها، وتُعيد إنتاج أدواتها بطرائق أكثر خفاءً. فحين لم تعد الهيمنة الفجّة ممكنة، ظهرت أنماط أكثر مرونة، لكنها أكثر فتكاً: السيطرة النفسية، والتلاعب العاطفي، وتفكيك الثقة، وتشويه إدراك الذات. هذا التغيّر لا يعني أنّ الذكورة الأبوية اندثرت، بل إنها تمرّ بمرحلة تحوّل بنيوي، تنتج عنها أعطابٌ في الشخصيات التي لم تعد تجد اتساقاً بين ما نشأت عليه وما وُعدت به وبين الواقع الجديد الذي يجدر بها التأقلم معه.
في السياق الذي يصفه جولي، يحضر مفهوم الانحراف النرجسي في عالم بين ذكورة مترنّحة وأخرى تتبلور بشكل مختلف. أما في حالة عبير رحال، فنحن في مجتمعات لا تزال الذكورية بشكلها التقليدي حاضرةً بقوة، لذا يبدو شكلا الذكورة هذان متعاضدَيْن هنا ويعملان معاً. نحن في الماضي والحاضر، في القرون الوسطى وفي القرن الحادي والعشرين في الأوان ذاته.
لكن ما ينبغي أن نعيه جيّداً هو أنّ السلطة ليست كياناً ثابتاً يمتلكه طرف بالكامل ويفتقده تماماً طرف آخر، بل هي منظومة منتشرة ومتشعّبة، تتغلغل في اللغة والسلوك والمؤسسات، ولكنها قبل كل شيء مراوغة، ومتحرّكة ومتبدّلة وكلما هُدّدت شرعيتها تعيد تشكيل ذاتها وإنتاج أدواتها من جديد لتحافظ على امتيازاتها.
قُتلت عبير رحال، ولا شيء يُعيد لأطفالها الثلاثة أمّهم. لكنّنا في كلّ مرّة نسمّي فيها العنف الذي تتعرّض له النساء باسمه الحقيقي، نكسر دائرة الصمت التي تقتلهنّ مرّتين وننقذ، ربما، عبير رحّال أخرى.
رسوم: ميشال حامد