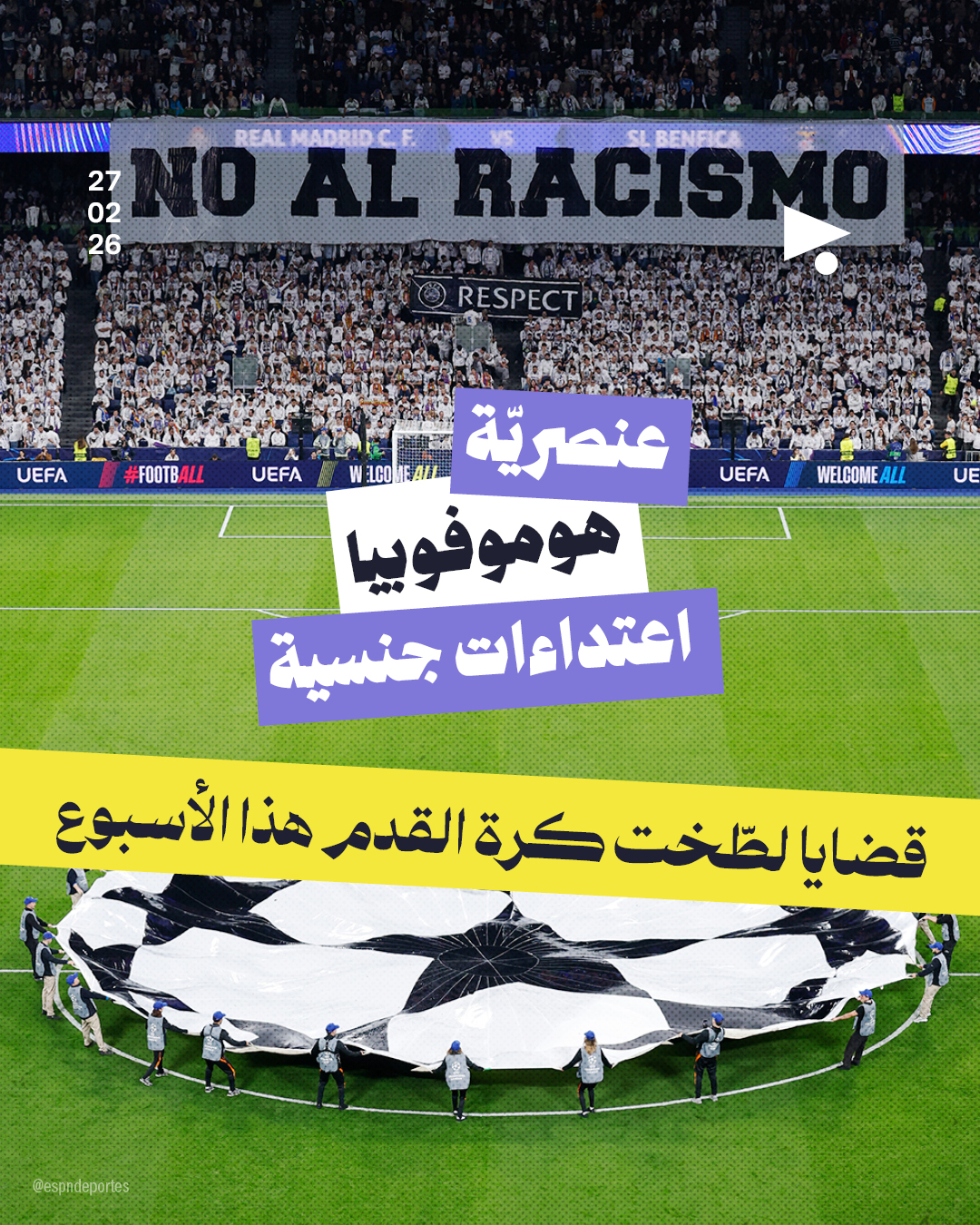في 23 تشرين الأول الفائت، بينما كانت عائلة عز الدين تجتمع في منزلها في قرية تفاحتا، في جنوب لبنان، وتحضّر الطعام في منزل الجدّ، سُجّلت إحدى أكثر لحظات العدوان الإسرائيلي فداحةً، حين أصاب صاروخ حربي منزل العائلة، ليُسجّل في تلك اللحظة مسح عائلة مؤلفة من ثلاثة أجيال. 21 فرداً من العائلة، معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء، كانوا حصيلة مجزرة تُعَدّ استمراراً للاضطهاد الذي عاشته المنطقة على مدار عقود، وتعيد إلى الذاكرة الجمعية، كما غيرها من المجازر في جنوب لبنان، رمزية كربلاء، كونها مرجعية ثقافية ودينية، شكّلت الطقوس المتوارثة كاللطم والبكاء ومجالس العزاء والمسيرات في المناطق والمسرح العاشورائي. وكأنّ الجنوب، في سياقه الراهن، استعاد دور التاريخ في تشكيل الحاضر، منتجاً موقفاً يعكس لحظة عاطفية من جهة، وخطاباً إيديولوجياً يعيد تفعيل الرمزية التي تجسدها معركة الحسين بن علي ضد الظلم، من خلال تكريس قوة كربلاء في نفوس البعض.
من الطقس إلى المشهد: تمظهرات الفرجة في المجال العام
لطالما أخذت عاشوراء بعداً درامياً بما تحمله من عناصر الزمان والمكان والانفعال. أكثر ما كان يعلق في ذهني، كجنوبيّ من مواليد التسعينيات، هو مشهد حلقات اللطم التي تقام ليلاً على مدار عشر ليالٍ، في ساحة البلدة. كان الصوت الجنائزي لباسم الكربلائي وحسين الأكرف يصدح، عند الليل، مترافقاً مع لطم الصدور، النساء على مهل وبروية، في حين يقود الرجال إيقاع الحركة المتمثلة بتنويع الضربة على الصدر، بين خافتة ومكثفة حيناً، أو قوية ومنفجرة أحياناً أخرى. ترافق هذه المشهدية، تأثيرات حواسية عميقة، يدخل معها المشاركون في تجربة انغماسية. الصوت المفجوع للمقامات الحزينة في رثاء الحسين، رائحة الهريسة التي تحضر على الحطب، توزيع راحة الحلقوم المغطاة بالبسكويت.
هذه العناصر بمجملها، بما فيها من مكوّنات صوتية وبصرية وجسدية، تخلق تجربة جماعية بالغة الكثافة والانخراط، تلامس حدود «الفرجة» بالمعنى الثقافي العام، لا بوصفها عرضاً تمثيلياً وحسب، بل كحدث تفاعلي ورمزي. وعلى الرغم من عدم وجود تماثل بين السياق الإغريقي، والسياق الطقسي العاشورائي، حيث لا يمكن إسقاط نموذج على آخر، خصوصاً لناحية الطقس العاشورائي الحيّ كتجربة انفعالية، إلا أنّ تداخل الأبعاد الروحية والاجتماعية يذكّر، من حيث احتشاد الجماعة حول لحظة سردية جامعة، ببدايات تشكُّل المسرح في اليونان القديمة، الذي نشأ من الطقوس الدينية الجماعية، قبل أن يتحوّل تدريجياً إلى فنّ أدائي مستقل له بنية جماليّة وموقع ثقافي داخل المدينة– الدولة، قديماً.
ولأن الإيديولوجيا، بحسب الناقد الإنجليزي تيري إيغلتون، هي آلية رمزية تشكّل وعينا الجماعي، من خلال التحكم بطريقة فهمنا للعالم والأشياء من حولنا، يمكن القول إن الطقوس العاشورائية التي مهّدت لولادة مسرح عاشورائي، تحديداً في لبنان، تعدّت البعد الديني والرمزي، ولامست حدود السياسة، خاصة مع تصاعد قوة الأحزاب القيادية في جنوب لبنان، وذلك ما يمكن استنباطه من خلال الطقوس، والمسرح، وتحولاتها عبر العقود.

من إيران إلى النبطية: المسرح شاهداً على المأساة
بالعودة إلى البدايات، تحديداً إلى القرن السابع الميلادي، يشير الباحث اللبناني، نبيل أبو مراد، في كتابه «المسرح اللبناني في القرن العشرين» (2002)، إلى أنّ مأساة الحسين كانت تُروى في الجوامع، التكايا، الساحات العامة، وحتى في المنازل الخاصة، في إيران. وكان هناك شخص يُعرف بـ«روزى كان» يتولى دور الراوي الذي ينسج أحداث المعركة بأسلوب يدمج بين الرواية والمواعظ، ويسرد الحدث ضمن لحن حزين.
تطورت هذه الطقوس مع مرور الزمن، تحديداً في إيران، حيث كانت تُنظَّم المسيرات، وتُقام مراسم البكاء على الحسين بن علي، مع إدخال الحركة الجسدية من قبل المشاركين، التي أصبحت جزءاً أساسياً من الطقس العاشورائي، فينسجم المشاركون مع الإيقاع الحركي، لإظهار الحزن على مقتل الحسين. ومع تطور الوقت، أي بعد عقود من الزمن، صار للتعازي مسرحيات خاصة، لها نصوصها الموضوعة من قبل بعض المؤلفين في ذلك الوقت. وكان يتم تمثيل هذه المسرحيات في الساحات العامة. وبهذا بدأت معالم المسرح تظهر أكثر فأكثر مع خلق الفضاء المسرحي ضمن صيوان خشبي دائري يُسمى «سيكو» ويستعمل كخشبة مسرح، وهو مفتوح من كل الجوانب، وليس فيه ديكورات، والممثلون يتنكرون بملابس تشبه قافلة الحسين.

كان العرض يدوم ساعات وساعات، ويحتدم الصراع الدرامي مع مشهد القتال بين فئتين: الحسين وأهله وأتباعه، والأعداء، لتدور معركة حامية تكون نتيجتها معروفة للجميع، وهي قتل الحسين بن علي ومن كان معه. ومن هنا، تتجلى أعلى مراحل الاندماج العاطفي، «فيكون التأثير عليهم تأثيراً مأسويّاً كاسحاً قد لا تصل إليه أعظم مآسي الإغريق المكتوبة»، بحسب ما يقول أبو مراد.
تحوّلات المسرح العاشورائي: التفاعل بين الدين والسياسة
كيف وصلت هذه الاحتفالات إلى جنوب لبنان، وتحديداً، إلى مدينة النبطية؟ تشير المصادر التاريخية إلى أنَّه مع قدوم الطالب الإيراني إبراهيم ميرزا، الذي كان يدرس الطب العام في «الجامعة الأميركية في بيروت»، إلى النبطية، عام 1918، لاحظ، في ذلك الوقت، أن الشيعة ممنوعون من الاحتفال بعاشوراء، بحكم من السلطات العثمانية. دفع ذلك الشاب الإيراني إلى تقديم شكوى إلى السلطات العثمانية في اسطنبول، عن طريق وزارة الخارجية، وتم إصدار مرسوم يسمح للعائلات الإيرانية المقيمة في النبطية، والتي كان عددها حوالي 20 عائلة، بالاحتفال بعاشوراء. ومع ضعف الحكم العثماني نتيجة الحرب العالمية الأولى، بدأ الشيعة المحليون ينضمّون إلى الاحتفالات.
عقداً بعد آخر، بدأ أهل المدينة يضيفون عناصر درامية على الاحتفال بذكرى عاشوراء، من قبيل إحضار تابوت خشبي في ذكرى مقتل القاسم بن الحسين، أو أن يدخل أحد إلى الحسينية حاملاً رضيعاً مقمطاً وملطخاً بالدماء، مجسداً مقتل رضيع الحسين بن علي. إلى أن عمد الشيخ عبد الحسين صادق، عام 1936، إلى كتابة أول نصّ للتمثيلية العاشورائية. وبهذا يتجلى التقاطع بين الطقس وولادة المسرح العاشورائي في مدينة النبطية.

يلفت أحد أبناء النبطية المطّلعين عن كثب على المسرح العاشورائي، إلى أنه في خمسينات القرن الماضي، قام الشيخ محمد تقي الصادق بتعديل على التمثيليات، وأضاف أحداثاً تاريخية أكثر، تشرح أسباب خروج الحسين إلى كربلاء بعد أن رفض مبايعة يزيد بن معاوية في الحكم، في محاولة لإطلاع العامّة على البعد السياسي والإنساني.
ظلت الأمور تأخذ هذا الشكل حتى سبعينيات القرن الماضي حين نقّح الشيخ صادق الأدوار التمثيلية للحسين والشمر، وبدأت تُقام التمثيليات في الهواء الطلق وتأخذ شكلاً احترافياً ومعمّقاً، لا يكتفي بالسرد، بل يقدّم الحسين كمخلّص للدين الإسلامي. عام 1971، بعد أن أصبح يوم العاشر من محرّم عطلة رسمية في لبنان، تزايد عدد المشاهدين والمشاركين في تمثيلية عاشوراء في النبطية، وأقام المهتمّون بإنشاء مسرح في الطرف الشرقي من موقع التمثيل في ساحة النبطية، الذي أصبح وقفاً حسينياً، وتأسست «جمعية لجنة عاشوراء» التي تولّت تنظيم الذكرى في لياليها العشر.
أخذت هذه الاحتفالات شكلاً ممسرحاً أكثر وضوحاً، حيث بدأت تُعرض بعض المشاهد على منصّات خاصّة، ينفّذها متطوّعون من المؤمنين الذين كانوا يقومون بدور «الممثّلين». وهكذا، أصبح العرض الديني في جوهره نوعاً من الأداء المسرحي، بمقوماته الخاصة: النصوص، الأزياء التاريخية، الأسلحة، خشبة المسرح، وجمهور يشارك بعواطفه. ظلّت هذه الاحتفالات تحظى بحضور لافت في النبطية حتى وقت طويل، حتى أن المرجع الشيعي، السيد محمد حسين فضل الله، قد سمح في إحدى فتاواه، عام 1996، أن تتطوّر احتفالات عاشوراء في اتجاه مسرحي حقيقي، بحيث يتولّى مؤلِّفون ومخرجون مسرحتها بأسلوب فنيّ، بشرط أن تبقي على احترام الجانب الديني.
بقي المسرح العاشورائي في النبطية يعكس تداخلًا بين الدين والثقافة الاجتماعية، ويظهر ذلك بوضوح مع مشاركة الندابة حسيبة هاشم بدير، حتى آخر ظهور لها في بداية التسعينيات، في ذكرى عاشوراء وهي تنعى الحسين. حتى أن الشيخ صادق بقي متمسكاً بمشاركتها، لقوة تأثيرها في المشهد العاشورائي، وما يمكن لها أن تؤثر في النفوس. كان ندب حسيبة يقدم باللهجة اللبنانية المحكية، ويجمع بين التاريخ والبيئة الثقافية للمشاهدين. وللمفارقة، بقي صوتها في مخزون الجنوبيّين وذاكرتهم، حتى أصبح مرجعاً ثقافياً ألهمَ عدداً من الفنانين والمسرحيين اللبنانيين، مثل المخرج علي شحرور الذي استوحى من مواويلها في عرضه المسرحي الأخير «عندما رأيت البحر»، على خشبة مسرح «المدينة» في بيروت، وأعاد تأطير النعي، وفقًا للواقع المعاصر، مما يبرز قدرة المسرح العاشورائي على إعادة صياغة وتجديد التراث الديني والثقافي، لما تحمله عاشوراء، كموروث ثقافي، من قدرة على التكيّف والتفاعل مع سياقات فنية مختلفة.

جدير بالذكر أنَّ العام 2004 كان نقطة تحوّل على مستوى المسرح العاشورائي. يقول أحد أبناء النبطية إنّ العروض المسرحية تطوّرت بشكل احترافي في عام 2004، مع المخرج اللبناني رئيف كرم. مع إدخال مزيد من الإخراج والسينوغرافيا (من أزياء، وموسيقى، وديكورات) لتعزيز الجانب الفني، وتطوير الحبكة الدرامية، والمشهدية برمّتها، ممّا جعلها تجذب اهتماماً أوسع وتفاعلًا مع الجمهور. كما تولّى أيضاً، في السنوات اللاحقة، عدد من المسرحيين المحترفين، مثل مشهور مصطفى وحسام الصباح وجواد الأسدي، إخراج المسرح العاشورائي في النبطية.
لكن مع بداية عام 2006، جاءت الحرب في تموز لتشكّل نقطة تحوّل جديدة، تضاف إلى سلسلة تحوّل تمظهرات عاشوراء، تحديداً على مستوى التجربة التفاعلية. أتت اللحظة في حينها، مشحونةً بخطاب سياسي، يكرّس مفاهيم لطالما كانت تتردّد على المنابر العاشورائية: «هيهات منّا الذلة»، «اللهم تقبل منا هذا القربان»، وغيرها من العناوين التي أعاد حزب الله، تحديداً، تركيزها في محاولة لتجسيد أفكاره بما يتناسق مع حروبه مع إسرائيل.
لم تكن اللحظة التي تلت حرب 2006 إلاّ امتداداً لمحاولة الأحزاب الشيعية في إعادة تأكيد معاني كربلاء، منذ عقود. إلا أنّ المظاهر التي ترافق عاشوراء، في بيروت والضاحية، وغيرها من المناطق الشيعية، من لطم ومسيرات ونصب خيم عاشوراء، كانت محاولةّ لاستقطاب الجمهور الذي لطالما كان يبحث عن ممارسات لإظهار القهر والحزن، وربط التاريخ مع الحاضر، ممّا أعاد تشكيل واقع جديد. فزادت نسبة إقبال المؤمنين بالحسين وأهل بيته على حضور المجالس المركزية التي يقيمها كل من حزب الله وحركة أمل، في المدن والقرى، ومن خلالها برزت بقوّة الخطب السياسية التي كانت تسبق قراءة السيرة الحسينية، على المنابر، بمشاركة فعاليات سياسية من نواب ووزراء ومسؤولين من الحزبين، فأخذت طابعاً يعزز فهم التفاعل بين الدين والسياسة.
لحظة الجنوب، لحظة تطهير صادقة
يحيلنا هذا السرد التاريخي للمسرح العاشورائي وتمظهراته إلى بعض السمات الأدائية التي تذكّر، من حيث شدّة الانفعال الجماعي وتكامل الحواس، ببنية التراجيديا الكلاسيكية. والاستعارة هنا مجازية تحليلية، وليست مطابقة بنيوية، تؤكد أنَّ المسرح العاشورائي والطقوس التي ترافق الذكرى (من لطم، وعزاء، ومسيرات)، ليست فرجةً مسرحيةً وحسب، بل أداء جماعي حيّ قائم على المشاركة والاندماج، ويحرّك في المشاركين مشاعر الحزن. فالمسرح العاشورائي، بلا أي شك، يثير في المتفرّج/ المشارك، مشاعر التطهير أو الـCatharsis، وهو مفهوم أرساه أرسطو، أحد أبرز المنظِّرين الدراميّين الإغريقيّين، ويعبّر عن تنقية الروح وتحريرها من التوتّرات العاطفية والوجدانية، وذلك من خلال مشاهدة ما حلَّ بالحسين وأهله، وبروزه كبطل ثوري حقق انتصاراً معنوياً، رغم عدم التكافؤ العسكري.

لكن في هذه اللحظة التاريخية، وتحت سماء الحرب الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة، يُسجل غياب أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، عن المنبر العاشورائي، وهو غياب يحمل في طيّاته فراغاً رمزياً ثقيلاً بالنسبة للشيعة في لبنان. ففي ظلّ هذه اللحظة الحرجة، كان يُنتظر من نصرالله أن يكون حاضراً، ليس فقط كقائد سياسي، بل كرمز للبطل القومي الذي يُجسّد المقاومة بالنسبة للمؤمنين بالحسين بن علي. ومع غيابه، يُطرح السؤال حول ما إذا كان ما شهدناه في ذكرى عاشوراء هذا العام، هو لحظة تطهيرية معلقة، مترافقة أيضاً مع حاجة الجماهير للتماهي مع رمز قويّ يوحّدهم، ممّا يشير إلى فقدان الخلاص وتحدّيات اللحظة.
اليوم، وهي لحظة الجنوب، كثير من العائلات التي فقدت أفراداً في الحرب الإسرائيلية الوحشية الأخيرة، لم تجد الوقت أو الفضاء لإقامة المآتم أو الحزن الجماعي. ومع حلول عاشوراء هذا العام، شكلت المناسبة لحظةً انفعاليةً منفجرة بالعواطف، أو لحظة شفائية، تُعيد تركيب الهوية الجماعية للبعض، من خلال المشاركة في طقوس عاشوراء والمسرح. عائلات تمّت إبادتها، شهداء، وجرحى، وثكلى، دمار، ونحيب، وحزن جماعي. اغتيل نصرالله، في ساحة المعركة، كما الحسين بن علي. وما على المراقب لتمظهرات عاشوراء الدرامية، إلا أن يدرك أنّ ما حدث كان لحظة تحوّل دراماتيكي كبير، وما حالة «التطهير» التي رافقت عاشوراء هذا العام سوى تحرير للانفعالات والمشاعر، تنقصه لحظة للتأمل من جديد.