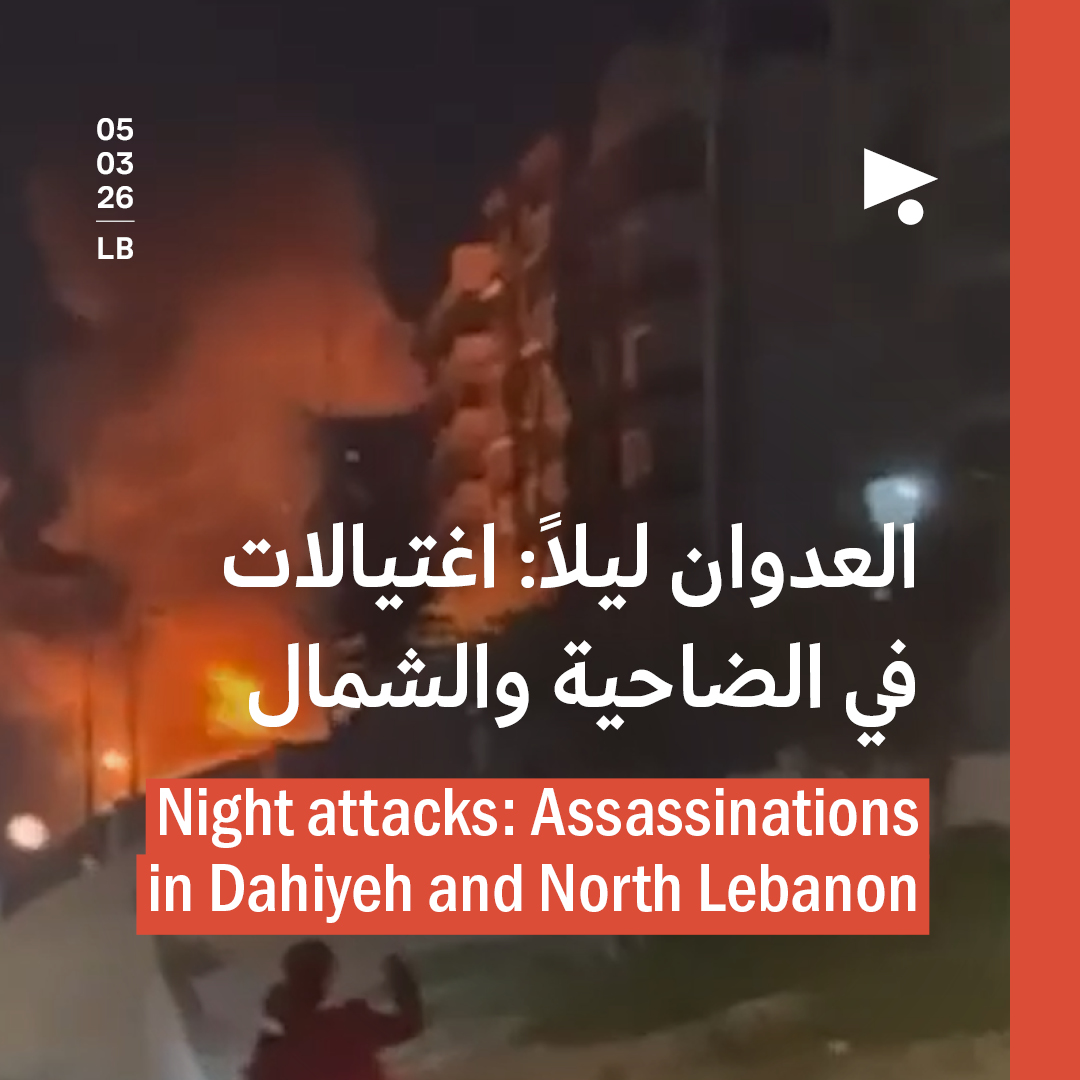يزعم هذا النص أنّ الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدها لبنان تتيح النظر إلى دور الاغتراب اللبناني السياسي وفق أربعة نماذج تصويت، تتبع جغرافيات وشرائح ديموغرافية مختلفة.
كما يزعم أن لا حاجة ولا حجّة لمقارنة هذا الاغتراب وأدواره السياسية بحالات الاغتراب القسري العربية، حيث ليس بوسع المنفيّين او اللاجئين أو المشرّدين الاقتراع الحرّ أو العودة أو حتى زيارة بلادهم.
أربع حالات صريحة
أظهرت النتائج الانتخابية أنّ خصائص الاغتراب العمرية والطبقية والتعليمية وقِدَمه وتنوّعه الطائفي لعبت دوراً أساسياً في تحديد الخيارات السياسية للناخبين والناخبات. وبدا أن أربع جماعات من الديموغرافيات اللبنانية المغتربة شاركت في عمليات الاقتراع.
- ففي بلاد الهجرة القديمة والبعيدة المتنوّعة، مثل أستراليا (ويسري الأمر على البرازيل)، عكست أحوال التصويت بأكثريته المسيحية التنافس بين التيار العوني والقوات اللبنانية وبعض الشخصيات المتحدّرة من عائلات سياسية، إضافة الى بروز تصويت محدود لقوى التغيير.
- في بلاد الهجرات الواسعة المتعاقبة والحضور الطلابي في المدن الكبرى، مثل كندا والولايات المتحدة الأميركية، تفاوتت الخيارات بين الطلاب و«الباقين». ففي حين مال الطلاب لقوى التغيير، عكست سائر فئات الاغتراب بمشاركتها المحدودة (مقارنة بأعداد الجاليات) الانقسامات الطائفية-السياسية القائمة منذ العام 2005 مع حضور بارز للثنائي الشيعي وللقوات اللبنانية.
- في بلاد هجرات الطبقات العاملة بأكثريات طائفية محدّدة، مثل ألمانيا (وإلى حدّ ما سويسرا)، كما في بلاد الهجرات الاقتصادية التجارية أو الاستثمارية، في البلاد الأفريقية تحديداً، بدا التصويت لأحزاب السلطة ومعارضاتها «النظامية»، لا سيّما للثنائي الشيعي والتيار العوني من جهة وللقوات اللبنانية من جهة ثانية، هو السمة الأبرز.
- أما في بلاد الهجرات القريبة، حيث الأكثريات من خلفيات اجتماعية وتعليمية وسطى وعليا، أو حيث الحضور الطلابي واسع جداً، مثل فرنسا ثم بريطانيا، أو حيث العمل هو شأن الهجرة الوحيد والمؤقّت بمعزل عن أمده، مثل دول الخليج العربي، فإن التصويت لقوى التغيير تقدّم على ما عداه.
ويمكن القول إن الاغتراب في باريس ودبي برز كحالة معارضة قصوى للسلطة وللنظام ككل، لأسباب ترتبط بالخروج اللبناني الأخير الذي اتّخذ من المدينتين وجهة رئيسية له، ولانخفاض أعمار المعنيّين فيهما، طلاّباً أو خرّيجين مستخدَمين، ولتشكّل أطر منظّمة في باريس منذ فترة واكبت انتفاضة 17 تشرين. يُعطف على ذلك أن ثمة شعوراً بالذنب رافق المغادرين أو المغتربين الجدد، ودفعهم لمستوى مشاركة أعلى ثأراً لأنفسهم ولمن تركوا في الداخل المنكوب.
يبقى أن ما ذُكر ارتبط باستحقاق خاص، هو الأول منذ الانتفاضة والانفجار، وأن أي عمل تنظيمي في الاغتراب قابل للتعثّر ما لم ترافقه قناعة أن التغييريين في الداخل يخوضون بالفعل مواجهاتهم ويجدّدون بعض جوانب الحياة السياسية. فرغم هلامية الحدود اليوم بين الداخل والخارج نتيجة التنقل والتواصل المباشر الدائمين، يبقى الداخل هو منطلق الاستنهاض والمحفّز له، ولنا في جميع أحداث وتطوّرات العقدين الأخيرين أكثر من دليل على ذلك. الخارج وظيفته إعلامية وديبلوماسية و«تقنية» للتأثير في السياسات والخيارات تجاه لبنان، واقتصادية مالية لدعمه، شريطة وجود ما يبرّر السعي لها ويمدّها بالمشروعية داخله.
في تهافت المقارنات عربياً
تُغري المقارباتُ السياسية المقارَنةُ الناشطينَ والصحافيين على الدوام ليُعملوها، فيقفوا على المشترك والمختلف بين التجارب. وفي حالات الاغتراب عن البلاد المأزومة أو المتجاورة والمتشاركة في عناصر مصائبها، يبدو الأمر مثيراً للاهتمام ولاستخلاص العبر.
لكن هذا لا ينطبق بأي شكل على اللبنانيّين في اغترابهم إن قورنوا بالفلسطينيين أو بالسوريّين (أو حتى بالمصريين واليمنيّين وسواهم). فحركة الذهاب والإياب اللبنانية اليسيرة (إذا ما استثنينا كلفتها المالية) نحو البلد مسألة كافية لإبعاد كل مقارنة مع المُحتلة بلادهم والممحو استقلالها بما يجعل جانباً من كفاحهم الأساسي هو انتزاع حق العودة إليها أو حتى الزيارة لها. الأمر نفسه ينطبق على من تشرّدوا نتيجة القصف والاعتقال والتعذيب والاجتياحات ولا عودة لهم ما لم تسقط أنظمة الحكم عندهم وتتوقّف الحروب. والحرّيات السياسية اللبنانية رغم كل محاولات السلطة كبحها لا يوجد ما يُماثلها في المنطقة (إذا ما استثنينا تونس، ولَو بحذر في الفترة الأخيرة)، بما يجعل المقارنات في السياسة مع «الدياسبورا» العربية بدورها بغير طائل.
هذا لا يعني أن لا تداخل في القضايا السياسية وفي الأولويات وفي ضرورة التحالفات. فارتباط استقرار لبنان واستقلاله بأحوال سوريا وإيران مسألة وجودية. ووقف العدوانية الإسرائيلية وجرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة شرط من شروط التعامل مع حصانة المنتهكين للقوانين والمرتكبين للجرائم في كامل المنطقة. وربط التحرّر من الاستبداد بمواجهة الاحتلال هو في جوهر الوعي السياسي لدى جيلٍ واسعٍ من الناشطين السياسيين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين والعرب عموماً. والعمل على هذا الأساس لإيجاد سبل تنسيق وتضامن حول قضايا سياسية ومجتمعية وثقافية من الأمور التي يمكن للمعنيين في صفوف الاغتراب اللبناني التفكير بها، بموازاة العمل اللبناني الخاص وأولوياته الملحّة. لكن مقارنة الحالات والظروف لا تستقيم.
يبقى أن المصاعب والانهيارات مرشّحة للاستمرار في لبنان وفي المنطقة، والتحدّي الأساسي للناشطين والناشطات سياسياً في أوساط الدياسبورا سيكون تنظيم أنفسهم للعمل «المُمأسس» والنفس الطويل...