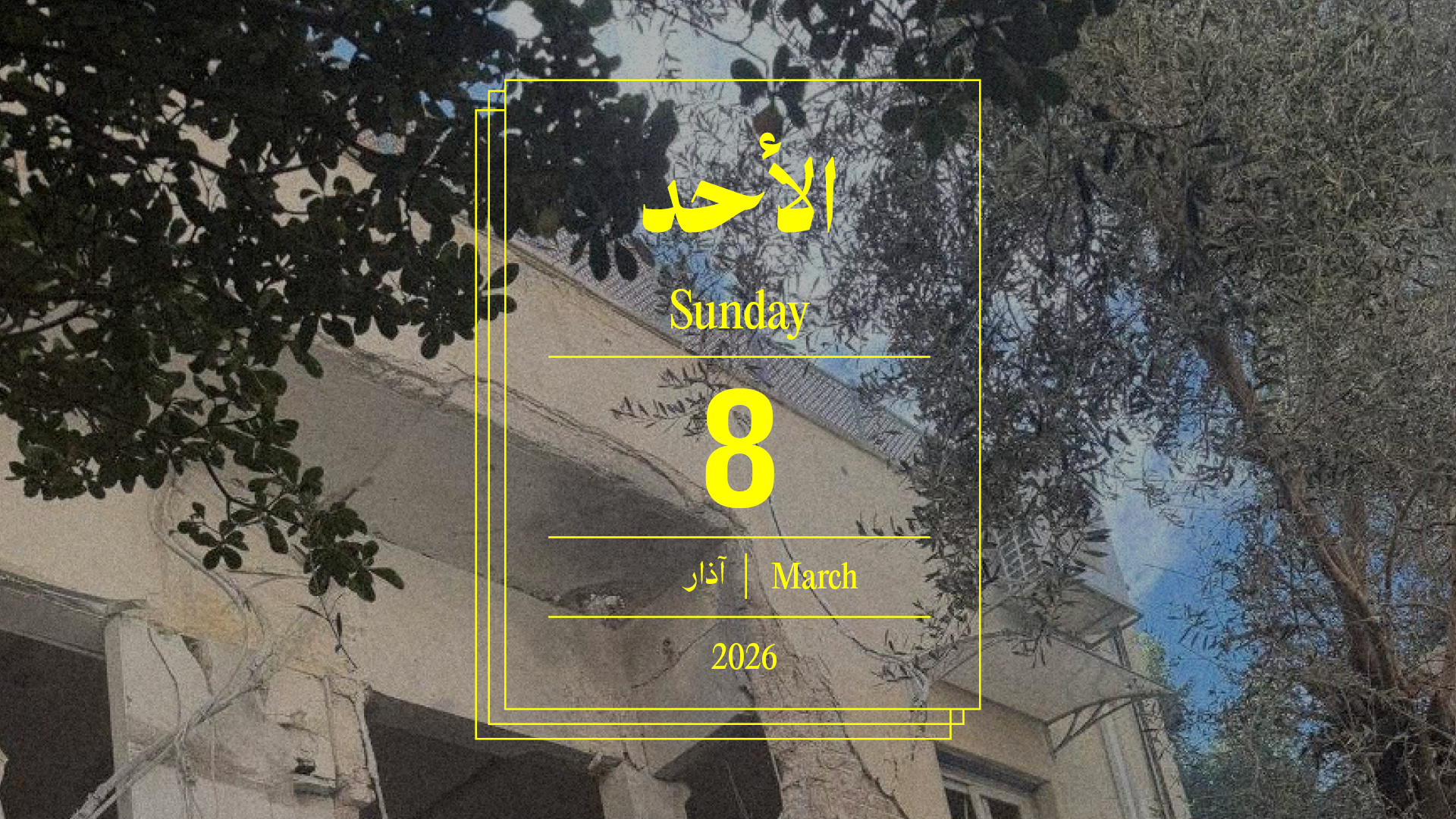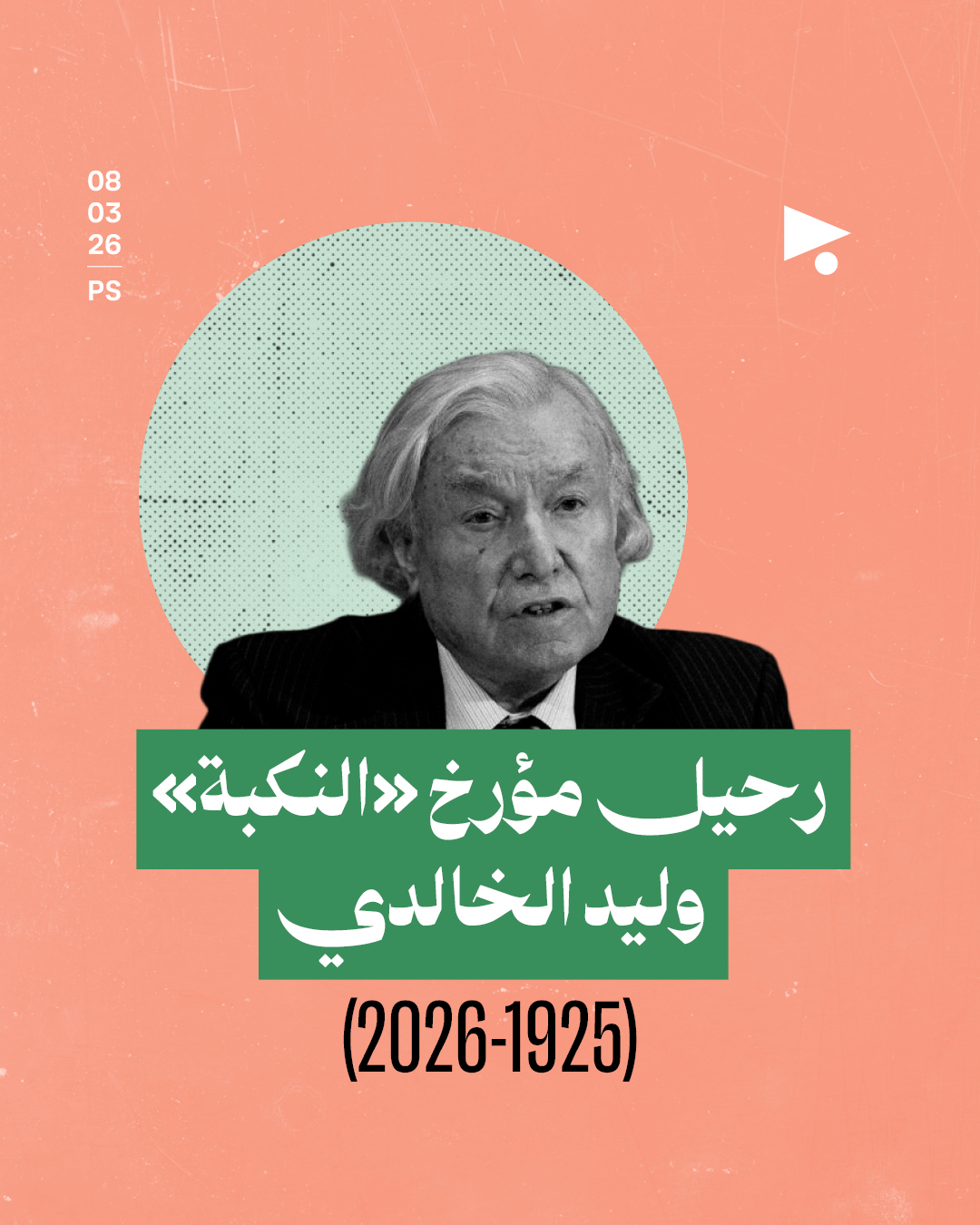اللاجئ بين التنميط والترحيل
تمثّلت إحدى المهام الأساسيّة للخطابات العنصريّة ضدّ اللاجئين السوريين بمحو الفروقات بين لاجئ أو شبّيح أو رجل أعمال، حيث يتطلّب الاعتراف بفروقات كهذه الوقوف جديّاً عند الوسائل المُتاحة لكلٍّ من هؤلاء اللاجئين للنجاة، وبالتالي عند أوضاعهم الإنسانيّة. ووسط هذا الخلط والتجهيل المتعمّد، من المُفيد والضروري أن نُعيد تعريف اللاجئ. بحسب تعريف منظمة العفو الدولية، اللاجئ
هو الشخص الذي فرَّ من بلده جراء خطر التعرُّض لانتهاكاتٍ خطيرةٍ لحقوقه الإنسانيّة وللاضطهاد. حيث تكون المخاطر التي تُهدّد سلامته وحياته قد بلغت حدّ اضطراره إلى أن يختار المغادرة وطلب السلامة خارج بلاده، لأنّ حكومة بلده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له. ولِلّاجئ الحقّ في التمتّع بالحماية الدوليّة.
في ظروف كالتي وصفتها منظمة العفو الدولية عن اللجوء، لم يكن مستغربًا أن تفشل خطّة «العودة الطوعيّة» التي كانت تهدف إلى «عودة 15 ألف لاجئٍ إلى سوريا شهريّاً»، حيث لم يُسجّل على العودة سوى أعدادٍ قليلةٍ.
ومع فشل الخطة، بات هناك توجُّه نحو العنف والعودة القسرية للّاجئين إلى البلد الذي فرّوا منه. من الصعب تحديد مصدر أو توقيت شرارة هذا التصعيد المباغت ضدّ اللجوء السوري في لبنان في ظلّ سنوات من التأجيج على الكراهيّة. فمنذ نحو ثلاثة أسابيع، انطلقت حملة أمنيّة على امتداد الأراضي اللبنانيّة، شملت مداهمات للمنازل والمخيّمات واعتقالات عشوائيّة للّاجئين، بموجب قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر بتاريخ 24 أيلول 2019 بحقّ المخالفين، خاصّة لجهة الدخول بصورةٍ غير شرعيّة.
أنا مالك عمري 29 عاماً
يعيش اللاجئون السوريّون منذ أسابيع حالات من القلق والارتياب، بينما يتمّ التفاوض حول «ملفّهم» لدوافع سياسية أو اقتصادية. تحدّثتُ إلى العشرات منهم ومنهنّ في الآونة الأخيرة، أخبروني عن الترحيل القسري، ما قبله وما بعده، وعن الأفق المسدود أمامهم وعجزهم أمام هول ما يحدُث.
توصّلت إلى مالك (اسم مستعار) بعد جهد طويل، لكنّه كان مستعدّاً للكلام دون حذر، كون سرد ما حصل معه هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذه.
في الحادي والعشرين من الشهر الجاري (نيسان)، وفي طريقي إلى أحد زبائني، أوقفتني سيارتان تحت جسر برج حمود، جانب سوبر ماركت «وش السحارة». نزل منها ثلاثة عناصر من مخابرات الجيش وطلبوا أوراقي الثبوتيّة. أعطيتهم هويّتي. طلبوا بعد ذلك إقامتي. فأخبرتهم أنّني دخلت لبنان خلسة، غير أنّني لاجئ ومُسجّل في مفوضية شؤون اللاجئين. وضعوني في السيارة واتجهوا بي إلى ثكنة للجيش في الأوزاعي. هناك وجدت نحو خمسة عشرَ رجلاً سوريّاً قد تمّ اقتيادهم من مناطق مختلفة. وبعد مرور خمس ساعات، وضعونا جميعاً في سيارة. كانت الوجهة نقطة المصنع. وضعونا قبيل حاجز الفرقة الرابعة، قاموا بإرجاع أوراقنا الثبوتيّة، أعطونا زجاجات مياه للشرب ودوائي للضغط.
على الرغم من كلّ شيءٍ، كانوا «محترمين ولم يزعجوننا». وبعد انقضاء نحو ساعتين، أتت سيارة تابعة للفرقة الرابعة. أخذوا ثلاثة شباب منّا، بقينا على الحدود يومين مفترشين الطرقات، ومعنا عائلات ومن ضِمنهم أطفال كان قد تمّ ترحيلهم أيضاً من لبنان، فيما كانت السيارات العابرة بين الحدود تقوم بتزويدنا بالطعام والشراب.
بعد يومين، عاد الشابان مُبرحين ضرباً، وبقي الثالث في التحقيق. في منتصف ليل البارحة، استطعنا الدخول مرّة ثانية إلى لبنان بعد أن دفع كلّ شخص 150 دولاراً.
يلي كان حامل مصاري فات، ويلي ما معه بعده عالحدود.
أنا مالك عمري 29 عاماً متزوج ولديّ ثلاثة أطفال وأعمل «حلّاق عالطلب». هربتُ إلى لبنان بعدما قضيتُ ستّ سنوات من حياتي في زنازين الاعتقال في سوريا. نعم دخلتُ لبنان خلسة أملاً بالنجاة. عندما اقتادوني إلى الحدود، لم أشعر بشيء. استشعرت بدنوّ أجلي لكنّي تذكرت أنّني أعيش جحيماً آخر في لبنان أساساً. عُدت بذاكرتي إلى أيام الاعتقال، إلى اليوم الذي خرجت فيه مدمَّراً جسديّاً ونفسيّاً، بعدما دخلتُ مرّة ثانية لبنان. فكرتُ في الانتحار، أو فكرت أن أسلّم نفسي إلى النظام السوري.
شخص في وضعي لا يمتلك فرصة لاستخراج جواز سفر، ما هي فرصه في الحياة؟
ماذا حدث في جونية حارة صخر؟
في الثامن عشر من نيسان، أصدر «مركز وصول لحقوق الإنسان» بياناً عاجلاً على خلفيّة تنفيذ الجيش اللبناني عمليّات ترحيل مفاجئة بحقّ العشرات من اللاجئين السوريين، في عدد من المناطق، ومنها منطقة حارة صخر في جونية. تحدّثتُ مع رهام (إسم مستعار) لتروي لي ما جرى، تقول:
في العاشر من نيسان، الساعة الرابعة صباحاً، داهم منزلنا أفرادٌ من الجيش، أوقفوا زوجي على الحائط، بعدما رأوا إقامته منتهية الصلاحيّة. أخذوه وأخذوا معه أخاه، بالإضافة إلى العشرات غيرهم من الشباب. بكيت وطلبتُ منهم تركه لأنّني حامل وعلى وشك الولادة، لكن هذا لم يُغيّر شيئاً.
تضيف مرتبكة: منذ تلك اللحظة لا أعلم عن زوجي أيّ معلومةٍ. صَمتَتْ قليلاً، ثمّ أكملت:
هناك أخبار تقول إنّهم في لبنان، وأخرى تقول إنّهم في سوريا.
يعمل زوجي في مهنة البلاط، كما أنّه دخل لبنان بشكلٍ نظاميّ، كان يحمل إقامة نظاميّة إلّا إنّه لم يستطع تجديدها لأسباب تتعلّق بكفيله اللبناني. تواصلت مع الأمم، لكنّهم قالوا إنّهم لا يستطيعون فعل أيّ شيءٍ. أنتظر وأمامي حقيبتي المجهّزة للولادة، لكن حتى تكاليف الولادة لا أستطيع تغطيتها. فلم يكن لي أحد سوى زوجي.
صُوَرٌ عن الخوف
ليست المرّة الأولى التي يُباغِت فيها الخوف حيوات السوريّين في لبنان، الآن يمكن أن أقول أنّه عنف مُركّب، تذكير بأنّهم لا يزالون في خطرٍ، وفي أيّ لحظة يمكن أن يُرْمَى بهم في سوريا وسط الخطر الذي نكّل بهم على مدى أعوام. هناك مجموعة على فيسبوك تجسّد كيف يعيش الخوف بين السوريين من خلال مئات المنشورات التي يسأل أصحابها فيها:
كيف الطريق من صيدا لبيروت؟
حاجز المدفون عم يفتش عالإقامات؟
عم يرحلوا نسوان؟
كيف فيني أعمل تسوية بالأمن العام؟
في حاجز عالدورة؟
انا مطلوب للنظام إذا رحلوني بموت، بس ما فيني أعمل إقامة، شو أعمل؟
لا يحتاج الأمر إلى أكثر من بحث صغير لتدرك حجم تعقيد استصدار إقامات نظاميّة إلى حدود استحالتها أحياناً. يقول أبو غيث (إسم مستعار) في هذا المجال:
أنا كَربّ أسرة بدأت بترتيب أموري للهروب قبل أن يتمّ رَمْيِي وعائلتي على الحدود ونُترك نُواجه مصيرنا وحدنا. حتى الأمم المتحدة، لم أعد أشعر بأنّها تحمي اللاجئين بعد هذا الكمّ الذي تلقّيناه من الخذلان، لا أمتلك رفاهيّة اختيار المكان لكنّي مستعد أن أعيش في الصحراء، أصبح عندنا رهابٌ من كلّ شيءٍ، لدرجة أنّ صوت طفلٍ صغيرٍ في الشارع يثير قلقنا، لا يمكن أن يُطلق على الذي نعيشه اسم حياة.
أعرف أنّ هذا الكلام قد يبدو مكروراً لكنّنا لا نملك غيره، ما يعيشه اللاجئون اليوم هو ترجمة حرفيّة لمعنى الخسارة، ومعنى أن يكونوا وحيدين في هذه المجزرة. لا يُمكننا إلّا أن نعترف أنّ اللاجئين اليوم يُواجهون مصيرهم بمفردهم وبعُزلتهم وبخوفهم وببعض آمالهم وبإيمانِهم بأنّ الحياة في لبنان ليست الأفضل لكنّها قد تفسح مجالاً لعيش المزيد منها على علّاتها.