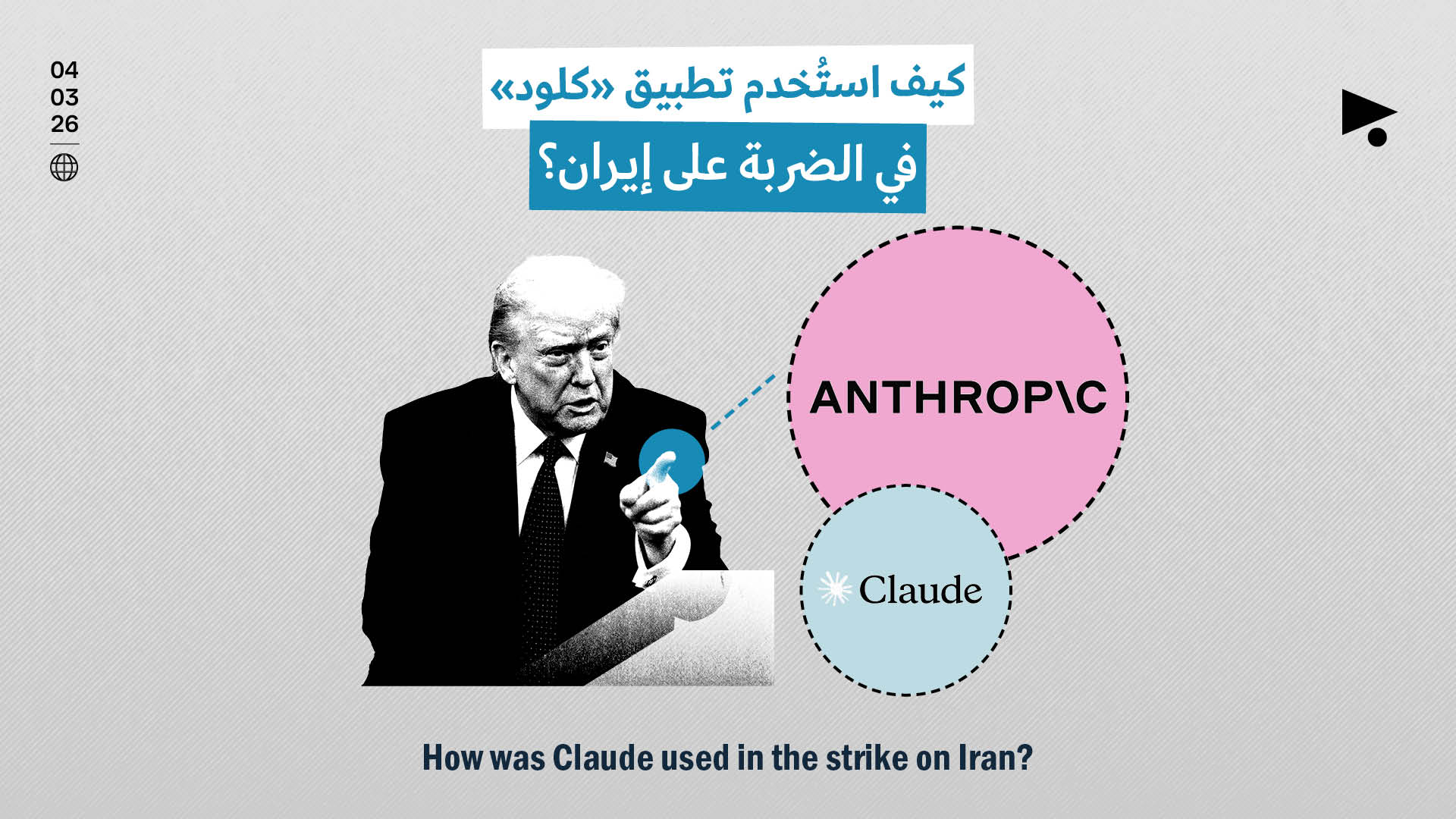قبل أيّام، كان سائق التكسي يستمع إلى تحليلٍ سياسيّ على الراديو. قال المحلّل: ما من هويّة وطنيّة موحّدة في سوريا. لم يعجب هذا الكلام السائق، فردّ قائلاً: شو يعني؟ ليش انت شو مكتوب على هويتك؟ وين ساكن؟ شو هالحكي الفاضي؟
ربّما كان هذا التعليق الوحيد المعبّر الذي سمعته منذ بداية معارك شمال شرق سوريا والمحاولات اليائسة للتفاهم مع قوّات سوريا الديمقراطية. بعد عامٍ على فشل المفاوضات، أطلقت السلطات معركة السيطرة على مناطق «قسد» من حلب. تقدّم الجيش بسرعة غرب الفرات، وأكمل طريقه نحو حقول النفط والغاز والسدود في الجزيرة. حصلت الدولة على جوكر النفط، فتريّثت. صاغت اتفاقاً قدّمته كضمانةٍ للتمثيل وحماية القرى الكرديّة من الانتهاكات، لكنّه بدا كمحاولةٍ لاستقطاب الكرد نحو الدولة من جهة، ومحاصرة «قسد» من جهة أخرى.
قبل الاتفاق، أصدر الرئيس الشرع مرسوماً يمنح الكُرد جنسيّتهم وبعض حقوقهم. هذا المرسوم، كالاتفاق، جاء في سياق معركة كسر شوكة «قسد»، وليس تنفيذاً للتفاهمات. كان يمكن أن نختصر الطريق قبل سنة، وندرج بنود المرسوم بالإعلان الدستوري، لضمان بناء دولة حقوق ومساواة. أو كان يمكن أن يأتي المرسوم من نيّةٍ صافية (أو شعبيّة على الأقل) لإنصاف الكرد بعد عقودٍ من العنصريّة والحرمان. رغم الفارق الإيجابي الذي قد يصنعه، جاء المرسوم أشبه بمراوغة سياسيّة.
لم يتّضح بعد مصير اتفاق 18 كانون الثاني، انتظاراً لانتهاء المهلة التي منحتها الدولة لـ«قسد». وبحال تنفيذه، يبدو صعباً أن يحقّق غرضيه الأساسيين، وهما وحدة سوريا واسترداد الموارد الطبيعية. فقد أصبح الهدفان جزءاً من خطابٍ رسميّ- شعبي يناقض الاتفاق نفسه.
وحدة سوريا
حافظت السلطات على سرديّة توحيد الأراضي السوريّة تحت قيادةٍ مركزيّة. يمكننا تبنّي جزء من هذه السرديّة، من باب أنَّ إعادة بناء ما مزّقته الحرب ليس حكراً على المدن المركزيّة، بل يجب أن يطال كل شبرٍ من سوريا. لكن كي نكون واقعيّين، لا يمثّل هذا التفسير الجو العام. بقيت فكرة توحيد سوريا مشتّتة ومتناقضة، يعتبرها البعض تهديداً للأقليات الإثنية والطائفية، والبعض الآخر فرصةً لإعادة الإعمار، أو سبيلاً للإذلال. للأسف، هيمنت الميول القمعية على مشاريع توحيد سوريا بالمعنى الحقيقي، أي محاولات سدّ الشرخ الذي يتّسع يوماً بعد يوم بين السوريّين. لم يعد التوحيد في المخيّلة السائدة مشروعاً وطنياً يردّ لنا كرامتنا، بل تحوّل أمام أعيننا إلى ترسيخ طبقاتٍ جديدة متفاوتة من المواطنة.
انعكس هذا الخطاب المتناقض على أخذ مناطق «قسد». كان في الظاهر سعياً للوحدة، لكنه بباطنه مزيدٌ من التفرقة. المخجل اليوم أنَّ السرديّة الشعبيّة لم تنشغل فعلاً بتلاحم السوريين والتضامن والحنين لزيارة الجزيرة والفرحة لاحتمال عودة أهلنا الكرد إلى قراهم التي هُجّروا منها قسراً. كان كلّ همّنا استعادة سوريا للنفط والغاز من الجزيرة، وكأنّ سكّانها ليسوا سوريّين ولا يملكون حصّةً من هذه الموارد.
استرداد الموارد الطبيعية
لا أذكر أنّه كان يدور بالفضاء العام مثل اليوم خطاب استرداد الموارد الطبيعية من «قسد»، قبل مقابلة الرئيس الشرع على قناة «شمس». بعد حديثه المفصّل عن الكم الهائل من الموارد التي تحتكرها «قسد»، بدا وكأنّ سوريا عاشت لحظة إدراك جماعيّة واصطفّت خلف هذا الخطاب. تقتصر نشوة النصر اليوم على استعادة الموارد واحتمال توفيرها بأسعار رخيصة. بالفعل، تشعر شرائح واسعة من السوريّين بالظلم بسبب حرمانهم من موارد بلادهم، لكن كالعادة، سيطرت على الأجواء المبالغة بالمظلوميات، التي باتت عصب التواصل بين السوريين، بسبب غياب كل أشكال العدالة.
المشكلة ليست فقط بتعزيز المظلومية، بل أيضاً باختزال الجزيرة السوريّة لحقل نفطٍ ومصدرٍ للمال وتذكرةٍ للازدهار المنتَظر. تُعرّض هذه النظرة الجزيرة لمزيدٍ من الإقصاء وربّما الاستغلال أيضاً. لماذا لم ننشغل، مثلاً، بآليات جبر ضرر الأهالي الذين تعرّضوا للتنكيل من قبل نظام الأسد وبعده داعش؟ لمَ لا تعنينا الأراضي المنهوبة والأبناء المغيّبون والثقافة المهمّشة؟ لماذا لا نفكّر بمعضلة العدالة الانتقالية في الجزيرة؟ أليس ذلك بقدر أهميّة النفط؟
نقف اليوم، إذاً، أمام خطابٍ نردّده ولا ندرك قساوته. خطابٌ يمزّق طموحنا ببناء مجتمعٍ لا يحتقر نفسه وبعضه. منذ سقوط نظام الأسد، يختار معظمنا الزاوية الأكثر تطرّفاً وإقصاءً عند كلّ مفترق طرق. لكنّ هذه الزوايا لن تقتل الضوء الخافت داخل التكسي الأصفر، ولن تُسكِت محاولات النقاش في الغرف المغلقة والدكاكين الصغيرة، ولن تقتل حقيقة أنّ هناك شيئاً ما يجمعنا.