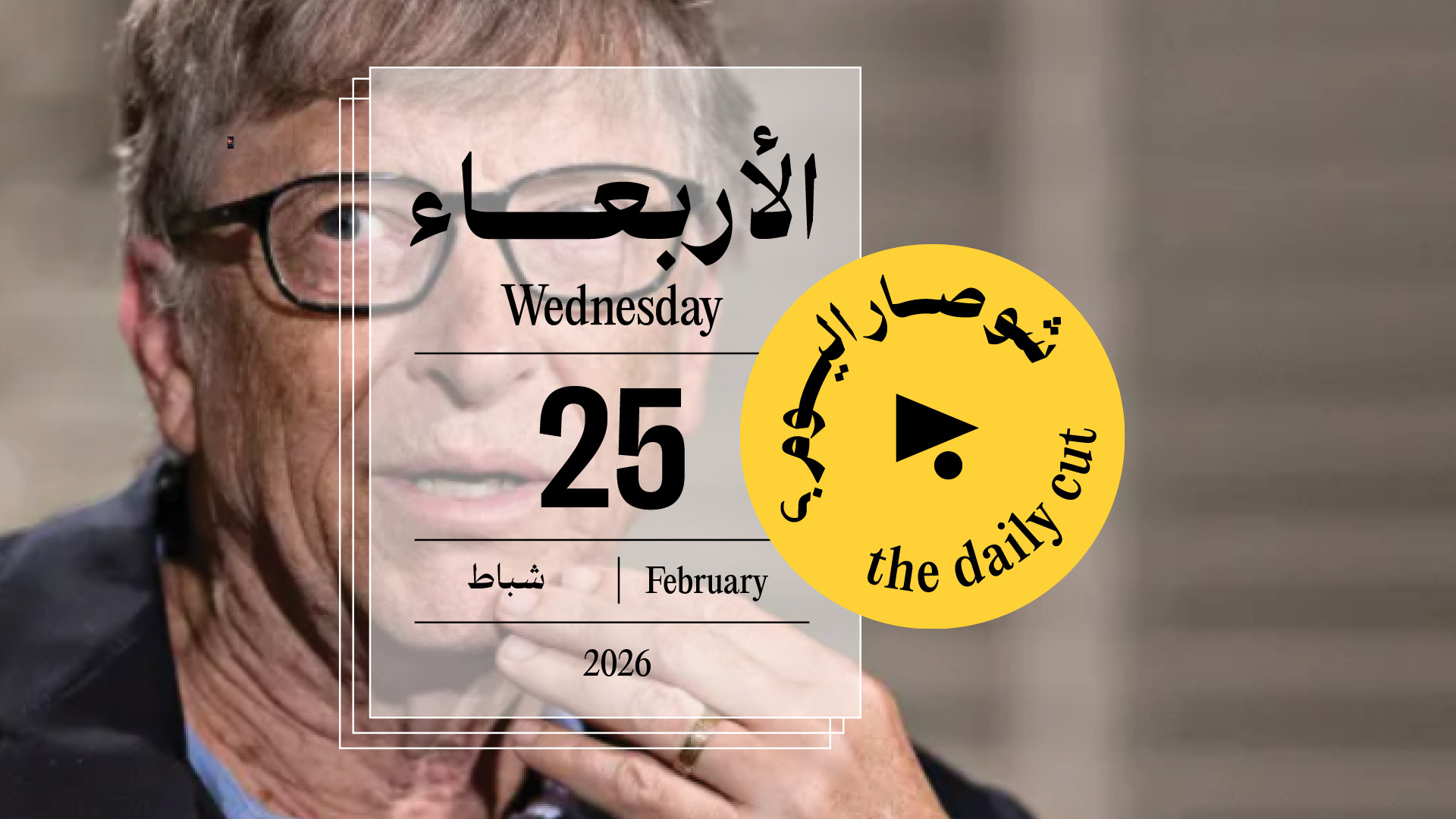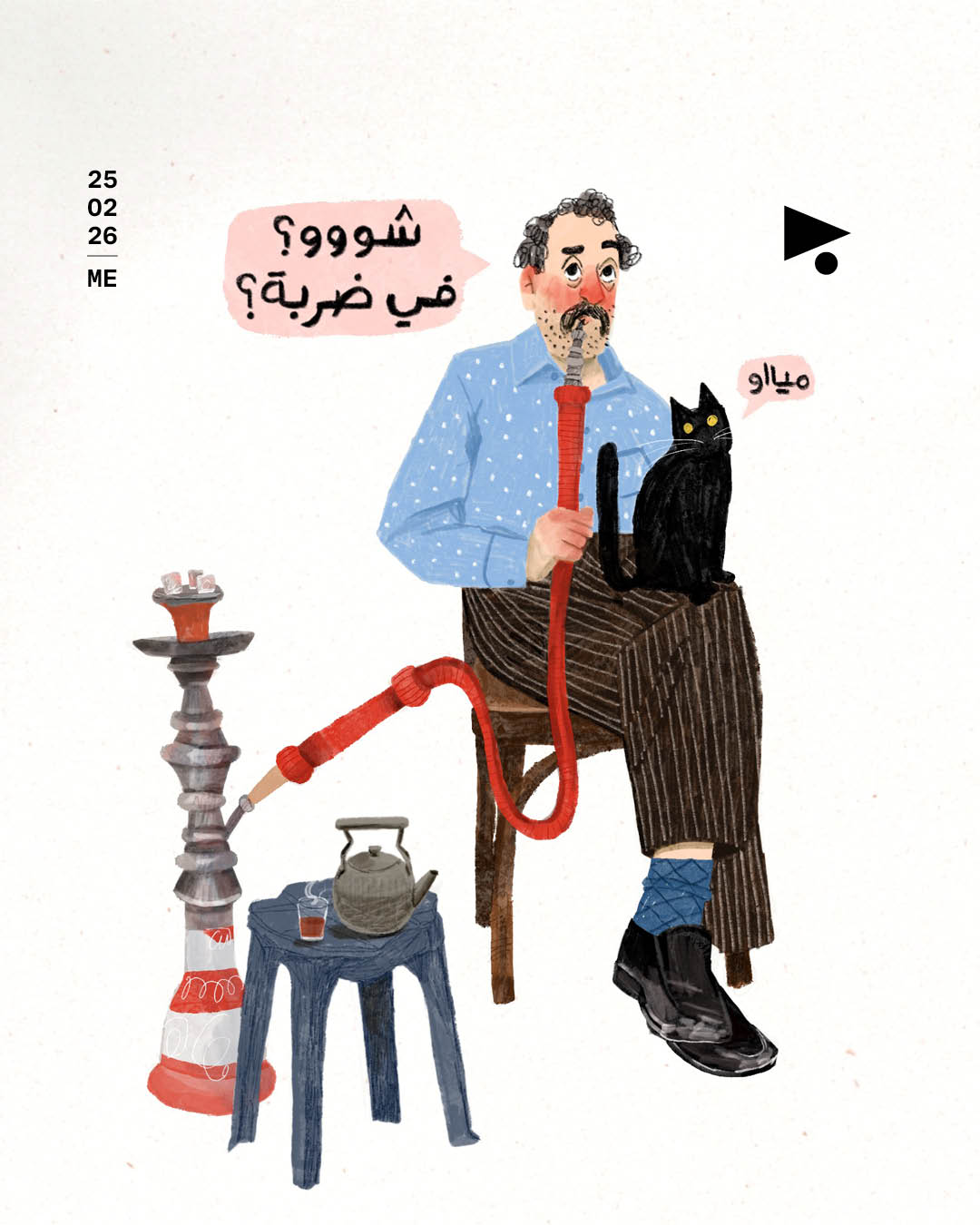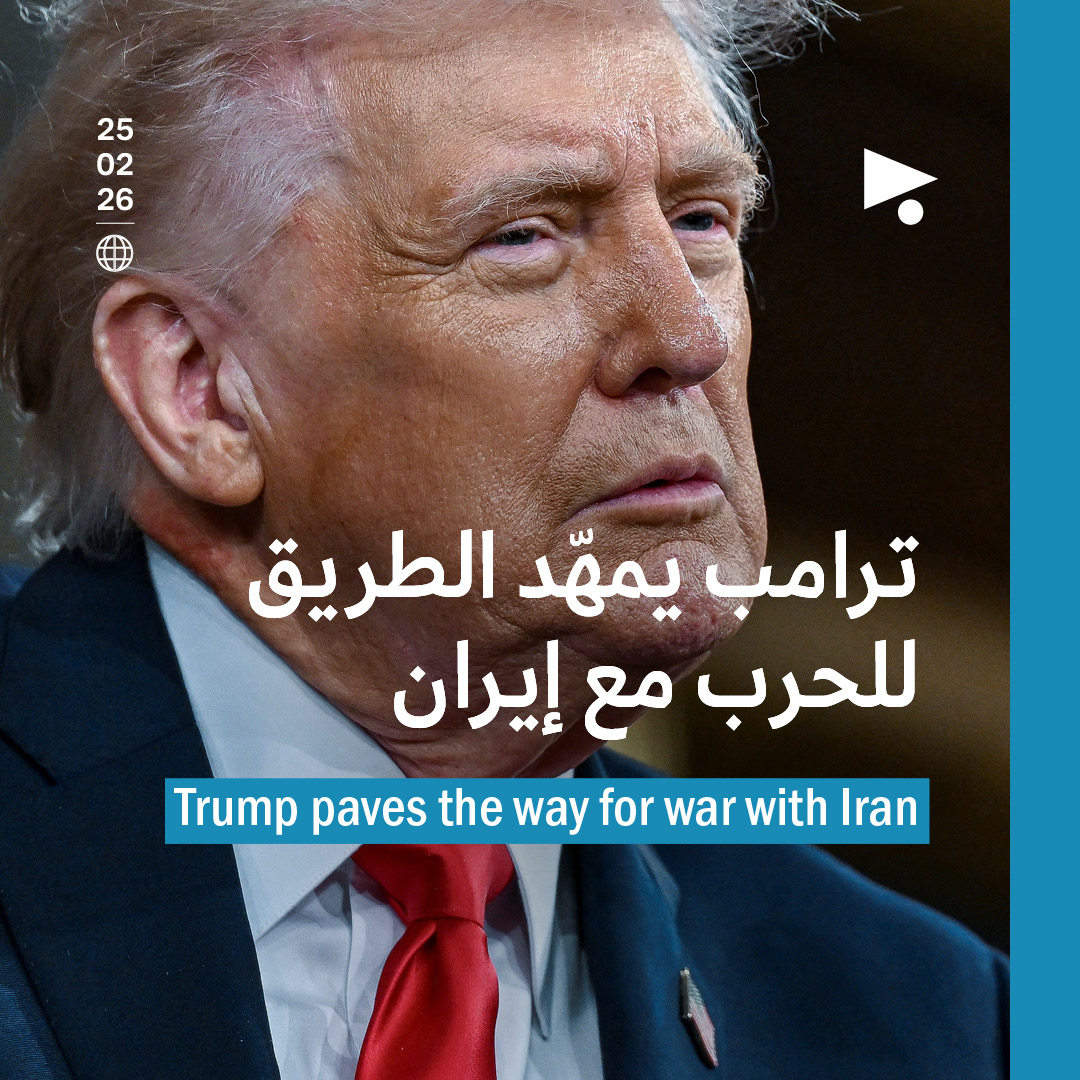عادت مجموعة من اللاجئين السوريين من مخيمات اللجوء في منطقة القاح على الحدود السورية التركية إلى مناطقهم المتضررة، من دون أي إجراءات إصلاحية مسبقة أو إعلان عن سياسة شاملة تدعم مسارات العودة. يُنذر هذا الواقع بتوسّع فجوة العدالة المكانية في السياق السوري، إذ يُترك الأفراد لمواجهة آثار الدمار بمفردهم. وعلى الرغم من مساهمة بعض المنظمات في تخفيف هذا العبء من خلال مبادرات ترميم محدودة، إلا أن تلك الجهود تواجه تحديات كبيرة، ما يحدّ من أثرها ويعمّق الحاجة إلى حلول أكثر شمولية واستدامة. فغياب العدالة المكانية يُعَدّ عاملاً محورياً في تفاقم الفروق المجتمعية ويساهم بشكل أساسي في تعميق التهميش وترسيخه، ليصبح قدراً مفروضاً سواء على صعيد الأفراد أو الجماعات.
بين إقصاء النظام السابق وغياب خطة النظام الحالي
لطالما عمل نظام الأسد على تسليط قوانين تخدم مصالحه في كلٍّ من قطاعَيّ العقارات واستصلاح الأراضي. وقد نشبت على إثر ذلك العديد من المظالم المكانية التي كانت محرِّكاً في الثورة السورية. إلا أنه في فترة ما بعد السقوط، تكاد تختفي العدالة المكانية من النقاشات السورية، رغم الدمار الذي طال 40% من المساحة العامة، وإلحاح عودة اللاجئين بعد سقوط نظام الأسد وغياب الخطة الشاملة للعودة. فبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يتجاوز عدد اللاجئين الـ12 مليوناً، بينما بلغ عدد العائدين، وفق مفوضية اللاجئين، أكثر من 1.5 مليون، بين لاجئ داخلي وخارجي. تواجه هذه العودة تحدّيات جسيمة، إذ يغطّي الدمار 60% من بنية حلب السكنية والخدماتية و40% من حمص، ويمتدّ ليشمل الرقّة والغوطة الدمشقية وإدلب وحماة وغيرها، مما ينذر بأزمة خدمات حادّة في مناطق العودة. تعود هذه الأزمة إلى سياسات النظام السابق التي عزّزت المركزية الحضرية في مدينتَيْ حلب ودمشق على حساب الأرياف والضواحي، ممّا عمّق الفجوة المكانية وزاد من تفاقمها بعد الحرب. فقد آثرت سياسات النظام إعلاء مصالح السوق على احتياجات السكان، متجاهلةً مبدأ العدالة الذي يتطلّب توزيعاً عادلاً للموارد والخدمات وضمان وصول الجميع إليها.
وكمثال حيّ على ذلك، ما زال قائماً حتى اليوم مشروع «ماروتا سيتي» الذي هجّر السكان بموجب القرار رقم 66، وخصّص مساحة 1,160,000 متر مربع للمشروع في مقابل 370 ألف متر مربع لسكان المنطقة. كان قد تولّى مختبر iwlab دراسة تبعات مشروع «ماروتا سيتي»، وصرّح المعماري إياس شاهين، أحد مؤسسي المختبر: نرى في مشاريع مثل «ماروتا سيتي» بدمشق تجسيدًا لسياسات الإقصاء عبر الفضاء: مشاريع تجميلية أو استثمارية تنتج فضاءات تعزز الظلم المكاني، وهذا يستوجب إعادة النظر في منظومة العمل في المدينة.
إذن، ليس غياب العدالة المكانية بالمستجدّ، بل هو نتاج سياسات متجذّرة تتّخذ اليوم أشكالاً جديدة، في ظل آليات عودة اللاجئين دون وجود سياسة شاملة تضمن وصولاً عادلاً للخدمات في المناطق الأكثر ضرراً. فما دشّنته سياسات الأسد في استباحة المكان، تجسّد فيما سبق بقوانين ومشاريع لا تصبّ في الصالح العام، وهي تترسخ اليوم في غياب سياسات تضمن للّاجئين السوريين حقوق المكان.
العدالة المكانيّة
في الخطاب النقدي لما بعد الحداثة، ظهر مفهوم العدالة المكانية الذي يعيد تفكيك مفاهيم المكان والمشاركة في البيئات الحضرية، حيث يتجلى المكان في المدن المعاصرة كساحات صراع طبقي يهيمن عليها تراكم رأس المال على حساب المجتمعات المهمشة. في آليات تطبيق العدالة المكانية ضمن الواقع السوري المعقد، يعمل كل من إياس شاهين ووسام العسلي في iwlab على تحليل التفاوتات الحضرية واقتراح حلول تشاركية، وفق مفهوم هنري لوفيفر في «حق المدينة»، وهو الحق بالمشاركة في تشكيل الفضاء وليس فقط استهلاكه أو السكن فيه، ومع الاقتران بتوسيع ديفيد هارفي لهذا المفهوم، ليؤكد أن العدالة المكانية مرتبطة بإعادة توزيع الموارد والفرص بشكل عادل، لا بتركها لقوى السوق أو الحلول الفردية. كان قد قدّم لوفيفر رؤيةً نقديةً للمدن الحديثة التي تفصل بين الحيّز العام والخاص وتعزّز الفردانية، مؤكداً أن المدينة عبارة عن فضاء جمعي حيوي يُشكّل العلاقات الاجتماعية والممارسات اليومية. فإعادة إنتاج المدينة ليست عملية تقنية صرفة، بل هي بالأساس فعل اجتماعي ينبثق من سكانها الذين ترتبط هوياتهم وسلوكياتهم ومعارفهم عضوياً بهذا الفضاء المشترك. ومنه، الإنسان مشارك فاعل وليس متلقّياً سلبيّاً.
لكن ما تعيد الحلول الفردية في عملية إعمار سوريا إنتاجه هو القطيعة بين الإنسان ومحيطه، وتحويل المدن لكتل إسمنتية ميتة خارجة عن فضاء التفاعل والتشاركية. يعلق شاهين حول عودة اللاجئين دون خطة: إن ذلك لا يعني سوى غياب أي اعتراف جمعي بحقوقهم في المكان؛ هم يعودون كأفراد، يرمّمون بأيديهم ما كان يفترض أن تعالجه السياسات العامة. هذه العودة المفروضة تكرّس فجوات السلطة والموارد، وتعزز ما يسميه هارفي «إنتاج اللامساواة عبر الفضاء»، إذ يصبح المكان أداة لتثبيت تفاوتات بنيوية بدلًا من أن يكون مساحة لتحقيق العدالة. تعمل هذه التفاوتات على خلق مساكن عشوائية تحفز دائرة المظلومية والصراع السياسي. فبحسب شاهين لا تتوقف غياب العدالة المكانية في سوريا عند حد غياب التخطيط، بل تعكس بنية أعمق من الإقصاء الاجتماعي والسياسي: نحن اليوم أمام ما تسميه بعض الأدبيات النقدية «فضاءات ما بعد الصدمة»، أماكن تعيش في حالة تعليق مستمرّة بين الدمار والإعمار، تتقاطع فيها آثار الحرب مع غياب العدالة، فتتحول إعادة البناء بحد ذاتها إلى أداة سياسية أو اقتصادية. تشكل التشاركية والشمولية محاور العدالة المكانية، بغية توزيع الخدمات بشكل عادل، وتمثيل صوت الجماعة في صناعة المدينة لتقف أمام هيمنة احتكار سياسات رأس المال.
سياسات السوق بدل خطّة شاملة
تسعى سياسات إعادة الإعمار عادةً إلى جذب المستثمرين في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. لكن مع غياب الحوكمة الرشيدة، تؤدي سياسات السوق إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي، وتراجع التنمية. وفي غياب الخطة الشاملة، تؤدي الحلول الفردية في إعادة إعمار الدمار الهائل الذي خلفه نظام الأسد، إلى تفاوت في البنية المكانية. وتتفاقم هذه اللامساواة اليوم ضمن سياسات السوق التي تفضل مشاريع ضخمة مثل «برج ترامب» أو مشروع قاسيون في دمشق، بدلاً من توجيه الجهود لإصلاح ما دمرته الحرب. يرى شاهين أن معظم المبادرات الحالية تفتقر إلى بُعد العدالة، وتحرّكها قوى السوق التي تستبعد الفقراء والهشّين:
نحن لا نتحدّث هنا فقط عن بناء ما هدمته الحرب، بل عن عمليّة «عقرنة» للمكان- تثبيت السلطة على الجغرافيا، وإعادة تشكيل الحقوق بحيث تنحاز إلى من يملك القوة والنفوذ. من هنا، يصبح من الضروري إعادة التفكير في المصطلحات التي نستخدمها؛ إذ قد يكون مصطلح «إعادة الحقوق» أكثر صدقًا ودقّة من «إعادة الإعمار». فهو يوجّه النظر إلى دور السلطة والمجتمع معًا في استعادة العدالة، لا مجرّد استعادة الحجر. العدالة لا تُقاس بعدد الأبنية التي تعود للوقوف، بل بحجم الحقوق التي تُستعاد.
فما تطلبه تحديات ما بعد الحرب، هو تصويب اختلالات القوة، في حين أنّ ما تمثّله أزمة العدالة المكانية في سوريا، من غياب سياسة شاملة تعيد حقوق المكان للسوريين بعد سنوات اللجوء، هو هشاشة واضحة في العدالة الاجتماعية، المتأصّلة أصلاً في سياسات نظام الأسد، والتي تتعزز اليوم في مسارات عودة اللاجئين التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية وتدار بميزانية محدودة سواء في حالات العودة الفردية أو الجماعية.
في مسارات العودة
بين العودة الفردية وجهود المنظمات لتسهيل آليات العودة دون دعم كافٍ أو خطة شاملة، تبرز إشكالية عدم سوية إعادة الإعمار وتتفاقم فجوة العدالة المجتمعية، لتتماشى مع سياسات التهميش التي لطالما كانت سائدة في الساحة السورية. فلا يبقى إلّا الحلول الفردية، كما حالة بشار وأهالي قرية كفرسجنة (ريف معرة النعمان)، الذين عادوا طوعاً من مخيم التريمسة دون دعم ورغم الدمار الشامل لاستعادة أراضيهم الزراعية التي تُعَدّ مصدر رزقهم الأساسي. فمنذ خروج قوات النظام، عملوا على شراء البذور والأسمدة بأنفسهم.
يقول بشار أنّ العائدين اضطرّوا للسكن بجوار منازلهم المدمّرة، واستخدام خيام أو ترميم جزئي، بل وتفجير مبانٍ آيلة للسقوط. كما تعاون الأهالي في تأمين وسائل النقل، فيما جلب بعضهم ألواحاً شمسية من المخيمات لتعويض انعدام الكهرباء وعمدوا إلى صهاريج المياه، واستئجار معدات زراعية من مناطق أخرى. إن الخدمات غائبة تماماً، فلا مدارس أو أفراناً أو مراكز صحية. لكن إصرارهم على إحياء أراضيهم دفعهم للمخاطرة بالعودة.
مع غياب الدعم الحكومي، قدّمت منظمات مساعدات محدودة (كنقطة طبية متنقلة مثلاً) في ريف معرة النعمان، بينما أطلقت مجموعة من المنظمات حملات دعم للعودة، من بينها حملة «العودة الكريمة» التي نظّمتها «بسمة وزيتونة– سوريا»، حيث وضعت خطة استراتيجية عبر 50 لقاءً في مختلف المحافظات السورية، تضمّنت جلسات مركزة في حلب، حمص، دمشق، وريفها، بمشاركة العائدين والمجتمع المضيف والفاعلين. ثم قيّمت أماكن العودة في الداخل السوري، وبعد تحليل النتائج، طورت استراتيجيات العودة، وسهّلت عودة أكثر من 160 عائلة عبر تأمين النقل والمبالغ المالية الأولية، مع توفير خريطة الخدمات في مجتمعاتهم الأصلية. يصرّح حكم البني، المسؤول القطري في المنظمة:
واجهت العملية تحديات مثل غياب الخطة الشاملة، محدودية التمويل، وبُعد مسافات العودة (قد تصل لـ8 ساعات). كما زاد الدمار الكبير من الصعوبات، خاصة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، حيث تضرّرت المدارس والأراضي الزراعية. إنّ عودة اللاجئين تتطلّب تعاونًا شاملًا بين السلطات والمنظمات والمجتمع، مع إشراك السكان في تقييم الاحتياجات وتوزيع الموارد بعدالة. كما يجب تحليل سياق النزاع بدقة لضمان استراتيجية عودة مستدامة، تجنبًا لنتائج عكسية تعيق عملية التعافي.
تشكل الجهود الفردية في آليات عودة أهالي كفرسجنة والعودة المنظمة مع محدودية تمويل المتطلبات الآمنة والكريمة، نموذجًا مصغرًا لإشكالية أعمق، حيث تتحوّل عملية إعادة الإعمار إلى ساحة جديدة لإعادة إنتاج التهميش واللامساواة، بدلًا من أن تكون فرصة لتحقيق العدالة المكانية وإعادة البناء الاجتماعي. ففي غياب الخطة الشاملة والإرادة السياسية التوافقية مع المصلحة المحلية، يقف اللاجئون اليوم في مواجهة نظام إقصائي متجذّر، يعيد إنتاج نفسه حتى في لحظات إعادة البناء.