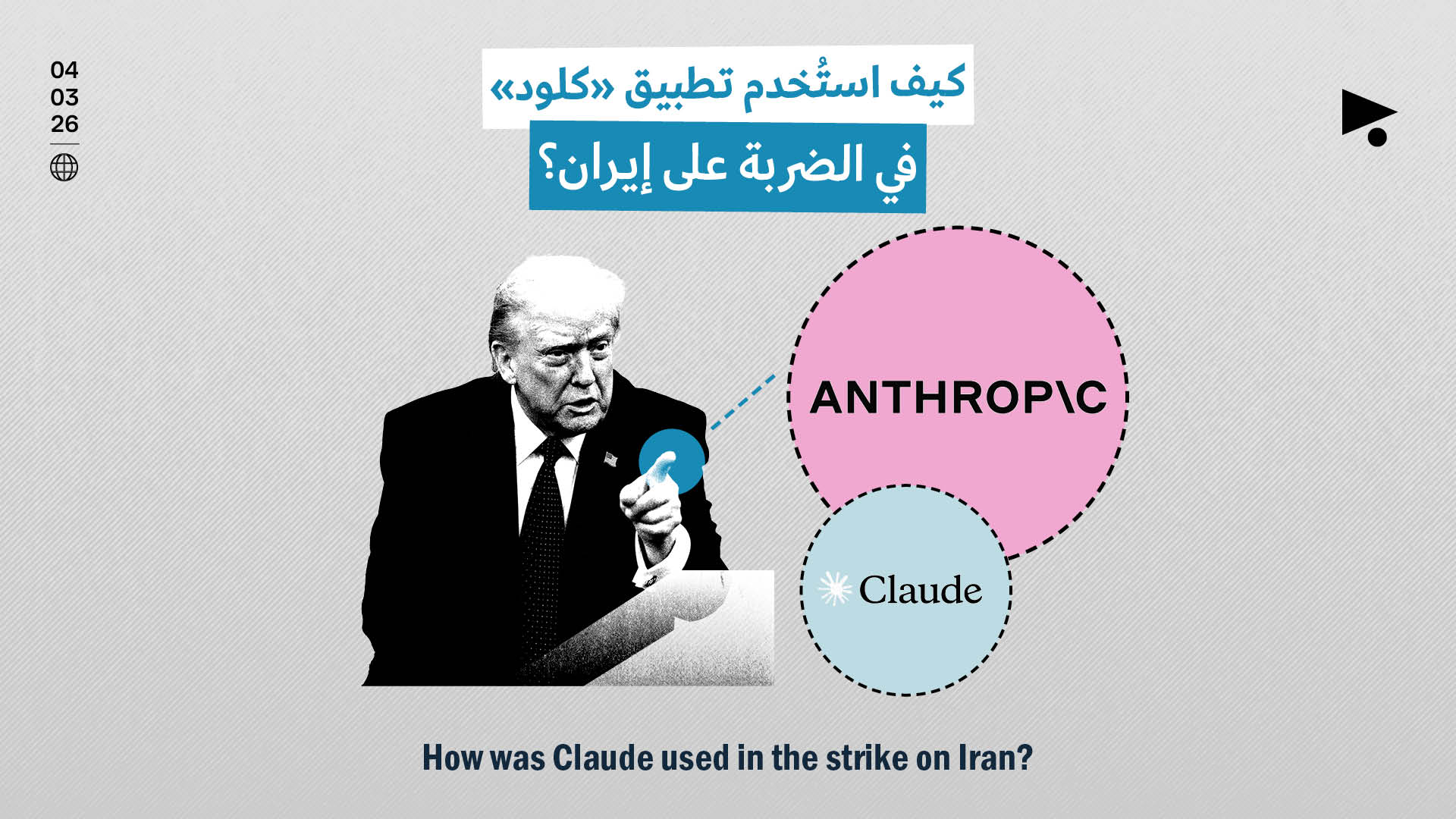ترافقت نشأة الكيان السوري في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ومن ثم ولادة الدولة السورية على أنقاض الدويلات الطائفية التي أنشأها الانتداب الفرنسي، بحضور إشكالية علاقة الدين بالدولة ومكانة الإسلام في دستور ومؤسسات الدولة الوليدة، وقدرة المواطَنة الجديدة على احتضان كل أبناء الطوائف والأقليات الدينية والمذهبية التي ضمها هذا الكيان الوليد. وبقي شعار «الدين لله والوطن للجميع» الذي تبنته مبكراً الثورة السورية الكبرى في العام 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش وعبد الرحمن الشهبندر، بمثابة ناظم أخلاقي ومرجعية سياسية للدولة الناشئة في عهد الاستقلال. إلا أنّ الانقلابات العسكرية والصراعات المحتدمة للوصول إلى السلطة سرعان ما تجاوزته نحو ممارسات وتحالفات تستند إلى ولاءات ما قبل وطنية، سهّلت عملية الاستئثار بالسلطة وإقصاء الخصوم المحتملين عنها.
رغم ذلك، وخلال كل تاريخ الدولة السورية الحديث، لم ينجح أي حزب أو تيار أو زعيم سياسي في ادعاء تمثيل الطائفة السنية وحشدها سياسياً من خلفه. وتوزّعت ولاءات أبناء هذه الطائفة بين العديد من التيارات السياسية والفكرية والمناطقية التي تنازعت الحقل السياسي على امتداد هذه العقود. لا يتوقف فشل محاولات حشد وإعادة تشكيل الطائفة العربية السنية وفقاً لعصبية سياسية واحدة، إلى غياب أي مرجعية دينية او سياسية او مؤسساتية يمكن لها ادعاء تمثيل كهذا. لكنه يعود أيضًا إلى التنوع الديموغرافي والمناطقي والطبقي والهوياتي الذي يتداخل ويتقاطع ضمن هذه الطائفة، ويجعلها على شاكلة تنوع وتعدد سوريا بكافة مكوناتها. من هنا كانت محاولات البعض لحشدها كمجموعة دينية وكتلة صماء، مجيشة وفاعلة سياسياً، أمراً في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً.
ينتشر أبناء الطائفة العربية السنية على كامل الجغرافيا السورية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وتمرّ عبرهم وتتشابك بهم كل خطوط الانتماءات والهويات وطرائق العيش المتواجدة في سوريا، من بدو إلى حضر، ومن ريف إلى مدينة، من دمشق عاصمة البلاد إلى حلب عاصمة الشمال، ومن مدن الداخل إلى مدن الساحل، ومن سهل حوران إلى حوض الفرات، ومن تجار وملاك الأراضي إلى موظفين وعمال مياومين، ومن قوميين وناصريين إلى ليبراليين وإسلاميين، ومن متصوفة وأشاعرة إلى سلفيين وجهاديين، ومن البوطي وأسامة الرفاعي إلى محمد شحرور وجودت سعيد، وقائمة التعداد تطول ولا تنتهي. وإن دلّ هذا على شيء، فعلى صعوبة أن ينطوي كل هذا التنوع في تيار سياسي معيّن وأن يعبّر عنه خطاب مُؤدلَج أو زعيم أوحد.
لقد أظهرت هذه الطائفة غنى التنوع والتعدد السياسي والسوسيولوجي في صفوفها في كل محطة من محطات تاريخ سوريا الحديث، عندما كان تسنح الفرصة لمكونات الشعب السوري أن تعبّر بحرية نسبية عن تطلعاتها السياسية والمطلبية والحزبية، من خلال الحراك المجتمعي الحر او من خلال الانتخابات البرلمانية أو النقابية. ونستطيع أن نغامر ونقول انه حتى في سنوات الانقلابات العسكرية، بما فيها انقلابات البعث، لم يستطع أي فريق سياسي ان يضمها تحت جناحه او ان يدعي حصرية تمثيله لها.
بين الأسد والإخوان المسلمين
وصل الجنرال حافظ الأسد إلى سدّة الحكم بانقلاب عسكري أبيض واصبح أوّل رئيس للجمهورية السورية غير سنّي ينتمي للطائفة العلوية. وترافق ذلك مع انفجار الصراع السياسي ومن ثم العسكري بين النظام الأسدي والطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين خلال حقبة السبعينات من القرن المنصرم. حيث دخل كل من الطرفين بداية في حرب كلامية ومزايدات لفظية حول أحقية تيارات الإسلام السياسي في تمثيل الطائفة السنية وضرورة ان يكون منصب رئيس الجمهورية محصوراً بأبناء هذه الطائفة، وصولاً إلى المطالب الأكثر راديكالية بإقامة الدولة الإسلامية. وفي المقابل، أصرّ حافظ الأسد على مشروعيته كرئيس لكل السوريين وفقاً لدستوره الذي فصّله على مقاسه، متظاهراً في ذات الوقت بتقواه وإيمانه وانتمائه إلى الإسلام المنفتح والعابر للمذاهب. لكنّ هذا الصراع على السلطة سرعان ما تحوّل إلى دوامة من العنف المتبادل والاغتيالات واستباحة المخابرات للناس وقتل للسياسة في المجتمع.
شكّلت جريمة مدرسة المدفعية، التي طالت الطلاب الضباط من الطائفة العلوية في 16 حزيران من العام 1979، نقطة فاصلة في دفع هذا الصراع إلى أبعاده الطائفية الأكثر فجاجة في محاولة يائسة من الطليعة المقاتلة للهروب إلى الأمام على أمل حشد أغلبية الطائفة السنية من حولها. في المقابل، لم يتوانَ النظام الأسدي في دفاعه المستميت عن السلطة ورصّه لصفوف أتباعه، عن ارتكاب واحدة من أبشع المجازر بحق أهالي مدينة حماه في العام 1982 حتى راح ضحيتها عشرات آلاف المدنيين الأبرياء ودُمِّرت أجزاء واسعة من المدينة.
ما بعد حماة لم يكن كما قبلها، حيث تحولت سورية إلى مملكة للصمت ولعبادة الفرد، وباتت حدود الطوائف تُصنع بالمجازر والقتل، بدلاً من ان تُصنع المواطنة بالسياسة والحوار. لكن مع ذلك نستطيع أن نقول: أن لا مجزرة حماة ولا جريمة إعدام الطلاب في كلية المدفعية ولا ممارسات نظام الأسد الطائفية ولا ديكتاتوريته الدموية، نجحت في دفع الصراع السياسي إلى الاقتصار على أبعاده الطائفية المحضة، ولا إلى انطواء الطائفة السنية بتنوعها تحت جناح تيارات الإسلام السياسي، وبقي الحقل السياسي، حتى في سنوات الأسد الأكثر ظلامية، مفتوحاً على تعدّد الخطابات السياسية والتيارات المجتمعية.

الشعب السوري واحد؟
توريث السلطة في مملكة الأسد وإجهاض محاولة ربيع دمشق للإصلاح السياسي والإمعان في الاستبداد والفساد، كلها ممارسات مهّدت لاندلاع الثورة السورية في العام 2011، والتي حاول ناشطوها منذ اليوم الأول إبقاءها سلميّةً وعابرةً للمذاهب والطوائف. لكنّ نظام بشار الأسد اختار الحل الأمني والتجييش الطائفي وإطلاق الجهاديين من السجون وصولاً إلى المشاريع الإبادية التي نتج عنها مجازر الكيميائي والبراميل المتفجرة وتدمير مئات المدن والقرى وتهجير ملايين البشر.
شعار «واحد واحد واحد الشعب السوري واحد» الذي انطلق ذات يوم من العام 2011 من حناجر المصلّين في مسجد الرفاعي في دمشق وانتشر بعدها في معظم المظاهرات التي شهدتها أنحاء سورية، لم يكن فقط شعاراً رغبوياً رومانسياً يتوافق مع مبادئ الثورة في طورها السلمي. كان أداة فعل سياسي تحاول فيه الجموع في المظاهرات، العارية في مواجهة آلة القتل الأسدية، أن تذكّر خصمها كما نفسها، بهذا الممكن الوطني لبناء الجماعة السياسية وفقاً لمبدأ المواطنة، بدلاً من بناء الطوائف المسيّسة بالقتل والكراهية وإلغاء الآخر.

طبعاً مضى النظام الأسدي بعيداً في خيار الإبادة والحرب على شعبه والاستعانة بالقوى الخارجية. وعلى شاكلته جاءت الخيارات الجهادية الإسلامية التي أصبحت بدورها مرتعاً للعنف المتوحّش وللتدخلات الخارجية والسيناريوهات العدمية، مروراً بتجربة إدلب والمناطق المحررة في الشمال، التي استثمر فيها ومعها الجار التركي، وصولاً إلى إسقاط النظام الأسدي في 8 كانون الأول 2024 على يد هيئة تحرير الشام وحلفائها في غرفة العمليات المشتركة وإعلان انتصار الثورة السورية وتعيين أحمد الشرع رئيساً للجمهورية وتسطير إعلان دستوري معلَّب وبدء مرحلة انتقالية مدّتها خمس سنوات.
الأمويّة الجديدة كجماعة متخيَّلة
شكّل تهاوي النظام الأسدي خلال أيام معدودة، وبأقلّ الخسائر البشرية والمادية الممكنة، وتخلي حلفائه الإقليميين عنه، فرصة تاريخية نادرة لبدء عملية انتقال سياسي حقيقية تسمح ببناء دولة المواطنة والقانون من خلال المشاركة السياسية لكل الأطراف، وبإفراز قيادات مجتمعية جديدة، وبإعادة البناء والإعمار، وبمسار واضح للعدالة الانتقالية يحاسب مجرمي الحرب ومرتكبي المجازر ويمكّن المجتمع السوري من تضميد جراحه والتطلّع بثقة إلى المستقبل.
لكن للأسف، وفي ظل نشوة الانتصار، دخلت سورية من جديد في نفق مظلم من الاستئثار بالسلطة، وفُرض إعلان دستوري معلَّب، وغابت المشاركة السياسية، وحلت العديد من مؤسسات الدولة بحجة انتزاع البعث منها، وأعيد توزيع المناصب الحساسة والغنائم على الدوائر الحزبية والجهادية المرتبطة بهيئة تحرير الشام. تمّ كل ذلك في ظل ادعاء احتكار تمثيل الأغلبية السنية وتقليب مكونات الشعب السوري بعضها ضد بعض، والاستئثار بالقرار ومركزته في يد من يراد له، وينظر اليه، على أنه القائد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كأننا في سيناريو معاد ومكرّر لمشروع عبادة الفرد والقائد الملهم الذي عانى منه السوريون لعقود طويلة وأدّى بهم إلى كوارث نعيش إلى اليوم عواقبها الوخيمة.
لقد قام النظام الأسدي في الماضي، ضمن منهجه في الاستئثار بالسلطة وحصرها في يد القائد الفرد، ومن خلفه بطانته الفاسدة، بمحاولة حثيثة لوأد السياسة في المجتمع عموماً، وضمن الطائفة السنّية خصوصاً، وحرص على تغييب التنوّع وتعدّد الأصوات السياسية داخلها، وعمد إلى اختصارها برموز دينية ومجتمعية مدجَّنة من أمثال الشيخين، البوطي وكفتارو، وشهبندر التجار بدر الدين الشلاح، ليختصر في النهاية سوريا كلها، بقضّها وقضيضها، بشخصه الفرد، حتى وجدت تعبيرها الأمثل بمقولة «سوريا الأسد».
واليوم، وإن كنّا لا نزال بعيدين عن تأليه وتعظيم الرئيس الشرع كقائد فرد، فهناك محاولات حثيثة تجري على قدم وساق لحصر أغلب السلطات في يديه، ولمصادرة الطائفة السنية، بتنوّعها وتعددها، لاختصار تمثيلها السياسي في النظام القائم، وفي ما بات يسمّى بـ«الأمويين الجدد».لا بل الطامة الكبرى، أن الجيش الناشئ، والذي ضم العديد من الفصائل الإسلامية التي حافظت على عقيدتها السلفية الجهادية، صار هو الآخر «جيش السنّة» وجيش «الأمويين الجدد»، بدلاً من أن يكون جيشاً لكل الوطن. لا بل ارتُكبت المجازر والانتهاكات من قبل بعض فصائله، تحت عنوان هذه التسميات الفضفاضة.
إلّا الديمقراطية!
منذ ولادة الدولة السورية الحديثة، هناك- لأسباب مفهومة ومعلومة- غياب شبه تام لإحصائيات دقيقة عن التوزع السكاني وأرقام ونسب توزع أبناء المذاهب والطوائف في سوريا الحديثة. فكيف هو الحال في سوريا اليوم حيث نال القتل والتهجير والهجرة من ملايين السوريين في السنوات الخمس عشرة الماضية. مع ذلك، فإنّ نظرة تقريبيّة للبنية الديموغرافية السورية، بالاستناد إلى أرقام فترة الانتداب الفرنسي ولبعض الأبحاث الأكاديمية الحديثة حول الموضوع، تُمكّننا من القول بشكل تقريبيّ إنّ العرب السنّة، على تنوّعهم وتعدّدهم، يشكّلون في أحسن الأحوال نسبة 70 بالمئة من تعداد الشعب السوري، أما الـ30 بالمئة الباقية، فتتشكل من الأكراد والعلويين والدروز والإسماعيليين والمسيحيين.
هذه الأرقام لوحدها يمكن أن تدلّنا لماذا يخاف العديد من أهل السلطة من كلماتٍ مثل الانتخابات والديمقراطية والمشروعية الشعبية، ليس فقط لأنّ أغلب أبناء الطوائف غير السنّية من المستحيل أن تصوّت في أيّ انتخابات ديموقراطية إلى تيار أو فصيل ينتسب إلى الأيديولوجية السلفية الجهادية التي اعتادت في الماضي على معاملتهم كأهل ذمّة، بل أيضاً، والأهمّ، لأن العديد من الممسكين بالسلطة اليوم، يعلمون علم اليقين أن قبولهم بأي عملية انتخابية حرة، وبالاحتكام للإرادة الشعبية، لن يضمن لها كسب الأصوات الكافية داخل الطائفة السنّية، لكي تكون لهم من بعدها الأغلبية والغلبة على مستوى الشعب السوري بأكمله.

صحيح أن تيار الصحوة الإسلامية والفكر السلفي الجهادي قد انتشر في السنوات الماضية بكثرة في بعض أوساط الطائفة السنّية، لا سيما تلك التي نال منها التهجير والمجازر والقتل على يد النظام السابق، لكن هذا لا يعني بتاتاً أنّ لهذه التيارات الغلبة اليوم داخل الطائفة السنّية. يكفي، في هذا السياق، أن نفكر ونسأل أنفسنا افتراضياً ماذا لم تقدّمت اليوم شخصية لها ثقلها السياسي والرمزي من مثل رجل الأعمال أيمن أصفري لمنافسة الرئيس أحمد الشرع في أي انتخابات رئاسية قادمة، هل ستكون نتيجة الانتخابات مضمونة للرئيس الشرع، وهل سيستطيع الشرع أن ينال أغلبية أصوات السنّة ليضمن أغلبية أصوات السوريين؟ أشكّ بذلك.
المشاركة السياسيّة كمدخل للخلاص
منذ مؤتمر النصر في 15 كانون الثاني 2025 الذي عيّنت فيه الفصائل المنتصرة قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع رئيساً للبلاد، ومروراً بمؤتمر الحوار الوطني في 25 شباط، ووصولاً إلى الإعلان الدستوري المؤقت في 13 آذار، والذي أقرّ مرحلة انتقالية مدّتها خمس سنوات، تمّت صياغة نظام هجين للحكم، بعيد كل البعد عن المشاركة السياسية وعن مراعاة خصوصيات الاجتماع السوري. نظام فردي رئاسي، يغيب عنه فصل السلطات وتتمركز فيه باسم المشروعية الثورية معظم السلطات في يد رئيس للجمهورية لم يُنتخَب، بل عُيِّن تعييناً من قبل قادة فصائل عسكرية نجحت في إسقاط نظام الأسد ودخول دمشق كفاتحة ومحرِّرة من نير الاستبداد.
لقد أعطى الإعلان الدستوري للرئيس الشرع صلاحيات استثنائية توازي تلك التي كان يتمتع بها كل من بشار وحافظ الأسد، لجهة كونه القائد العام للجيش والقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي ويترأس مجلس الوزراء ويصدر المراسيم، ومن حقه تعيين الوزراء وثلث أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وإعلان حالة الطوارئ، وغير ذلك كثير. وفي كل هذا المسار، وبحجة ضرورات الفترة الانتقالية ووجود ملايين السوريين المهجرين داخل وخارج سورية، وعدم بسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها، تمّ تجاهل عناوين ومحطات مفصلية في أي عملية سياسية، من مثل الانتخابات والمشروعية الشعبية ومبدأ سيادة القانون وصندوق الاقتراع وحرية النقابات والديموقراطية وتداول السلطة وحرية تشكيل الأحزاب. لماذا وكيف انتقلنا من سنة أو سنتين كمدة للمرحلة الانتقالية إلى خمس سنوات؟ ومَن قال إنّ المراحل الانتقالية تتطلب قائداً فرداً ولا تشهد تقاسماً للسلطة ولا انتخابات نقابية وبلدية، حتى لا نقول نيابية.
لا، لم نتعلم شيئاً من تجارب شعوب أوروبا الغربية في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولا من تجارب الانتقال الديمقراطي لدول أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية. جمّدنا كل عملية انتخابية، وأقصينا كل شخصية لها ثقلها الرمزي وقيمتها الاعتبارية في مجتمعنا، ورفضنا أي تقاسم للسلطة، وقررنا بمشورة مجموعة من الجهلة والوصوليّين وحملة شهادات الدكتوراه المزوّرة والفارغة أن نصدر بيانات تأسيسية باسم المشروعية الثورية ونشكل لجاناً ونكتب إعلاناً دستورياً معلَّباً ونعيد إنتاج نظام للحكم لا يشبه شيئاً في بنيته أكثر من نظام الأسد نفسه.
اليوم، حيث باتت للأسف حدود الطوائف تُصنَع بالدم والمجازر والتدخلات الخارجية، بدلاً من أن تُصنَع حدود المواطنة والانتماء للوطن بالانتخابات والتوافقات السياسية والمؤسسات الشرعية، فإن لا سبيل لخلاص سوريا من دون إعادة النظر بالإعلان الدستوري وما انبثق عنه من أُطُر وتشريعات، باتجاه حوار وطني حقيقي تحت سقف دستور العام 1950، يضمّ كل الأطراف الفاعلة سياسياً واجتماعياً، وينتج عنه مسار انتقال سياسي حقيقي نحو انتخابات لمجلس تأسيسي تجري خلال سنة أو سنتين، وينبثق عنه دستور دائم ويُنتخب من قبله رئيس شرعي جديد للبلاد.