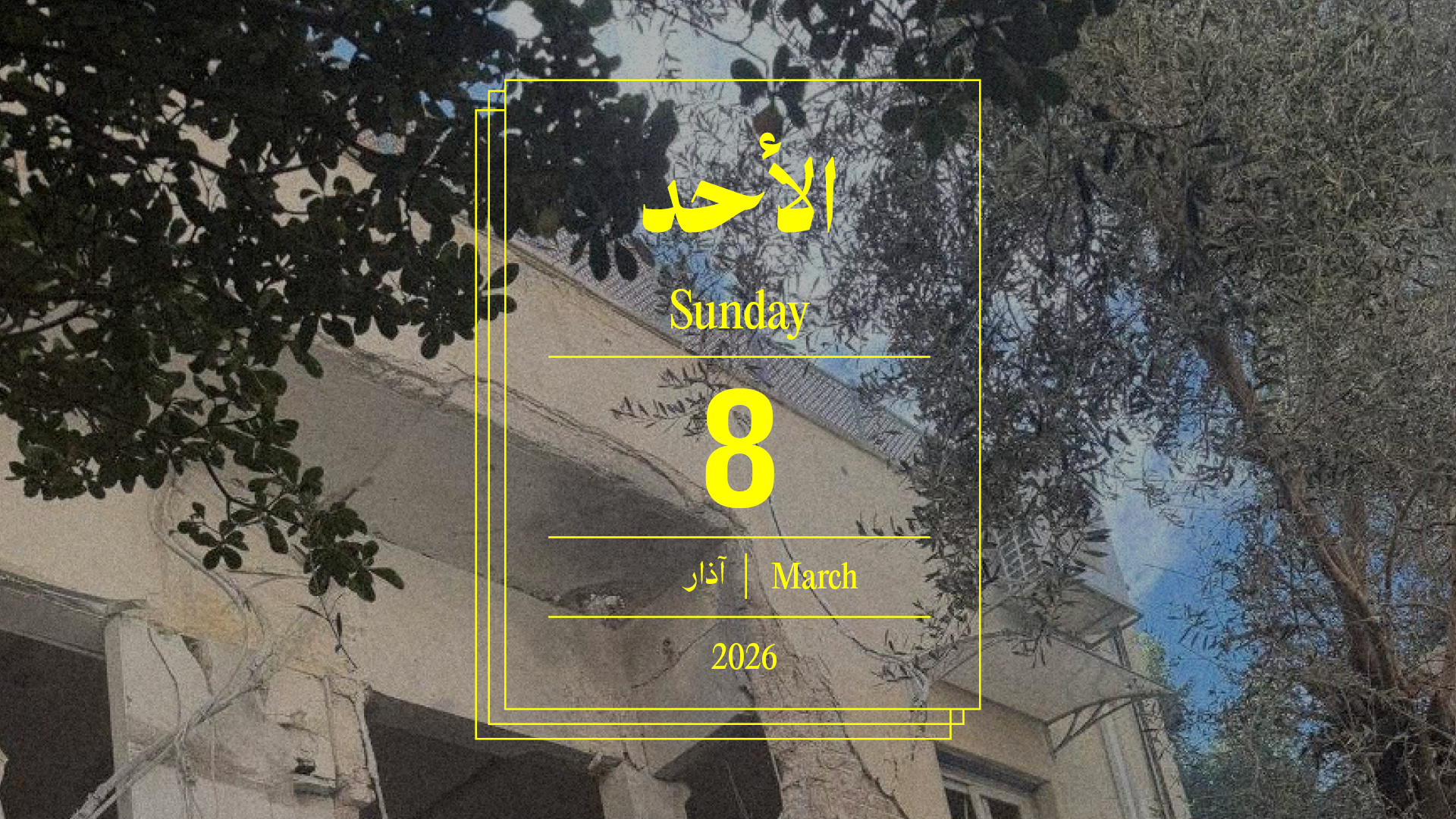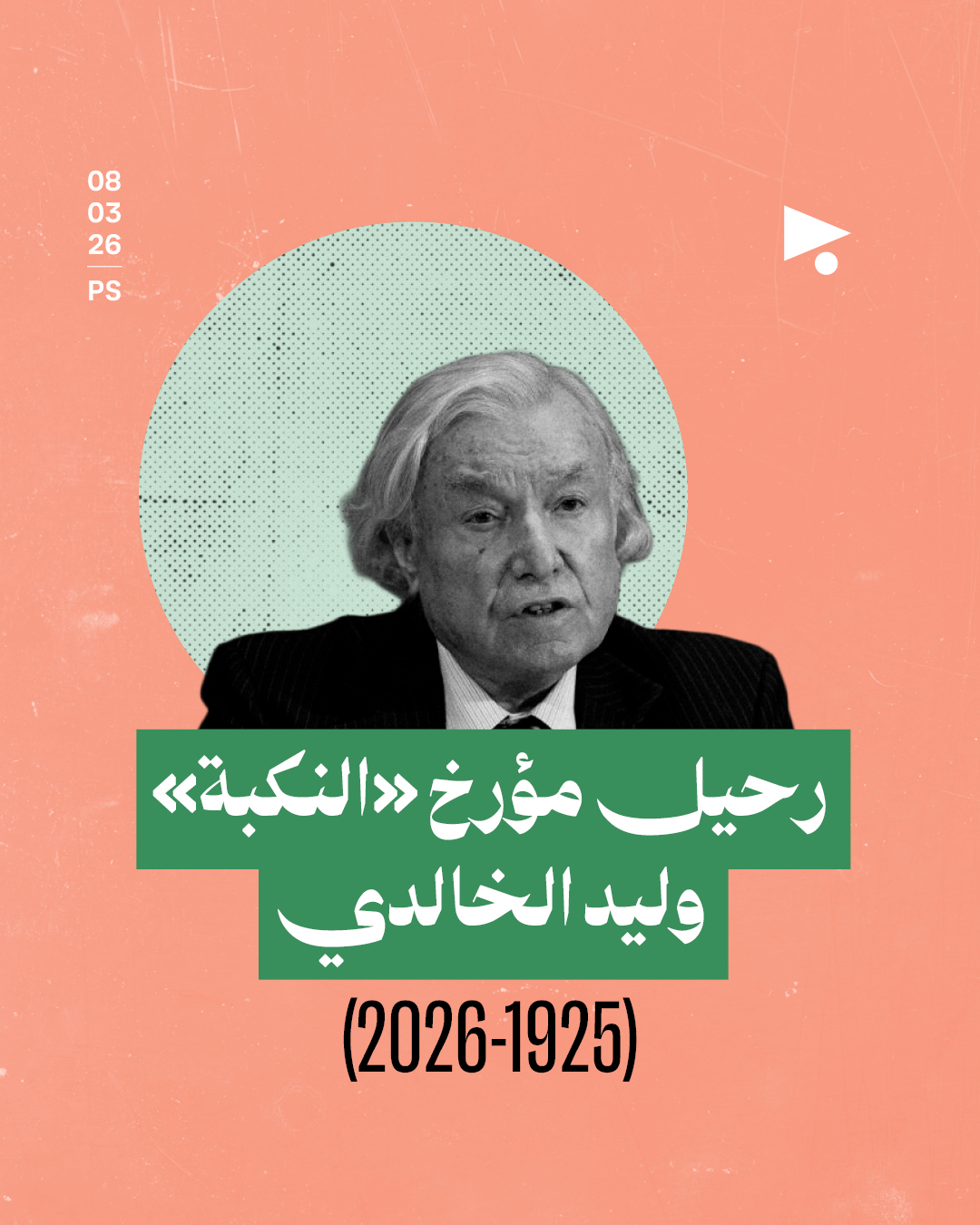في منتصف آب الفائت، أعلن وزير التربية والتعليم الجديد في مصر محمد عبد اللطيف. عن إعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي في مصر. أبرز ما أسفرت عنه تلك الهيكلة الجديدة، والتي أثارت الكثير من الجدل، هو إلغاء مادة اللغة الأجنبية الثانية كمادة تضاف إلى المجموع، كما تمّ إلغاء مادة الفلسفة والجيولوجيا بشكل كامل. لم تكن تلك الضجة فريدة من نوعها في عهد الرئيس السيسي في ما يخص التعليم. فسبق أن تسبّب تعيين الوزير بحدّ ذاته بسجال حول عدم امتلاكه دكتوراه كما يدعي وتدعي الحكومة، ما أجبر الحكومة بأن تغير لقبه من دكتور إلى سيد.
خلال عشر سنوات من حكم السيسي، يُفتح ملف التعليم في مصر بشكل سنوي ليثير الكثير من المناقشات والاستدعاءات التاريخية لمعنى التعليم في مصر، والمعركة بين الحق الدستوري في المجانية وبين ما تثيره مجانية التعليم من إضرار بجودته. يبدو جليًا أن الحكومة تختار الوقوف في صف إلغاء المجانية، لكنّها لم تجرؤ حتى الآن على الإقدام على تلك الخطوة. فالناظر في خطاب السيسي عن التعليم يمكنه أن يستشف رؤية رجعية لدور التعليم في المجتمع المصري الحديث وحالة الحنين إلى هذا الزمن الذي لم تكن تتكفّل فيه الدولة بتعليم المواطنين إلا على قدر حاجتها لهم في مؤسساتها، ولم تكن تُعلّمهم سوى المواد الأساسية التي تساعدهم في حياتهم المهنية. لذلك تبدو مواد كالجغرافيا والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية أجدر بالحذف كما حدث في التعديل الهيكلي الأخير. ومن أجل النفاذ بوضوح إلى كنه مشروع السيسي في التعليم، علينا أن نعود إلى الماضي لنتتبّع مسيرة ذلك الحق في التعليم الذي اكتسبه المواطن، وبات مُهددًا بالزوال كغيره من الحقوق الأخرى تحت سلطة النظام الحالي.
من أجل الجيش والمصنع
كان التعليم في مصر حتى بدايات القرن التاسع عشر يتركز بالأساس في التعليم الأزهري، وكان ذلك تعليمًا غير مؤسسيّ وغير منظّم. ومع عهد محمد علي (1805-1845) الذي يُنسب كثيرًا إليه لقب «باني مصر الحديثة»، بدأ التعليم النظامي في مصر. يذكر المؤرخ خالد فهمي، في كتابه «محمد علي: من والي عثماني إلى حاكم مصر»، أن الاهتمام بالتعليم في سياسة محمد علي توسّع بدءًا من العام 1830 لخدمة احتياجات الجيش. فكانت المدارس العسكرية هي المدارس الأولى التي اهتم محمد علي ببنائها، قبل أن يتوسع في المدارس الحرفية وسياسات التعليم المهني التي تهدف إلى تخريج فنيين يمكنهم العمل في مجالات الهندسة والطب والمصانع التي كان محمد علي يتوسع بإنشائها.
اعتمد محمد علي على «نخبوية» التعليم الذي ينتج مجموعة من الصناع والمهرة والموظفين الإداريين القادرين على إدارة دولة وترسيخ بيروقراطيّتها. وكان إلى جانب إنشاء المدارس في مصر، مسار آخر يقوم على إرسال الطلبة في بعثات تعليمية إلى الخارج، خاصة إلى فرنسا. وكان حد أشهر المبعوثين الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي الذي أرسى أدبيّات التعليم الحديث النظامي في مصر فيما بعد. ويؤكد جابريل بير في كتابه «دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة» أن الباشا حذر كثيرًا ابنه وخليفته إبراهيم من انتشار التعليم بأكثر مما يحتاج إليه الجهاز البيروقراطي للدولة.
أنتجت هذه السياسة ارتفاعًا بنسب التعليم. ففي عهد الباشا، كما يذكر جاكوب سكوفجارد-بيترسون في كتابه «إسلام الدولة المصرية»، تلقّى التعليم 5% من الأطفال بين عمر السادسة والثانية عشرة فقط. وارتفعت تلك النسبة إلى 17.5% عام 1875، ثم 25% عام 1914. لن تعرف مصر مثل هذه الزيادة ثانيةً إلّا في النصف الثاني من القرن العشرين، أي مع صعود مصر الناصرية وسياسات التحديث الاشتراكية التي ستوفر مجانية التعليم.
وفي أعقاب إسقاط مشروع محمد علي بعد توقيع «معاهدة لندن 1840»، وتخفيض مصر عدد قوات جيشها من 150 ألفًا إلى 18 ألفًا، تراجعت سياسات التعليم والتوسع فيها حتى وصلت إلى الانهيار التام في عهد خليفته عباس حلمي الأول الذي عُرف بالعهد الظلامي.
لكن في عهد الخديوي إسماعيل (1863-1879)، ستعود سياسات التوسع في التعليم، بل وإنشاء أول مدرسة لتعليم البنات في مصر، مدرسة السنية، واستئناف البعثات إلى الخارج. وستعرف مصر الإرساليات التعليمية التي ستزيد من عدد المدارس الأوروبية في مصر. كذلك أسّس الخديوي «وزارة المعارف» لتنظيم التعليم في مصر. ولكن كان هناك انحدار في التعليم في عهده مقارنةً بعهد محمد علي، وقد تجلى ذلك في انخفاض عدد المؤسسات التعليمية نتيجةً للضغوط المالية الوطنية، حيث تمّ ضمّ العديد من المدارس الثانوية معًا، وأُغلق بعضها وانخفض عدد الطلاب في النظام. فكانت سياسات الإصلاح في عهد الخديوي إسماعيل مرهونة بكثرة الاستدانة التي تسببت في النهاية بسقوط مصر تحت الاحتلال البريطاني في عهد ابنه توفيق عام 1882.
أداة للتنافس الاستعماري وإدارة شؤون الاحتلال
بعد مرحلة محمد علي، تحوّل مشروع التعليم في مصر إلى عمود الخيمة في مشروع المُستمعر البريطاني. يتحدث تيموثي ميتشيل في كتابه «استعمار مصر» قائلًا:
جرى مد مبادئ النظام نفسها لتشمل كامل مسطح المجتمع في إعادة بناء القاهرة والمدن المصرية الأخرى لخلق منظومة من الطرق المنظمة المفتوحة والإشراف على الأحوال الصحية والصحة العامة والتحكم في العمال ومراقبة المجرمين والفقراء، وبالدرجة الأولى في إدخال نظام حديث للتعليم المدرسي الانضباطي. والواقع أن التعليم المدرسي يبدو أنه قد أتاح وسيلة لاستخدام المناهج الجديدة للنظام والانضباط لصياغة كل مصري فرد بحيث يكون رعية سياسية طائعة وطيّعة. ونتيجة لذلك فإن التعليم المنظّم صار يُنظر إليه بوصفه العنصر المحوري لسياسة الدولة الحديثة، وهي سياسة لا تستند إلى مجرّد الاستخدام المتقطع للقسر، بل إلى عملية تلقين وانضباط وتفتيش متصلة.
نقرأ مقولة تيموثي ميتشيل بتوسع وجلاء في كتاب جرجس سلامة «أثر الاحتلال البريطاني في التعليم القومي في مصر 1882-1922» حيث يبيّن سلامة أنّه في عهد كرومر، تمثّل أحد أهداف السياسة البريطانية التعليمية بالسيطرة على النفوذ الثقافي الفرنسي في الحياة الثقافية والتعليمية المصرية، هذا النفوذ الذي ورثته مصر منذ أيام اعتماد «محمد علي» على الفرنسيين في تحقيق نهضته العلمية. فحتى وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، لم يكن بمصر سوى مدرستيْن انجليزيتين، سيُصبحان عشية الاحتلال 20 مدرسة. لكنّ النفوذ الثقافي الفرنسي لم يتوقف. فعند عام 1928، بلغ عدد المدارس الفرنسية 179 مدرسة. استطاعت بريطانيا، من خلال مستشارها دانلوب، أن تقوم بتضييق الخناق على الثقافة الفرنسية في التعليم المصري من خلال فرض اللغة الإنكليزية كلغة رسمية للتعليم وزيادة الأقسام الإنجليزية في المدارس في مقابل الفرنسية، حتى أصبح هناك في عام 1901، 1175 تلميذًا في الأقسام الإنجليزية في المدارس المصرية مقابل 756 تلميذًا في الأقسام الفرنسية.
في عهد اللورد كرومر، توقفت بريطانيا عن التوسّع في رفع مستوى التعليم وعدد المدارس الثانوية والتعليم العالي، لاعتقادها أن التعليم سيولّد مجموعة من المثقفين غير السعداء بالاحتلال، ما سيُنتج ديماغوجيين تخريبييّن. فمانعَ اللورد كرومر كثيرًا إنشاء جامعة مصرية. وكان يعتبر التعليم وسيلة لتحقيق أهداف مختلفة، مثل تدريب الموظفين العموميين وضمان الخدمات المدنية الفعالة وتدريب الشباب المسجلين في المدارس على العمل في الخدمات الحكومية. لذلك كان التعليم البريطاني هادفًا لخلق طبقة من الموظفين لدى الحكومة الاستعمارية كاستنساخ لتجربة الهند التي طبّقها اللورد ماكولاي.
التعليم في العقد الاجتماعي الجمهوري
في فترة الاستقلال الشكليّ الذي نالته مصر عن الاحتلال البريطاني (1922-1952)، كان التعليم ومجانيّته واحدًا من أهم النصوص التي تأسّس عليها دستور الاستقلال عام 1923. لكن رغم ذلك، لم تخطُ مصر على مدار تلك السنوات الثلاثين سوى خطوات بطيئة جدًا في إصلاح السياسات التعليمية. فانتظرت مصر حتى منتصف الأربعينيات، كي تبدأ بالسعي إلى تعميم مجانية التعليم، لكن دون التوسّع في بناء المدارس. وفي عام 1951، استطاع طه حسين حين كان وزيرًا للمعارف أن يفرض مجانية التعليم الثانوي والفني. لكن هذا لم يكن كافيًا. ففي عام 1952 الذي شهد ثورة الضباط الأحرار، بلغت نسبة الأمّية في المجتمع 75%.
أطلق جمال عبد الناصر (1954-1970) ثورة اجتماعية شاملة تخطت آثارها عهده. ثمثّلَ أحد مظاهر تلك الثورة في التعليم. فبينما كان هناك استهداف لتعميم مجانية التعليم قبل الثورة، فإنّ نظام عبد الناصر هو من توسّع في بناء المدارس والجامعات وتحديث المناهج وحتى إدخال التعليم النظامي داخل مؤسسة الأزهر التقليدية وإنشاء جامعة للأزهر وسّعت تعليمها إلى العلوم الإنسانية والبيولوجية.
كذلك حظي الشباب المتعلّم بمكانة خاصة في النظام. فكانت تُخفَّض لهم تذاكر الأوتوبيسات والسينما والمعارض الثقافية، كما كان يتمّ تأجيل الخدمة العسكرية حتى الانتهاء من التعليم الجامعي، وكان المتعلّمون يحصلون على تخفيض سنوات الخدمة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة. وطالت سياسات عبد الناصر التوسّعية التعليم العالي والجامعات، والتي وصل عددها إلى 12 جامعة حكومية بنهاية عام 1976 يتعلم فيها ما يقارب 480 ألف طالب. ظلت نسبة الإنفاق على التعليم من الميزانية العامة تتزايد سنةً بعد أخرى، إلى أن جاءت هزيمة حزيران/يونيو 1967. لكنّ السياسات الناصرية في التعليم ظلت ساريةً حتى 1991 في عهد الرئيس حسني مبارك، وهو العام الذي تدخل فيه صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري لمساعدته على سداد الديون، أي بمعنى أخرى، التوسع في النيوليبرالية المشوّهة التي كانت قد بدأت في منتصف عهد السادات.
كان التعليم جزءًا من العقد الاجتماعي لمرحلة الجمهورية التي تأسست على حكم المصريين لأنفسهم، وحقهم جميعًا في الارتقاء، بعد أن تمّ القضاء على مجتمع النصف في المائة كما سماه عبد الناصر في خطاباته العديدة. اعتبر التعليم وسيلةً للترقي الاجتماعي حيث يضمن المتعلم بشكل مجاني، التعيين في وظيفة حكومية تؤمن له الحياة من خلال الراتب والتأمين الصحي والإسكان الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة وراتب المعاش التقاعدي بعد سن الستين.
لكنّ لذلك العقد الاجتماعي كلفته. فمنذ البداية، كان بديلًا للمصريين عن الحقوق السياسية التي احتكرتها الدولة ونظامها الحاكم، كما ظلّ يكلف الخزينة ويُنهكها سنة بعد أخرى، وينهك جودة التعليم بحد ذاتها. وبعد التراجع في دور الدولة وفي سياسات التصنيع في عهد الرئيس السادات، أي عصر «الانفتاح»، أصبح هناك الكثير من الخرّيجين المتعلّمين سعياً وراء وظائف حكومية آخذة بالتقلُّص بحكم أن الدولة قد بدأت في الخروج من العديد من المجالات التي كانت تقوم بها في عهد الأحلام الناصرية الاشتراكية.
تفاقمت الأزمة في مصر بدءًا من العام 1991. فالنهضة في المجال الصحي أنتجت طفرة المواليد، بمعدل نموّ سنوي وصل إلى 2.8% عام 1991. وزاد عدد المصريين من 1952 إلى 1991، من 22 مليونًا إلى 60 مليونًا. ومقابل ذلك، تراجعت، سنة بعد أخرى، مخصصات الميزانية للإنفاق على التعليم، وغرقت البلاد في أزمة الدين التي بدأت منذ عهد السادات وبلغت ذروتها عام 1986 حين بلغت نسبة الديون 150% من الميزانية العامة، كما يذكر جلال أمين في كتابه «قصة الاقتصاد المصري». أصبحت مصر تُعاني في التعليم من أزمة «مالتوسية» كلاسيكية، حيث فاق عدد الطلاب طاقة عدد المدارس ومخصصات التعليم المجاني، ما أدّى إلى انحدار جودة التعليم، وفتح المجال للمدارس الخاصة عام 1991 لتنافس التعليم الحكومي، ولتبدأ المنافسة غير العادلة.
تمثّلت تلك المنافسة غير العادلة في وجود التعليم الخاص ذي الجودة المرتفعة والكلفة المرتفعة الذي يُرحّب القطاع الخاص بخرّيجيه، حيث يُعَدّ خريج التعليم الخاص مؤهّلًا بشكل أكبر من خلال امتلاكه العديد من المهارات، ومن أهمها اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية عمومًا. في غضون سنوات قليلة، تأسس «بيزنس التعليم الخاص» مع مدارسه وجامعاته، والتي يمتلكها رجال أعمال هم على صلة بمؤسسات الدولة، أو جزء من كيانها أساسًا. على سبيل المثال، بين عامي 1996 و2006، ارتفع عدد الجامعات الخاصة من جامعة واحدة إلى 16، وفي عام 2023 وصل عدد تلك الجامعات إلى 32 في مقابل 28 جامعة حكومية.
الثورة الجديدة التي لم تحلم بتعليم جديد
ينصّ الدستور المصري على تخصيص مقدار 6% من الميزانية العامة السنوية للدولة من أجل الإنفاق على التعليم والتعليم العالي وتعزيز مجانيّته، وأن تتزايد تلك النسبة على أساس سنوي وفقًا لتزايد الدخل القومي. لم تحقق تلك النسب أي ارتفاع منذ التسعينيات إلا في فترة نادرة هي عام 2005، وظلت آخذة في التراجع وفقًا لبيانات البنك الدولي. ظلت تلك الحالة حتى قيام ثورة يناير 2011، وازدادت سوءًا بعدها، حيث لا تتخطى نسبة الإنفاق على التعليم، في ميزانية العام الحالي، الـ2% من الأساس. وكنسبة للإنفاق على التعليم من الدخل المحلي، فإن مصر لم تبلغ منذ عام 1982 متوسّط إنفاق الدول النامية على التعليم، والذي يبلغ 6%.
اللافت للنظر أنه لم تكن هناك أية زيادة في ميزانية عام الثورة 2011-2012 في مجال التعليم، ولم يحز التعليم قدرًا كبيرًا من المناقشة في برامج المرشّحين في انتخابات الرئاسة الديمقراطية الوحيدة في تاريخ مصر عام 2012. بل أن حكومة تسيير الأعمال عقب ثورة يناير خفضت من مخصصات التعليم بدعوى عدم اللجوء للاستدانة من الخارج. في المقابل، اهتمّت الدولة آنذاك بإضرابات المعلمين وزيادة الأجور والتثبيت في الوظائف والتعيين للمعلمين الجدد. كان ذلك الجو يعكس حالة من اللامبالاة بالحالة التعليمية ولا جدواها في مصر، حيث أن المصريين آمنوا بأن التعليم الحكومي المجاني لا طائل وراءه من دون الدروس الخصوصية التي تُعدّ تعليمًا خاصًا. ورغم تلك الحالة المزرية بالفعل، كان للسيسي مشاريع أخرى للتعليم حين تسلم السلطة عام 2014.
كان واضحًا منذ البداية أن التعليم ليس على رأس أولويات مشروع الرئيس. فطيلة العشر سنوات الماضية، كانت نسبة الإنفاق على التعليم هي الأقل في تاريخ مصر مقارنة بالناتج المحلي، باستثناء عام 2015 حين بلغت النسبة 4%. في أحد مؤتمراته عام 2016، ألقى الرئيس السيسي كلمةً كان لها دويّ شديد أثار الجدل. قال السيسي ينفع التعليم في إيه مع وطن ضايع؟. اجتُزِئت تلك الجملة من حديث السيسي وكأنه كان يقصدها بشكل حرفي. لكنّ أهمية ما قاله تكمن في الكلمات التي سبقت هذه الجملة حين تحدث السيسي عن بلدان لم تكن فيها أي نسب من نسب الأمية، ولكنها لم تُنتج مواطنًا يحمي بلاده من الفوضى اللي بنشوفها. كان يقصد هنا ثورات الربيع العربي، وأكمل السيسي كلماته بعد التصفيق الحارّ بأن التعليم إذا لم يُنتج مواطنًا يحمي بلاده من الفوضى، يصبح فشل التعليم.
عُقد هذا المؤتمر قبل شهور بسيطة من إعادة هيكلة الوزير السابق طارق شوقي لنظام التعليم في مصر الذي بدأ منذ العام 2017 بتطبيق نظام عُرف بنظام «البوكليت»، الذي جاء في الأساس للقضاء على فضائح تسريب الامتحانات من المخترق الذي عُرف باسم «شاومينج» في العاميْن السابقيْن. كان السيسي قد عيّن الوزير طارق شوقي لإحداث ثورة في التعليم عام 2017. لكن كل ما أحدثه كان عبارةً عن ضجيج بلا طحين، من تغيير لنظام الامتحان إلى الحديث عن التعلم المدمج والتقني من خلال التابلت بديلًا عن الكتب. فعلى سبيل المثال، فشلت صفقة التابلت فشلًا ذريعًا في النهاية، واتّضح أنه لم يستفد منها سوى صهر الرئيس السيسي الذي كان مورِّدًا للتابلت للوزارة بالشراكة مع القوات المسلحة.
لم يُخفِ السيسي من البداية أنه لا يؤمن بمجانية التعليم. في أحد مؤتمراته عام 2016، تحدّث الرئيس للناس الذين يطالبونه بملف التعليم عن «ظروف مصر» و«فقه الأولويات الاقتصادية»، وضرب مثلًا بثلاث دول، أولها تلك التي اتبعت مجانية التعليم ووهبت ميزانيّتها بالكامل للتعليم ثمّ واجهت متطلبات شعبها بالعنف والقهر حينما طالب بأشياء أخرى. وعلّق الرئيس السيسي على تلك التجربة بأنه لا يمكنه أن ينتهج النهج نفسه، ولا يمكنه أن يقمع أو يقهر الشعب المصري. ولكن التجربة التي انفرجت أسارير الرئيس وهو يتحدث عنها هي تجربة أخرى تتطابق مع النموذج المصري في عهد محمد علي وعهد كرومر، حيث تحدث الرئيس عن تعليم مقصور على أفرادٍ بعينهم لكي يخلق «طبقة» لقيادة المجتمع تنهض باقتصاد البلاد.
بعد سبع سنوات من ذلك المؤتمر، كان الرئيس أكثر وضوحًا بشأن فلسفة «مجانية التعليم»، وبدا متذمِّرًا من ذلك الحق الدستوري الذي يعطي الحق للمواطن في أن يتعلم على حساب جودة المنتج. كان الرئيس يريد أن يوصل رسالة من وراء المؤتمر، أنه ليس من حق المواطنين أن يطالبوه بتعليم أفضل ما داموا يريدون الحفاظ على مجانية التعليم. فبينما يتعلم 25 مليون طالب، وتلك الأرقام على عهدة الرئيس، ويحتاج كل طالب إلى 10 آلاف دولار، كما يذكر الرئيس أيضًا، فإن مصر في حاجة إلى 250 مليار دولار في السنة، فمن أين لخزائن الدولة كل ذلك؟
يخشى المصريون أن يتعدّى الرئيس على الحق الدستوري في مجانية التعليم يومًا ما، وهو الذي أعاد تعديل مواد دستورية مرّتيْن خلال فترة حكمه لكي تتناسب مع مشروعه في الحكم. وفيما يبدو أنّ الرئيس قد لا يلجأ إلى التعدّي على ذلك الحقّ شكليًا، فإنّ حكومته تسير على أرض الواقع في مسار يعكس ذلك، كما فعلت مع ملف الصحة. فبينما يكفل الدستور حق المواطن في الصحة والعلاج المجاني، قامت الحكومة بالعبث في ذلك الملف، وحوّلت العديد من المستشفيات الحكومية إلى الخصخصة. وفي ملف التعليم، يبدو أن النهج المريح الذي تتّبعه الحكومة هو الإنقاص من مقدرات الإنفاق على التعليم المجاني عامًا بعد عام كما حدث منذ 2015، وترك الأهالي فريسةً للدروس الخصوصية أو التعليم الخاص غير الحكومي المتمثل في مدارس «نيرمين إسماعيل» التي أثارت السخط مؤخرًا في مصر. تُعدّ السيدة نيرمين أحد حيتان بيزنس التعليم غير المجاني في مصر، حيث تمتلك حفيدة المشير أحمد إسماعيل- قائد الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973- سلسلة مدارس «نيرمين إسماعيل» الدولية التي تمتلك فروعًا في مختلف أنحاء الجمهورية، كان آخرها الفرع الجديد المُفتتح في العاصمة الإدارية الجديدة. وتبلغ تكلفة الدراسة في مدارسها من رياض الأطفال إلى التخرج ما قد يتخطى ملايين الجنيهات بشكل إجمالي. تضرب لنا حالة السيدة نيرمين مثالًا جليًا عن حالة تضارب المصالح الذي يسود مصر دون أي خجل أو مساءلة. فالرئيس السابق لتلك المؤسسة ليس إلا وزير التعليم الحالي الذي تُعدّ السيدة نيرمين إسماعيل بمثابة والدته.