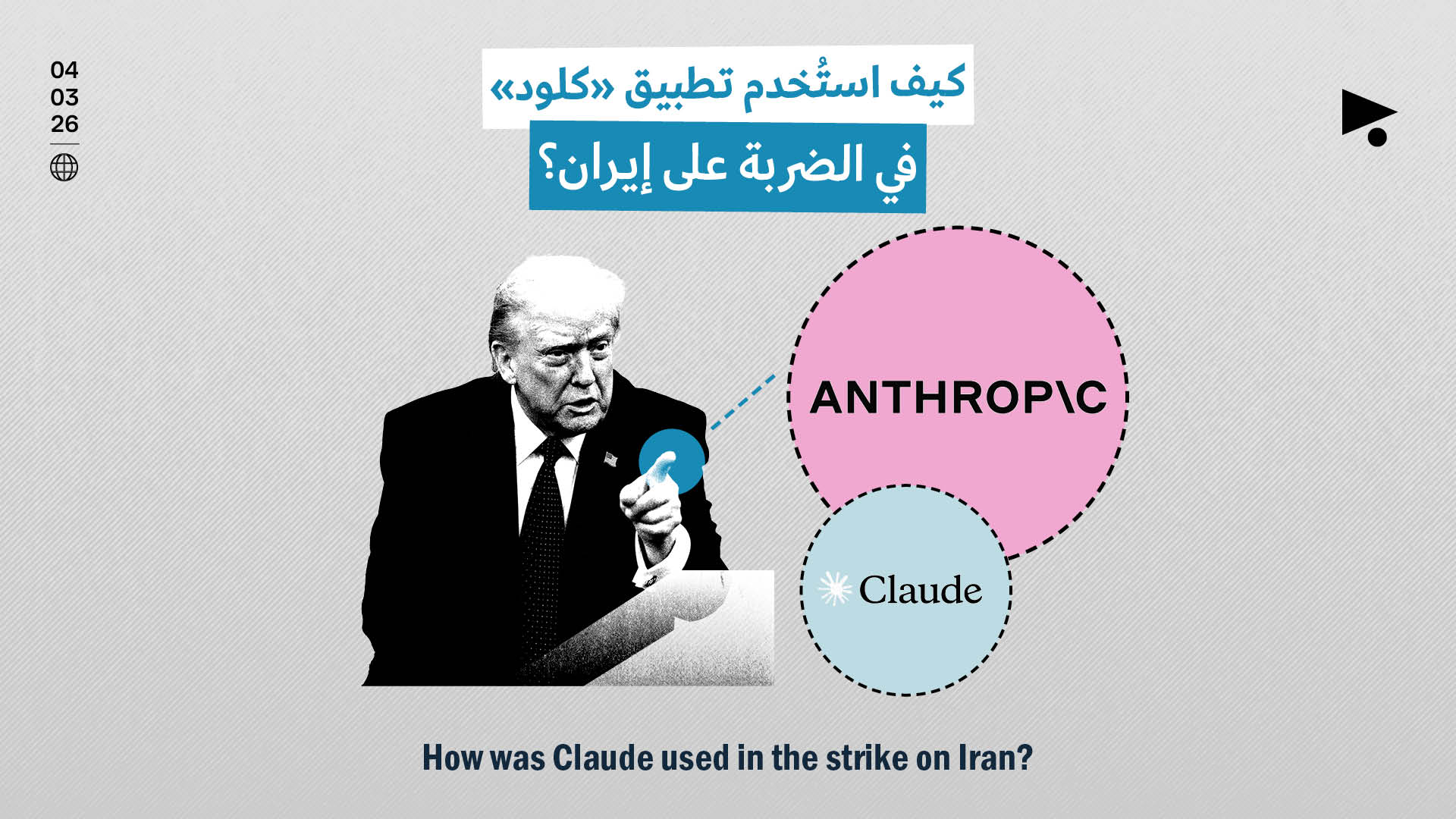تثبت صور العنف بعد سقوط نظام بشار الأسد تعقّد المرحلة الانتقالية. فالنظام البائد دمّر نسيج الحياة وإمكان توليدها في ظروف صعبة ومستحيلة، مع مخلّفات عميقة وتركة ثقيلة لا يمكن إزاحتها إلا بعقود. فنحن أمام تجربة متشابكة توضّح أن الإدارة السورية اليوم تحاول الالتفاف على مسؤوليّاتها الضخمة باعتماد سياسة ممنهجة للعنف، لكسب الوقت، أمام تحديات كبرى داخلية وتغيرات جذرية في الإقليم ولترسيخ قوّتها اعتماداً على فائض العنف والتلاعب بمستوياته.
العنف ومستوياته
يتسلّل العنف الممارس على درجات متفاوتة إلى تفاصيل الحياة اليومية السورية، ليتحوّل إلى حجر أساس في اللحظة الحالية. فهناك العنف الدموي الفج المتمثل بسلسلة المجازر المتنقّلة، والعنف المتمهّل والمتباطئ، القائم على الترهيب والتهديد والتلويح بالعقاب. ولا يقتصر العنف على السياسة أو الطائفية، بل يتشعّب ليأخذ أشكالاً جندريةً حيث تستخدم الأجساد، لا سيّما أجساد النساء والمثليين جنسياً والترانس أرضاً للمعاقبة. كما يظهر العنف الاقتصادي في الجوع والانقطاع الممنهج للدواء والكهرباء.
لا تتعارض أشكال العنف هذه، بل تتكامل في معادلة تعطي لسلطة أحمد الشرع مساحةً لإعادة إنتاج نفسها، حتى ولو بدت وكأنّها سلطة منهارة ومتآكلة. فالعنف السوري اليوم لا يعود فقط تكتيكاً لإسكات الخصم أو لكسر بنية التعارض، بل يهدف إلى تفكيك أي روابط تسمح بتشكيل بديل سياسي. فالعنف سياسة تُحوّل المجتمع إلى مجتمعات، تنعزل في رهابها من الآخر، لا تملك لغة مشتركة للمستقبل ولا قدرة على التضامن خارج نطاق طائفيّتها وقوميتها وتحت سقف خوفها الآني. هذا ما رسّخه عميقاً نظام بشار الأسد وثبّته نظامه القاتل من خلال سجونه ونظام مخابراته وفروعه الأمنية المعروفة ببطشها وتقنيات عنفها الشرسة.
الفوضى نظاماً بديلاً
يتطوّر هذا العنف كآلية لتفادي أي محاسبة في لحظة تعلو فيها المطالب لمسار عدالة انتقالية. فالعنف المتلاعب بمستوياته يجعل من تحديد المسؤولية عملًا صعبًا، ومن تسمية الفعل بالجريمة عملًا معقّدًا. فيتمّ تبرير العنف كنتاج المرحلة الانتقالية أو كمجرّد عمليات لملاحقة فلول النظام السابق أو الخارجين عن القانون. فتصبح الفوضى والدموية نظامًا بديلًا، يسمح لمجموعات غير منضبطة بأخذ مساحاتها وبفرض قواعدها، كما حصل مع مجموعات منضوية في «الأمن العام»، مستغلّة إطارها الجديد والفوضى القائمة للتحكّم. يتمّ إدارته بدقّة وتنسيق بين الفصائل الخارجة لتوّها من أتون الحرب إلى مرحلة الحكم. وهذا ما يجعل المجتمع ينزلق بسهولة في دوامة لا نهاية لها تمنع المساءلة والعدالة المفترضة.
وما كان في حسبان السلطة الجديدة أن تراهن عليه، وهو النصر العسكري، أفضى لا جدوى منه في الأشهر التالية في لعبة السياسة. فكان خيار هذه الفصائل الفائزة أن تربح الوقت من خلال العنف. العنف يجعلها تطيل من هذه المساحة التي تجعلها تعيد تركيب نفسها من جديد، مستفيدة من أنقاض المجتمع المنهك والمفكّك والهشّ. ومن هنا، فإن محاولة فهم ما يجري لا يتكامل بالاكتفاء بتوثيق المجازر أو إحصاء الضحايا بل بتفكيك البنية التي تجعل من العنف نمط حكم.
تفويض المجازر
ويبدو أن النظام الجديد لا ينخرط في تنفيذ كل المجازر أو التهجير بشكل مباشر، بل يميل إلى تفويض أكثر المهمّات فظاعةً، من مذابح وحملات تطهير وتارات جماعية، إلى تشكيلات مختلفة وميليشيات لها ولاء مزدوج ووحدات أمنية تعمل بإمرة مراكز قرار شبه مستقلّة. وتبدو التقنيات مختلفة بدءاً من تسجيل المجازر وفظائعها ونشر لقطاتها لترويع المجتمع أو حذفها لاحقاً لطمس الأدلّة، مروراً بخطف النساء واستخدام العنف الجنسي كسلاح لتفكيك النسيج الاجتماعي. هذه الأدوات ليست عشوائية. هي جزء من استراتيجية سياسية تهدف إلى توسيع دائرة العنف.
لا يعود هذا التفويض خياراً براغماتياً، بل تقنية حكم تخلق شكّاً في سلسلة القيادة، بحيث يصبح إثبات الصلة المباشرة بين الآمر بالقرار وبين المذبحة الميدانية نفسها مهمّة بالغة الصعوبة. فالفعل معروف، من قتل وتهجير، لكنّ المسؤولية تضيع في خيوط متشابكة من الفاعلين، حيث يختفي المركز خلف الأطراف. وبهذا المعنى يتحوّل التفويض إلى أداة مزدوجة، فهو يطلق العنان لنطاق العنف عبر مضاعفة منفّذيه، وفي الوقت نفسه يعزل ويحمي القيادة من المحاسبة. وما يُطلَق عليه الميدان يصير مساحةً ضبابيةً، تتمازج فيها الولاءات المحلية مع مصالح الأجهزة الأمنية (عشائر، قبائل، فصائل، إدارات محلّية) وتترابط في ما بينها بأوامر غير مدوَّنة ومثبَتة مع مبادرات تبدو مستقلّة لأطراف تريد إثبات الولاء عبر ارتكاب المجازر والدخول في سلسلة العنف الطويلة.
تقنين العنف وتحويله إلى موردٍ سياسيٍّ
يبدو أن وصول أحمد الشرع من قائد فصيل إلى رئيس لمرحلة انتقالية هو بذاته لحظة تأسيسية لصيغة جديدة للسلطة، عملها تقنين العنف وتغليفه بشرعية المرحلة الانتقالية. وما اكتسبه الشرع من شبكة معقّدة ميدانياً من فصائل وهيمنة عسكرية وثقة في الشارع السني، يمكّنه من قدرة تنفيذية للعنف لا تحتاج إلى تبريرات. لكنّ الشرع يحظى بدعم آخر، وهو الخارج الذي فتح نافذة دبلوماسية معه خفّفت من عزلة الدولة السورية، من خلال التخفيف الجزئي للعقوبات الدوليّة. كل هذا وفّر لأحمد الشرع مزيجاً من القوّة الميدانية مع دعم خارجي، ما منحه هامشاً، خصوصاً في إدارة ملفّات الأمن والتهجير. في هذا الإطار، يصير العنف مورداً سياسياً ثميناً وورقةً للتفاوض، كما العدالة الانتقالية، لتصبح محاسبة المجرمين أو مهل تطبيق مسار العدالة الانتقالية أو طبيعة المحاكمات جزءاً من لعبة كسب شرعية خارجية أو تفكيك تحالفات داخلية.
تكرّس سياسات العنف حالة إبقاء السكّان في حالة اضطراب وهشاشة دائمة. ففي الوقت الذي كان من الواجب على السلطة الجديدة أن تقوم خلاله بفتح ملفّات النظام السابق ومحاسبة الفاعلين وتنظيف المناطق الملوّثة بالألغام والبدء بإزالة الحطام والردم، وفتح مسارب العودة الآمنة، نراها تؤسّس لنظام حكم مبني على العنف، وإن كان على هوامشه هناك لجانٌ لتقصّي الحقائق، قد لا تنفع في ضبط العنف.