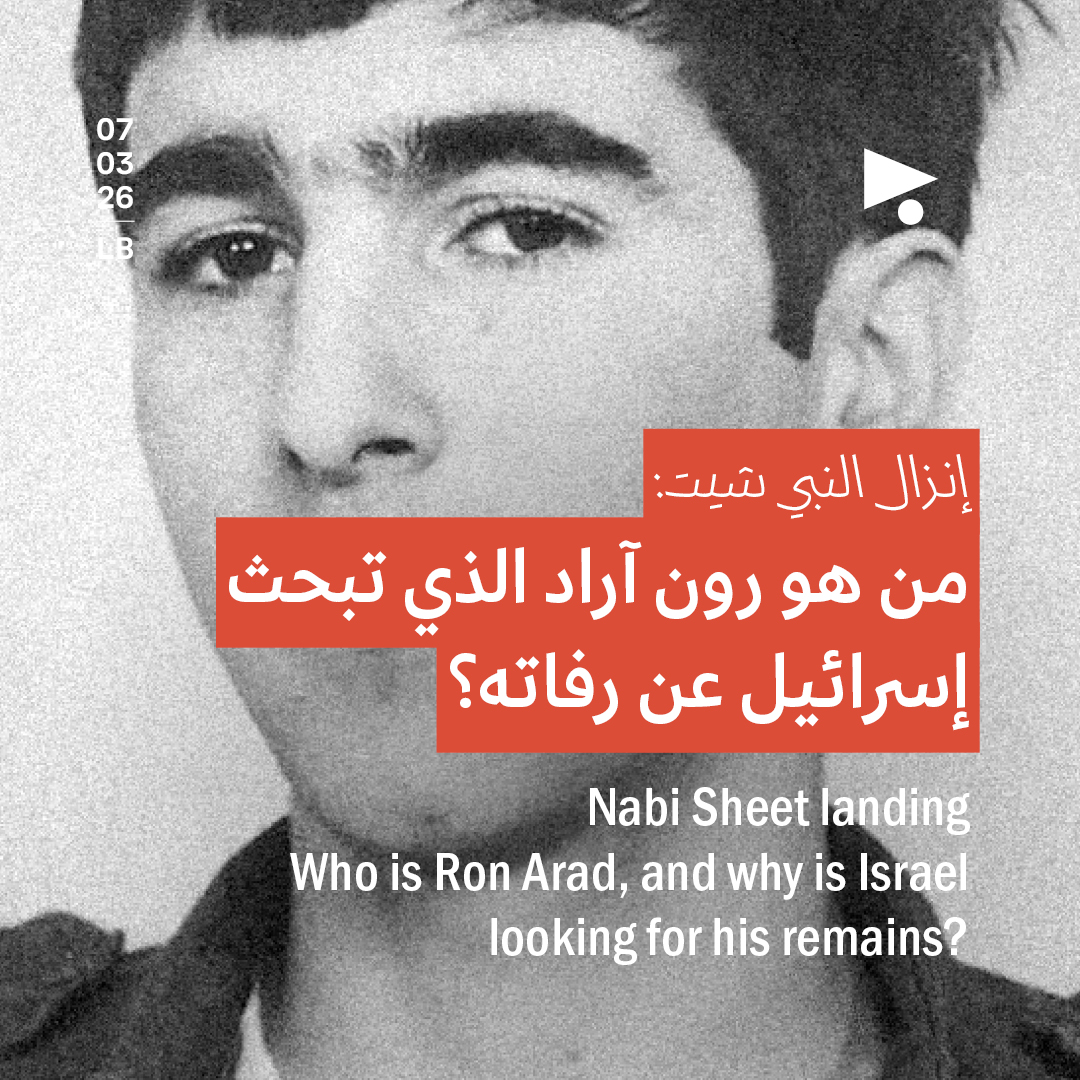في الآونة الأخيرة، صرتُ كثيراً ما أجِد نفسي متسائلاً ما هو هذا الشيء الذي نعيشه حاليّاً في لبنان. أهو خوف، وقلق، وغضب، وحزن، ويأس، وكراهية- ممتزجة كلّها بعضها ببعضٍ- أم شيءٌ آخر يصعب تحديده؟
ما الذي ينتابني، مثلاً، كلّما أغادر المنزل- ونادراً ما أغادره- وأسير في الشارع؟
أحسّ عندئذٍ بأنّ الفضاء فقدَ شيئاً مِن تماسكه فبات رخواً لزجاً، مُنذِراً بتحلُّلٍ وشيك. أدرك أن الإحساس هذا يطلع مِن جوفي، غير أنّني لا أستطيع إلّا أن أنسبه إلى مصدرٍ خارجيّ. وأفكِّر أنَّ المصدرَ هذا ليس سوى غضب المّارة وقلقهم، حزنهم ويأسهم، وكراهيّتهم أيضاً- إذ أتخيَّل أنّ الجميع في الشارع يكره الجميع. لكنّني عندما أُحدِّق في وجوه بضعة منهم، لا ألمح فيها شيئاً مُختلفاً، بل أراها مطابقةً لما كانته مِن قبل- لما كانته قبل أشهر، وحتّى قبل أكثر مِن سنة. إنّني أدلقُ اضطراباتي على الدنيا وسُكّانِها، أقول لنفسي، وأتابع سَيْري مُتناسياً وجوه المارّة.
لماذا، مثلاً، أشعرُ بالذنب أحياناً عندما أصرّف مئة دولار؟ ألأنّني، مقابل هذه الورقة الوحيدة الخضراء، أحصل على مبلغ يفوق بمئة وخمسين ألف ليرة الحدَّ الأدنى للأجور؟ ألأنّ القدرة الشرائية لهذه الورقة قد ارتفعت كثيراً؟ ألأنّني أتمنّى أحياناً في سرّي أن يواظب سعرُ صرف الدولار على الإرتفاع، بالرغم مِن إدراكي لأثر ذلك الكارثيّ على معظم اللبنانيين؟ ألأنّني أعجز عن تخيِّل كيف يمكن لعائلات كثيرة أن تعيش طوال شهر بأقلّ مِن قيمة هذه الورقة الخضراء؟
كيف يحدث، مثلاً، أنّني، خلال أغلب لحظات أيّامي، أكون ناسياً أنّ ما يحصل إنّما يحصل بالفعل؟ ناسياً أنّ هذا الشيء الذي نعيشه حالياً في لبنان، هذا الشيء الغريب والذي يصعب تحديده، إنّما نعيشه بالفعل؟ إذ يبدو لي، خلال أغلب لحظات أيامي، أنّني أعيش حياةً طبيعيّة، وأنّ كلّ شيء لا يزال على سابق عهده تقريباً. أمّا في تلك اللحظات القليلة حين أجدني وقد صحوت مِن النسيان، فأُبصِرُ شيئاً يُرعبني ويُذكِّرني نوعاً ما بلحظة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب. أُبصِرُ شيئاً لا أفهمه، هو إيّاه ما نُسمِّيه «الانهيار»، غير أنّ كثرة ترداد هذه التسمية أحالته أمراً أليفاً دخل يوميّاتنا وأضحى في صلب تصوّراتنا المُشتركة عن الدنيا. صار العيش في الإنهيار- أو في بداية الإنهيار- شيئاً طبيعيّاً اعتدناه ونادراً ما نلحظه بحقٍّ، مع أنّنا بتنا لا نتكلّم عن شيء سواه تقريباً.
صرنا نجهد للعيش في الإنهيار كأنّ الإنهيار لم يحصل. أو كأنّه حصل وبلغ ذروته، وما علينا الآن سوى التكيّف فحسب. فيتكيَّف مِنّا مَن يُتيح له ظرفُه ذلك. ومَن لا سبيل له إلى التكيِّف، فإلى المزبلة. أو إلى الذبح. ومِن المُستحسن ألّا يُرينا وجهه وهو يُذبح. ألّا يُسمعنا صراخه. ومِن المستحبّ أنّ يُراق دمُه في زاوية مُعتمة.
نتكيّف إذاً. فهل مِن أمرٍ نفعله غير ذلك؟ لكنّ الإنهيار لا يلبث أن يخطوَ خطوةً أخرى إلى الأمام، فينهار تكيُّفنا، ونحدس إذّاك بأنّ المسافة التي تفصلنا عن تلك الزاوية المُعتمة – حيث يُذبح مَن لا يتكيَّف – قد قَصُرَت. نتحسَّس أعناقنا ونجزع، ثمّ ننكَّب مجدداً على التكيّف. كي لا نُذبح الآن. وكي ننسى، مِن الآن وحتّى يخطو الإنهيارُ خطوةً أخرى إلى الأمام، أنّ مصيرنا قد يكون الذبح.
نعلم أنّ الذبح سيستمرّ لسنوات أو حتّى لعقود. وأنّ وتيرته ستتسارع. لكنّنا نعلم أيضاً أنّه قد يتوقَّف في يوم مِن الأيّام. بعد سنوات. أو بعد عقود. لذلك نأمل في سرِّنا – وقد يتملّكُنا ذنبٌ شديد جرّاء ذلك – ألّا يصلَ دورنا، أيّ أن تصل المذبحة إلى خواتيمها فيما لا يزال في وسعنا التكيّف. ولذلك أتمنّى أحياناً في سرّي أن يواظب سعرُ صرف الدولار على الإرتفاع- وليس الذنب الذي قد يتملّكني حينئذٍ سوى الضريبة التي عليّ دفعها كي أُجيز لنفسي تمنّي ذبحَ آخرين بدلاً منّي.
كثيراً ما أنسى أنّني أعيش في مذبحة يحاول سكّانها التكيّف مع قوانينها المتوحِّشة والمُتبدِّلة باستمرار. لكن ما أنساه أكثر بعدُ- مع أنني أعلمه علم اليقين- هو أنّ المذبحة هذه لا تُشبه الكوارث الطبيعية إلّا سطحياً. فهي مِن صنع الإنسان. ثمّة بشر استحوذوا على السلطة والثروات، وها نحن نُذبح نتيجة ذلك. أو نتمنّى ذبحَ غيرنا علّ الدور لا يصل إلينا.