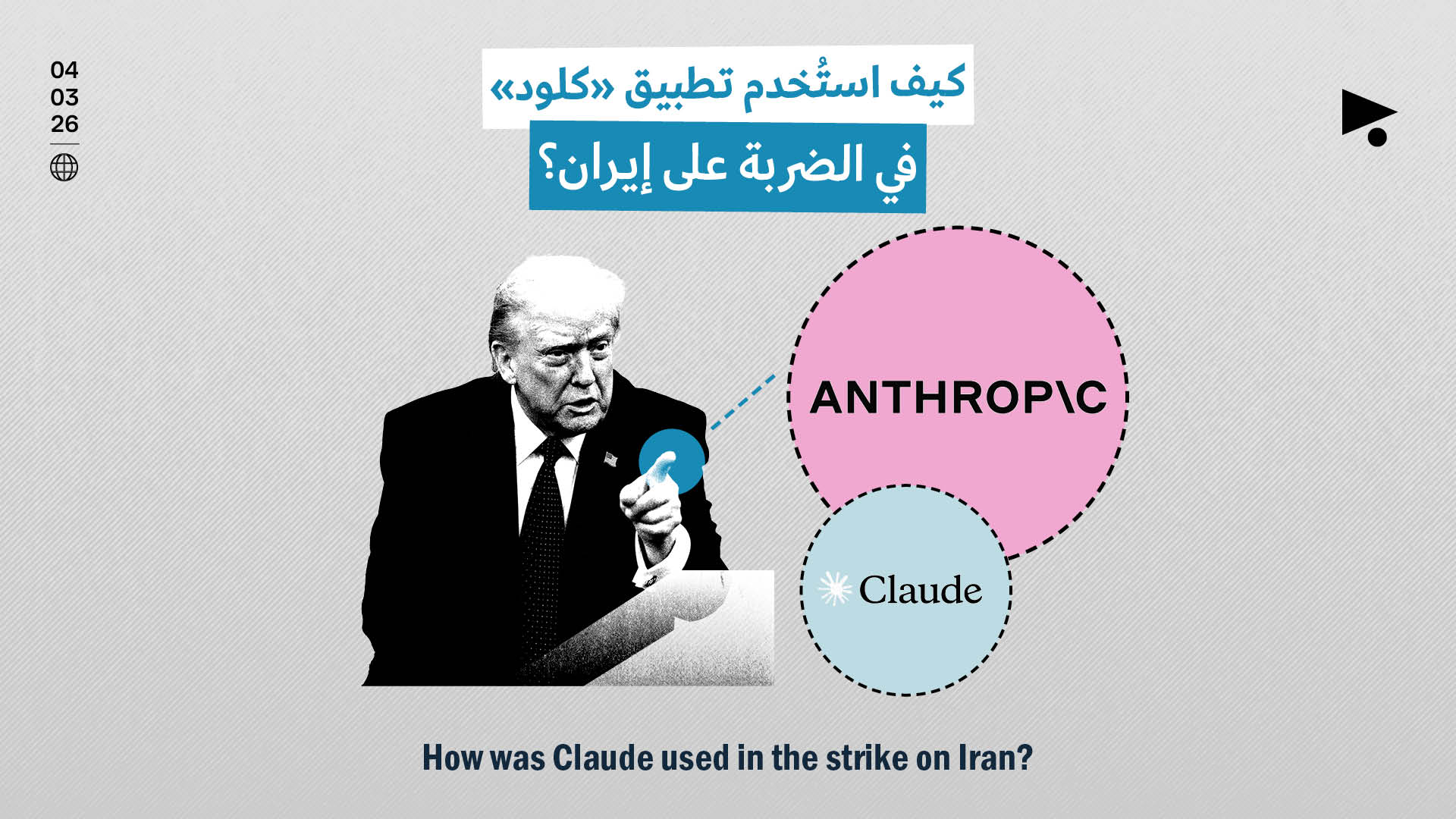إن حطك راس المال براسه، فش ولا حدا بيحميك
من أغنية شارع يافا في ألبوم «أحلى من برلين» لفرج سليمان، كتابة مجد كيّال
كان صباحاً قاسياً …
بدأت أرى سعر صرف الدولار يرتفع 500 ليرة في النصف ساعة، حتى وصل سعر الصرف في آخر اليوم إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار. كأنها معركة بيني وبين نفسي ولا أحد يخسر سواي… ولا أحد يربح سوى تجار المال من كل الأنواع، مكاتب الصيرفة والمصارف والوزارات والمقاعد النيابيّة والمؤسسات الخيريّة، وصولاً للكنائس والمساجد وغيرها من دور العبادة المُستحدثة مثل «السوبرماركت» الذي يُخزّن البضائع المدعومة منتظراً الانهيار الأكبر ليجني الأرباح الطائلة.
ومن عادتي، المرور كل يوم إثنين على محطة البنزين نفسها في بيروت لملء سيارتي بالوقود. يستقبلني كالعادة «أحمد»، العامل المصري، بسلامه المعتاد إزيك يا باشا. هذا الشاب لا يملأ سياراتكم بالبنزين فقط، بل ينظف أيضاً زجاجكم أثناء الانتظار. من الممكن لأنه يسعى لكسب القليل من «البخشيش» من السائق.
لا عيب في ذلك، فكلنا نسعى للحصول على القليل من «البخشيش» في المهن التي نختارها.
حتى وزير الصحّة حمد حسن لم يكتفِ بمخزون الأوكسيجين لدينا وقرر أن يقبل البخشيش من «بشار الأسد»، 75 طنّاً من الأوكسيجين، تكفي لثلاثة أيام. شحادة سريعة، لا عيب فيها ولا سؤال في جمهوريتنا المنهارة بلا ماء وبلا وجه. هل يا ترى سيفرض عليّ القدر أن أتنفس هواء الأسد غصباً عني؟
دعكم من وزير الهلع، فلنعد إلى أحمد على محطة البنزين.
عادةً تجدونه يُغني طوال اليوم أثناء عمله ولا تفارق وجهه الإبتسامة المزروعة «غصباً عنه» نوعاً ما. هو نفسه قال لي من قبل إنه يبتسم لعلّ جيب صاحب المحطة يبتسم أكثر للعاملين فيها. كانت عادتنا المشتركة شتم صاحب المحطة سوياً بصوتٍ خافت. نضحك كل مرة وأناوله ألفي ليرة. يضع النقود في جيبه ويقول لي كل مرة كُلنا مجاريح يا عم، قبل أن أكمل طريقي إلى الحياة التي كانت تزداد قساوةً يوماً بعد يوم.
ولكن في آخر زيارة لي للمحطة، لم ألمح ابتسامته، لم يحاول حتى الكذب على نفسه بسلامه المعتاد. اليوم لست «باشا»…
كان أحمد ناشفاً وغاضباً وصارماً بما قاله لي:
أنا عاوزك بخدمة يا زاك، اكبسلك كبستين زيادة بنزين وتعطيني سيجارة؟
جرحني… يُفاوضني ويُحاول إغرائي من أجل سيجارة. أصبحت السيجارة في بلادنا طلباً ثقيلاً بعد أن فقدنا من السوق أي علبة سجائر سعرها صديق الفقير. اللعنة الزائدة على أحمد هي أنني لم أحمل علبة سجائر في تلك اللحظات. قلت له سأعود ومعي علبة. لم يعارض لأي لحظة بل قال لي والله يا باشا مش ح قولك لا وحاجات عزّة النفس دي... تعبان يا باشا.
أتعلمون ما هي عزّة النفس؟ هي الحساب الجاري الخاص بالفقراء. لا يمتلكون سوى عزّة نفسهم ولا يأخذون المساعدة بل هم أول من يبادرون بالمساعدة بما توفر. لو عدنا بالزمن للـ2019، كان أحمد سيبدأ عراكه «الصدوق» معي وسيطلب مني الرحيل وكنا سنضحك ولم أكن سأناوله شيئاً. أحمد فقد عزّة النفس وهو يستسلم أمامي ويقبل عرضي بأن أشتري له علبة سجائر. على الأرجح أنه لن يدخن بوتيرته السابقة بل سيقسم تلك السجائر على الساعات والأيام القادمة.
في بلادنا القاسية، لا يمكننا اختيار نمط عيشنا، ولا طريقة مماتنا ولا حتى يمكننا أن «نحرق على زعل»، لا يمكننا تدخين السجائر بعد اليوم أثناء دقائق الراحة القليلة التي تمنحنا إياها مؤسساتنا ومشغّلونا.
كيف سننجو ونحن نتنفّس «نيترات الأمونيوم» بدل «النيكوتين»؟ هل العلاج بأوكسيجين الأسد؟
أين النَّفَس وأين عزّة النَفْس من حياتنا التي لا هواء طبيعياً فيها ولا سرطان من صنع أيدينا يفتك بصدورنا؟
حين غادرت المحطة نسيت كليّاً أن أحمد قد سألني عن سيجارة. حتى تضامني معه كان مؤقتاً قبل أن تتوافد على سيارتي مجموعات غير منظّمة من المتسوّلين والأطفال الذين كانوا يبيعون العلكة قبل الأزمة. اليوم يشحذون فقط، فلم تعد العلكة سعرها محمول لبيعها والربح منها. في الوقت عينه، ألاحظ أمامي سيارات من كلّ الأعمار والطرازات والجنسيات. كلّها تُدخن، الجديدة، القديمة، التي بحالة جيدة أو كسيارتي المضروبة، كلها سيارات تُدخن على ما يبدو «بنزين مضروب».
سخرية القدر أن السيارات تُدخّن ونحن نتنشّق ونفتح صفحة جديدة للتأقلم مع لبناننا الذي حرمنا السيجارة في سنة 2021.