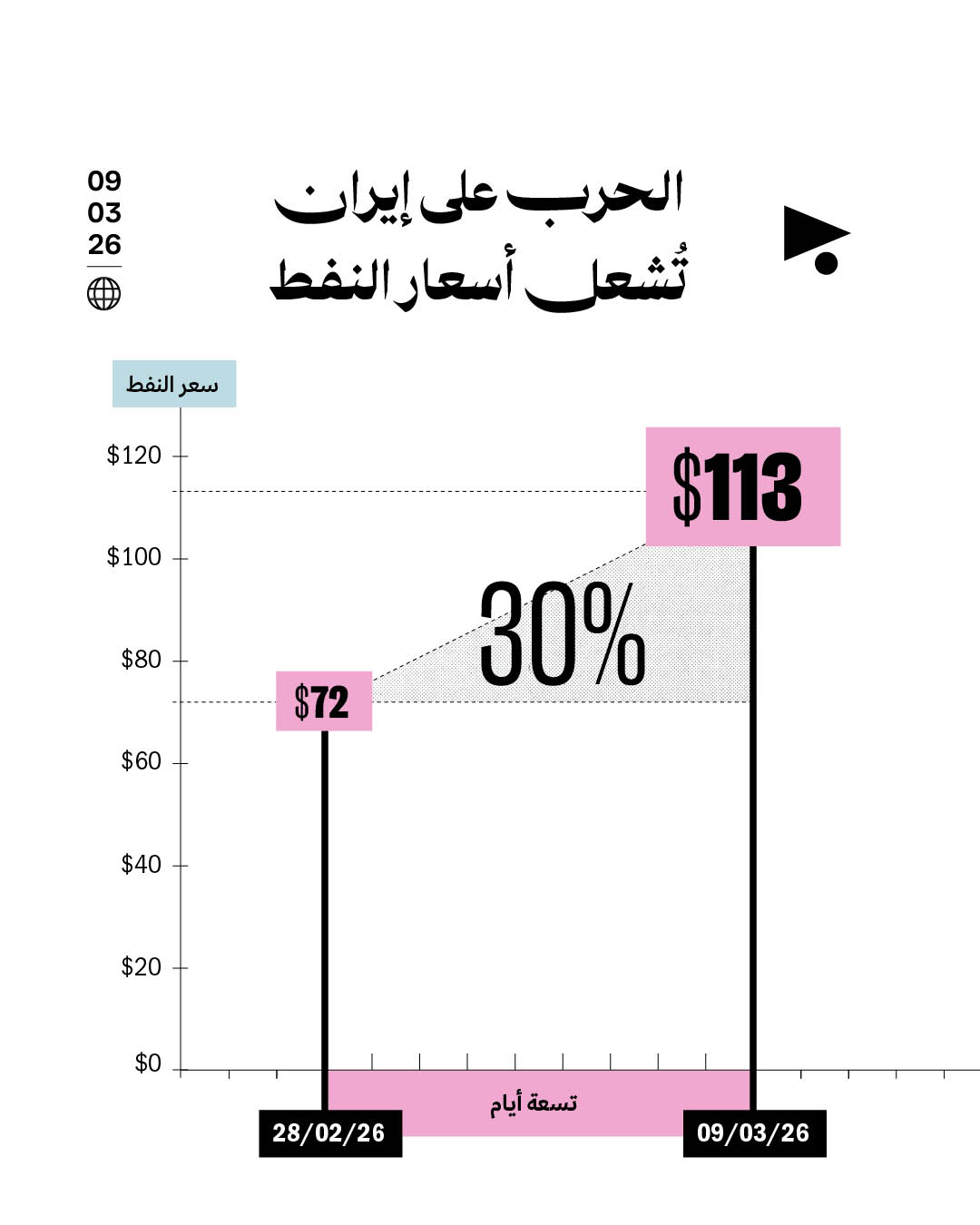نشاهد منازلهم تحترق أو تُقتحَم، ونبتهج. نشاهدهم يتلعثمون وهم يتبرّأون من علاقتهم بمهرّب من هنا أو من عريضة عار من هناك، وتمتلئ قلوبنا بخبث سعيد. نلاحقهم عبر هواتف «الثوار» وهم يفرّون من مطعم أو عرس، ونتلذّذ بطعم الثأر والكره الذي يفيض من فمنا.
نبتهج، ونحاول أن نُسكِت هذا الصوت الخفي الذي يحذّر من العنف المتفلّت، من هذا اليوم الذي سيخطئ «الثوّار» في هدفهم، من هذا الاقتحام الذي سينتهي بدم… لا نحتاج إلى الكثير لإسكات هذا الصوت. فهو يتضاءل يوميًا، مع كل جريمة أو فضيحة أو مجرّد تصريح لواحد «منهم». يخفت هذا الصوت ويستبدل بحالة من الابتهاج لأعمال الثأر هذه، للعدالة الانتقامية التي تبدو كالعدالة الوحيدة المتبقّية.
أسكتوهم…
نشاهد صور هذا الموكب الذي يقطع الطريق على الناس لكي يمرّ… أسكتوه. نرى رطلًا من العسكر ينهالون ضربًا على مواطن… أسكتوهم. نشاهد حاكم مصرف لبنان يتباهى على شاشات العار… أسكتوه. يحاضرنا سيّد المقاومة بنظريات الحصار والتهريب والزراعة… أسكتوه.
مجرّد غضب، وحاجة دفينة بإسكاتهم، حتى إذا جاء هذا السكوت جرّاء عنف…
وعندما يمرّ نهار من دون أي عملية ثأر، نتخيّل يوم إعلان موت أحدهم، يوم سنتلقى رسالة على «الواتس آب» تؤكد وفاة عون أو برّي، نتخيّل هذه البسمة الخفية التي ستزيّن وجهنا في هذا النهار، بسمة سنحملها كبطاقة انتساب لجماعة «الشماتة في الموت».
حتى «جمهورهم» سيبتسم في هذا النهار.
لكنّ هذا العنف لم يعد سرًا، نتلذّذ به من وراء شاشاتنا، لم يعد مجرّد أفكار سوداء تظهر مع اشتداد الأزمة، أو لعنة نطلقها بعد أربع ساعات في أحد طوابير المدينة.
بات هذا العنف في يومياتنا، ضابطاً لإيقاعها، ناظماً لمنطقها… فلم تمرّ ساعة من دون خبر مشكل على محطة بنزين أو في صيدلية، أو خبر مأساة على أبواب المستشفيات أو في طابور انتظار، أو خبر انفجار في عكار أو في المرفأ، أو عملية قتل في مكان ما.
بات العنف في كل مكان، يحيط وينظّم أصغر علاقة في هذا المجتمع المنهار.
نريد عنفًا عليهم ونغرق بالعنف بيننا… وندرك تمامًا أنّ هذا العنف المتفشّي سينقلب علينا يومًا ما. ربّما سيأخد منحًى طائفيًا كما اعتدنا عليه، وربّما سيتحوّل إلى عنف عصابات وأجنحة عسكرية. أو سيتحوّل إلى عنف قوى أمنية قبضت حالها جد، مع الإغراء المتزايد تجاه فكرة الإنقلاب العسكري. أو ربّما أسوأ من كل هذا، سيبقى عنفًا بلا منفس، ليلوّن كامل علاقتنا، وصولًا إلى أكثرها حميمية.
كائنات معنّفة وعنفية… كل طابور انتظار هو مصنع لكائنات معنّفة وعنفية لن تجد إلّا بعضها بعضاً لتنفيس هذا العنف.
وماذا يمكن أن نقول لأي شخص قرّر أن يختار طريق العنف، أكان انتقامًا أو مجرّد غضب؟ انتظِر القضاء، انتبِه أنو العنف بجيب عنف، أوعى الحرب الأهلية، ما هيك منعبر عل دولة، ركّز ع يلي فوق… كلها حجج باتت تنتمي إلى عالم ولّى.
الصمت في وجه العنف. لم يعد لنا أي مناعة ضد العنف، هذا العنف الذي نريده، هذا العنف الذي يحيط بنا، هذا العنف الذي يُفرَض علينا، هذا العنف الذي سيقتلنا يومًا ما.
أهذا عنف مبرّر أو ثوري أو رجعي أو عبثي؟ بات هذا السؤال بحدّ ذاته خارج الموضوع، نوع من العنف النظري يأتي فوق العنف المعاش. فالعنف بات هنا، موجود بيننا، يتغلغل في كل حركة نأخذها.
هذا ليس جديدًا، فالعنف كان من يوميات أكثرية من يعيش في بلاد القسوة هذه. ربّما كنّا نتجاهله لأنّنا استطعنا جراء امتيازنا أن نهرب منه أو نتعايش معه أو نبني مجتمعًا من حوله. كنّا ساذجين عندما اعتبرنا أنّه يمكن التعايش مع عنف بنيوي، حتى استفقنا يومًا وهذا العنف بات المشترك الوحيد.
ونحن ساذجون إن كنّا نأمل بضبط هذا العنف، بأي طريقة كانت، قبل الاعتراف بالجريمة الأصلية. فهناك جريمة وقعت، جريمة سقطت ضحيتها «الحياة» في هذا البلد، جريمة يحاول مرتكبوها طمسها لكي نبدأ من جديد، جريمة نحمل آثارها في أجسادنا ومستقبلنا وعمق قلقنا.
إذا كان لهذا العنف، أي عنف، أي دلالة، فهو في رفضه الضمني لهذه الجريمة. في كل مشكل أو حالة غضب أو تمنٍّ بالموت، مطالبة ضمنية، ليس بالدولة أو القانون أو النظام، بل العدالة، عدالة تكبّرنا عليها بالماضي وبرّرنا غيابها بشتى الطرق.
عدالة لا تحتاج إلى كثير من التعريف والتدقيق اليوم، عدالة بتنا نشعر بفقدانها مع كل نفس نأخذه، عدالة كالمخرج الوحيد من العنف.