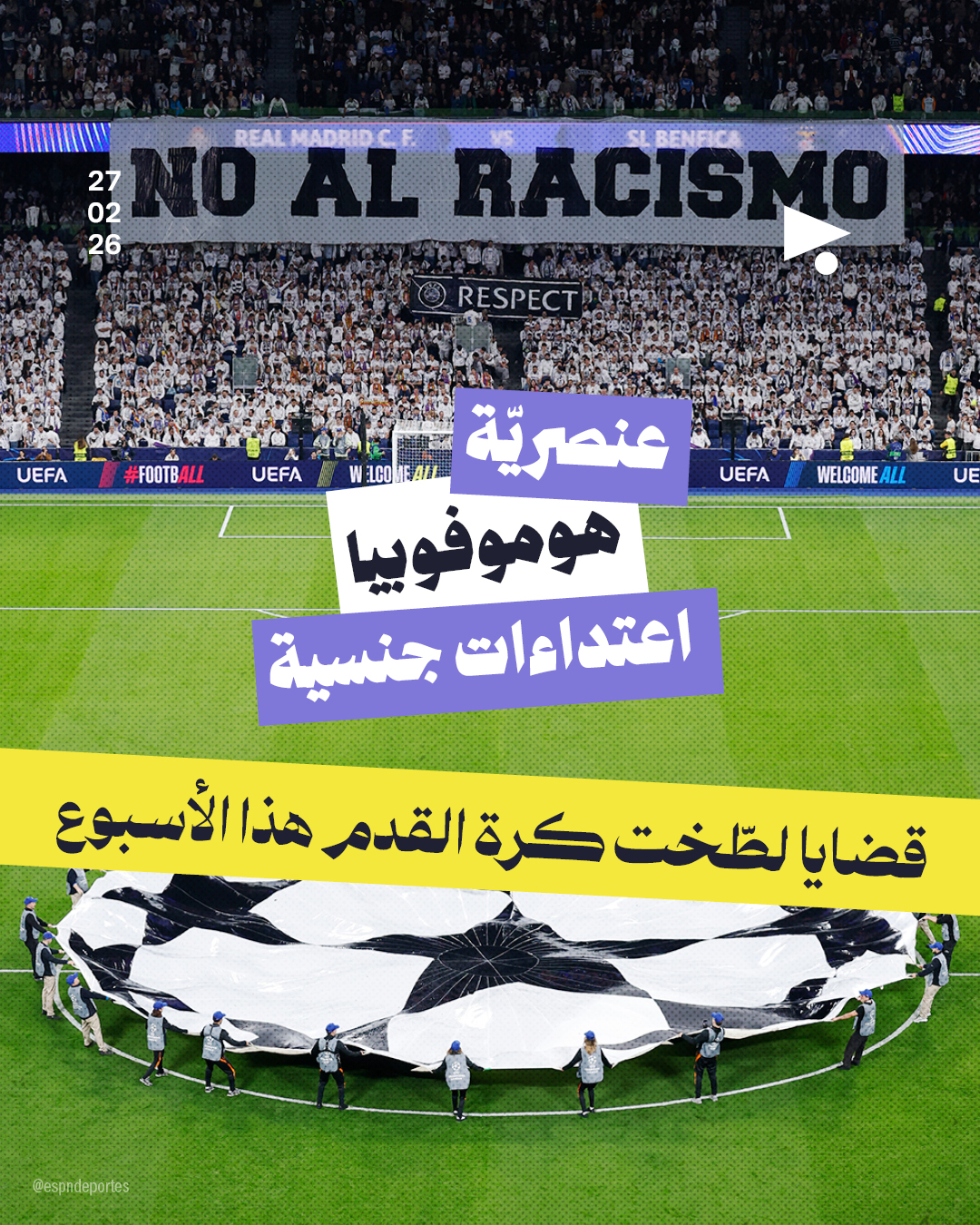«النهار هو الليل»

خلال مشاركته في انتفاضة 17 تشرين، صوّر المُخرج غسان سلهب عشرات الساعات. قال إنّه لم يصوّرها ليصنع فيلماً. لكن حين عاد إليها بعد سنوات، ارتأى أن يستخدمها في فيلمٍ وضعَ له عنوان «النهار هو الليل».
اختار سلهب مَنْتَجة ما يقارب الثلاث ساعات من التظاهرات، قبل أن ينتقل في نحو ثلاث ساعات أُخرى لما تلا الانتفاضة من عيش في ظلّ الكورونا، فانفجار مرفأ بيروت، وصولاً إلى حرب الإبادة في غزّة. وبين كلّ هذه الأحداث العامّة، يحكي المخرج عن خسارته لوالدَيْه خلال هذه السنوات نفسها.
لا يقدّم سلهب، لا في الفيلم ولا في حديثه عن الفيلم، إجابةً عن سبب عودته إلى تلك المقاطع المصوّرة عن الانتفاضة، ولماذا قرّر في النهاية أن يستخدمها في صناعة فيلم. لكنّ الإجابة قد تكون في تلك العبارة التي كُتِبت على جدران بيروت، والتي تظهر في الفيلم أكثر من مرّة: «صرنا ننتمي للفقدان».
أحسب أنّ الفيلم ليس فيلماً عن الانتفاضة، بل عن هذه العبارة بالذات. ربّما كانت الانتفاضة ومآلاتها جزءاً من هذا الفقدان. وربّما كانت مجرّد حيلةٍ استخدمها المخرج ليُتِمّ حداده على والديه، مجرّد جيغابايتات هائلة كان عليها أن تخرج من حاسوب المُخرج حتّى يصبح الفقدان مرئياً.
قبرٌ لعصام عبد الله

عُرِض فيلم سلهب في سينما متروبوليس يومَ الأحد 12 كانون الثاني 2025. كان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد دخل حيّز التنفيذ. بعد أسبوعَيْن تماماً، الأحد 26 كانون الثاني 2025، بدأت العودة إلى القرى الجنوبيّة الحدوديّة. توجّه مصوّرٌ صحفيٌّ يُدعى محمد زناتي إلى مقبرة بلدة الخيام ليبحث عن زميله عصام عبدالله، عصام الذي قُتِل بنيران إسرائيلية استهدفت تجمّعاً للصحافيّين في بلدة علما الشعب في 13 تشرين الأوّل 2023.
عند دخوله المقبرة، نسمع صوت بقايا القبور المدمّرة تُطقطِق تحت قدمَيْه، ثمّ نشاهد باقة وردٍ على الأرض، وأخرى مغروسة داخل حجر. الأرجح أنّ أحداً سبق محمد إلى المقبرة ليزور مَن فقدَه في هذه الحرب. من بعيد، نلمح شاهداً مُحطّماً على الأرض، تتناثر حوله شظايا الرخام. وحين تتحرّك الكاميرا، نتعرّف إلى صورة عصام المطبوعة على الشاهد المكسور في جزئه العلويّ والسفليّ، والمرميّ على الأرض، تغطّيه حجارةٌ مصدرُها- على الأرجح- أنقاض المقابر. بدأ محمد بإزالة الحجارة من فوق الشاهد قائلاً: حتى لحقوك عالقبر يا عصام. ثمّ رفع الشاهد عن الأرض ووضعه بشكل عموديّ، فعادت صورة عصام لتحدّق بنا. كأنّ محمد اطمأنّ الآن أنّ هذا هو عصام. أعاد الشاهد إلى الأرض، وراح يمسح التراب بيديه عن الصورة. يمسح ويمسح بإصرار حتى تعود الصورة واضحةً ويعود وجه صديقه عصام مرئياً. عندها فقط، قال: الله يرحمك.
مِشرَط غسان حلواني

في فيلمه «طِرس، رحلة الصعود إلى المرئيّ»، لم يستخدم غسان حلواني يديه لإزالة التراب عن صور مفقودي الحرب الأهليّة اللبنانية، بل استخدم مِشرَطاً لإزالة ملصقاتٍ إعلانيّة عن جدران العاصمة بيروت، حتّى تظهر من تحتها بقايا صُور المفقودين التي عُلِّقت في زمن سابق. الفيلم، بحدّ ذاته، يبحث عن أثر مفقودي الحرب، والطِّرس هو ما مُحِي ثمّ كُتِب، أو الكتابة فوق الكتابة. وكأنّ حلواني وهو يبحث عن الأثر الباقي لصور المفقودين، يعيدهم إلى الفضاء العامّ ليعيدهم إلى الحياة. كأنّه يزيل بمشرطه طبقة إعادة الإعمار، حتى تظهر من تحتها طبقة المقابر الجماعيّة.
يروي غسان قصّة المفقودين وقصّة المجتمع الذي فُقِدوا فيه. لكنّه يروي أيضاً قصّة مفقودٍ محدّد هو والده عدنان حلواني الذي يعود في نهاية الفيلم بهيئةِ رسومٍ متحرّكة، مرئيّاً لكن غير ملموس.
حين اختفى خليل أحمد جابر

تبدو حركة المشرط في فيلم حلواني معاكِسةً للحركة التي قام بها خليل أحمد جابر قبل 38 عاماً في رواية «الوجوه البيضاء» لالياس خوري. لم يتحمّل خليل فكرة أنّ ابنه أحمد، الذي سمّاه على اسم والده، والذي استشهد في بدايات الحرب الأهليّة، قد اختفت صورُه عن جدران المدينة لتحلّ محلّها صور شهداء آخرين. فالحرب طالت، والشهداء تكاثروا، وبات أحمد مجرّد شهيد واحد من مئات الشهداء الذين يسقطون تباعاً وتُصمَّم لهم الملصقات وتُعلَّق على الجدران.
في تشرين الثاني من العام 1980، عُثِر على جثّة خليل بالقرب من تمثال حبيب أبي شهلا بعد ثلاثة أسابيع على خروجه من منزله. خلال هذه الأسابيع الثلاثة، شوهد خليل، بحسب عدد من الشهود، ينتقل من شارع إلى شارع، حاملاً سطلاً من البويا البيضاء. في الواقع، لم يشأ خليل أن يصبح ابنُه غير مرئيّ، لكنّه لم يعثر على أثر لصُوَره، فخطر له أن يطلو جدران المدينة بالأبيض حتّى لا تظهر عليها صورٌ أُخرى تُنسينا صورة ابنه الشهيد، أحمد خليل جابر.
عنف الفقدان
لا أعرف متى «صرنا ننتمي للفقدان». لكنّ هذا الانتماء الجماعيّ يوحي بأنّ المسيرة استغرقت زمناً. ربّما منذ انفجار مرفأ بيروت، أو بعد «طوفان الأقصى»، أو مع عنف الثورات العربيّة المضادّة، أو الحرب الأهليّة اللبنانية، أو الأحداث التي سبقتها، أو اجتياح 82، أو مجزرة الكرنتينا، أو مجزرة الدامور، أو مجزرة التبّانة…
أيّاً تكن البداية، لعلّ أعنف ما في هذا الفقدان الجماعيّ هو مصادرته للفقدان الشخصيّ أو استتباعه. كأن يصبح فقدانُك الحميم حدثاً يقع بين قمع انتفاضة وتفجير مدينة وحرب إبادة. وفي مواجهة كلّ ذلك، لا تملك إلا دفتر يوميّاتك، أو يَدَيْن تزيل بهما أثر التراب، أو تحمل بهما مشرطاً أو سطل بويا، أو تقود بهما سيّارةً لتذهب إلى صالة سينما حيث تمضي ستّ ساعات محاولاً استعادة صورتك، وإتمام حدادك الشخصيّ، لعلّ فقدَك يصبح مرئياً.