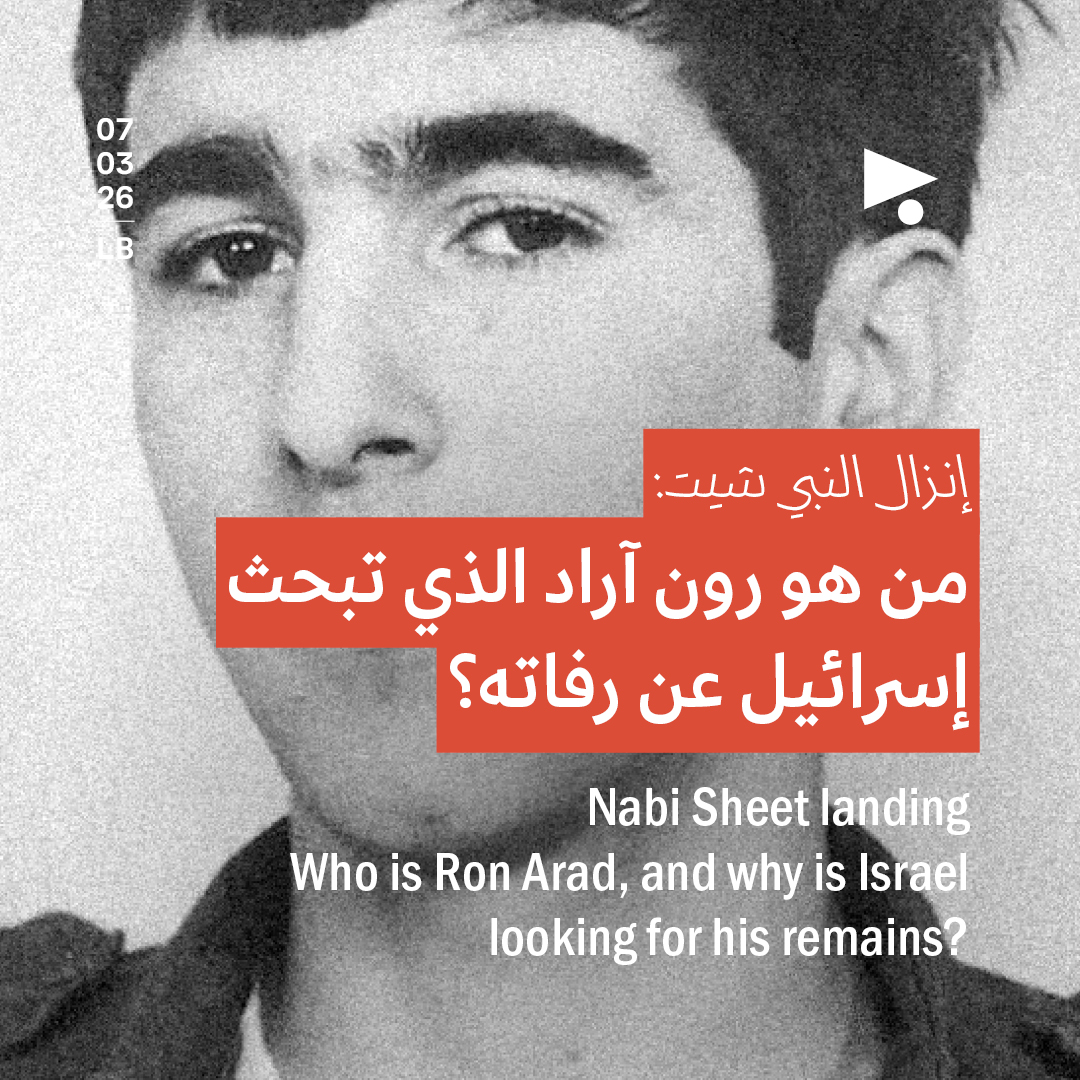منذ 18 تشرين الأول الماضي، وعلى امتداد أسبوعَيْن تقريباً، شاركْتُ يوميًّا في تظاهرات ساحتَيْ رياض الصلح والشهداء، لكنني لم أفعل ذلك ولو مرّةً واحدة بملء إرادتي تماماً. فكلّما كنتُ أُحيل مسألةَ المُشاركةِ في التظاهر إلى عقلي، كان يقول لي: اِبْقَ في المنزل، فأنتَ تَحْتقِرُ الحشودَ، وتَعْلَمُ يقيناً أنّ لبنانَ كومةُ برازٍ نتنة سوف تَعْظُمُ نتانتُها سنةً تلوَ أخرى.
غير أنّ طاقةً خارجيّةً ما كانت تبدأ بالتسرّب إلى بدني، فتُشعِرُني بشيءٍ مِن الدِّفْء والخَدَر، كأنّما قد انتهيتُ لتوّي مِن حمّام ساخن. يَخْفتُ ضجيجُ أفكاري، وتروح مُخيِّلتي ترسم لي صوَرَ جماهير مُتظاهِرة أستطيع سماعَ هتافاتها داخل رأسي، فأحسُّ بأنّني ما عدتُ نفسي، بأنّ مَن يتخيَّل ليس أنا حقّاً، فأحاول بما تبقّى لي مِن إرادةٍ أن أستعيد ذاتي الأصليّة، لكنّ ذلك لا ينجم عنه سوى تَمَلْمُلٍ لا يلبث أن يستحيل تَوَتُّراً ثمّ حالةً من الهياج لا تشرع بالخمود قليلاً إلّا لحظة مُغادرتي المنزل قاصداً وسط بيروت.
أعود ليلاً مُفْرَغاً مِن كلّ طاقةٍ وأيّ شعورٍ وفكرةٍ، فآوي إلى الفراش مُرهَقاً ومُعاهداً نفسي على أنّ الغد سيكون يوم عطلة: أيّ أنني لن أطّلع على آخر الأنباء، ولن أقرأ الصُّحفَ ولا المواقع الإلكترونية، ولن أشاهد البثّ الحيّ على قنوات التلفزيون، ولن أُلقي على فيسبوك ولو نظرة واحدة، وقَطْعاً لن أشارك في التظاهر. ويأتي الغدُ، وتتبخَّر قراراتي كُلُّها ما إن أفتح عينَيَّ قبل ساعَتَيْن مِن وقت استيقاظي المُعتاد وفيما هتافات البارحة تضجّ مؤْلِمةً داخل جمجمتي؛ وبعد الظهر، أجدُني مجدّداً بين الحشود وقد أُخْرِسَتْ تحفّظاتُ عقلي.
لستُ أنا مَن يتظاهر حقّاً، إذ لا أنزلُ إلى الشارع كفردٍ ذي إرادةٍ حُرَّةٍ ومُستقلِّة. ثمّة قوّةٌ جمعيّةٌ لا وَجْه لها، تسلبني إرادتي وفرديَّتي، تسحبني عنوةً مِن منزلي، وتجرُّني إلى الشارع كي أتلاشى بين الحشود.
ليست هذه القوّةُ ما يُسمّى، في الفلسفة السياسة، بالإرادة العامة. فالأخيرةُ مفهومٌ بالغُ التجريدِ، في حين أنّ ما يرمي بي في ساحة الشُهداء هو شيءٌ أكاد أستطيع أن ألمُسه بيدَيّ. إنّه كائنٌ حيٌّ تشكَّل مؤقَّتاً، متوحِّشٌ وبديعٌ في آنٍ واحد، بمقدوره أن يكون خلّاقاً أو مُدمِّراً، وقد يختفي في أيّ لحظة. وهو ظهور هذا الوحش البديع الذي لا وجه له، ما أربَك السلطةَ السياسية أيّما إرباك.
لم يُجرّدني هذا الوحشُ مِن إرادتي فحسب، وإنّما سلبني أيضاً مُخيِّلتي ومشاعري الفرديّة، مُستبدلاً إيّاها بأخرى ذات طابع جمعيّ. فإنْ حصل وذَرَفْتُ دمعةَ تَأَثُّرٍ لدى رؤيتي ذاك الجنديّ باكياً أثناء تصدّي الجيش للمتظاهرين الذين قطعوا طريق جلّ الديب، فإنّي أذرفها لأنني أتخَيُّل نفسي مُتأثِّراً مع الجماهير الغفيرة التي ترى ما أراه على شاشة التلفزيون فيما تنهمر سيولٌ من الدموع. وإن حصل وانتابتني حماسةٌ لدى رؤيتي على فيسبوك صورةَ تلك الشابة وهي تركل مُرافق أكرم شهيب، فذلك لأنني أتخيُّل حماستي قَطْرةً مِن دمٍ يَغْلي في عروقِ عملاقٍ جبّارٍ وغاضب.
لستُ أنا، إذاً، مَن يَشْعُرُ ومَن يَتَخَيَّل. بل هناك خيالاتٌ ومشاعر تخترقني وبالكاد أقوى على مقاومتها لثوانٍ قليلة. قبل 17 تشرين الأول الماضي، كنتُ أجد تلك الصُّوَر والخيالات مبتذلةً وأُطْلِق عليها تسمية «كيتش»؛ وكنتُ أنعتُ تلك المشاعر بالساذجة. أمّا الآن، فبتُّ حائراً في أمري في ما يخصّ النعوت والتسميات.