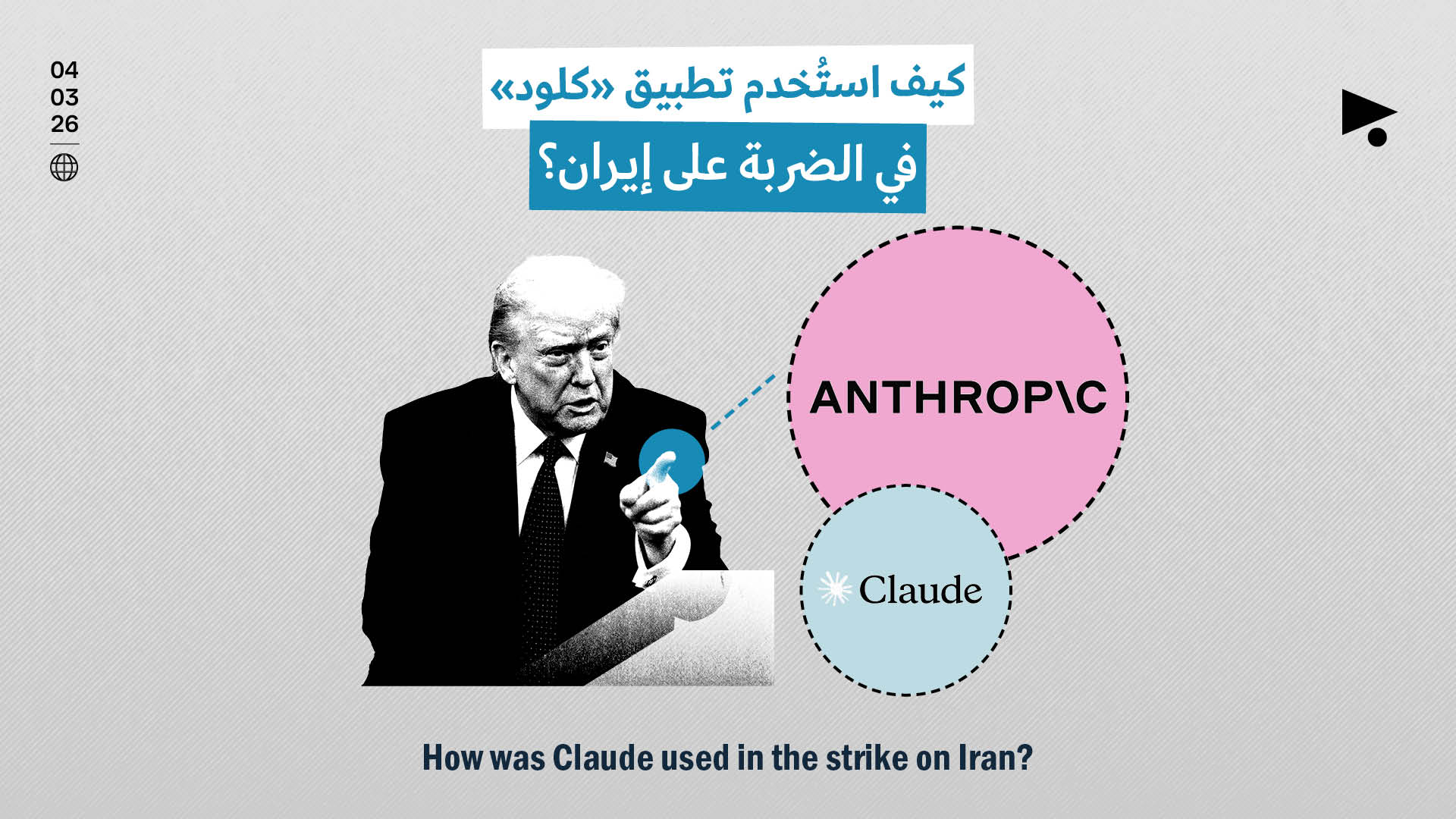انتزعت قضية التغيّر المناخي اهتماماً واسعاً مع انتشار أنماط الطقس الغريبة ومواسم الجفاف الطويلة والعواصف الحادّة، التي أظهرت ما كانت تخبّئه الأرقام والمصطلحات العلميّة. وبينما كانت المجتمعات العلمية على علمٍ مسبقاً بعواقب الانبعاثات والتلوّث الذي أحدثه الإنسان، لم نلمس هذه التداعيات على حياتنا مباشرةً إلّا توّاً، تزامناً مع الزيادة المتوقّعة في درجات الحرارة عالمياً والتي قد تصل إلى 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن. وإذا ألقينا نظرةً أقرب، تشير التنبّؤات المناخية إلى أنَّ العواقب المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط قد تكون أعلى بنسبة 25% إلى 40% مقارنةً بالمتوسّط العالمي.
لماذا لا تزال الانبعاثات مستمرّة إذاً، ولا يزال الوضع البيئي متّجهاً نحو الأسوأ رغم الجهود التي تبذلها الدول والأفراد، ورغم إنفاق المليارات على المؤتمرات والاتّفاقات والبحوث والحملات؟ وما الذي يقف فعليّاً وراء هذه الأرقام؟
لَوْم الأفراد بدلاً من الشركات
انتشرت عدّة سرديّات في محاولةٍ لتأطير الأزمة البيئية. وإذا ما اطّلعنا على أصل هذه المقاربات، نرى تيّاراتٍ تدّعي الموضوعية، إلّا أنّها تحجب في الواقع السبب الرئيسي لتزايد الانبعاثات، أي علاقات وأساليب الإنتاج الحاليّة. ويصحّ أيضاً أن نحاجج أنَّ هذه السرديّات بحدّ ذاتها تلعب دوراً أساسياً في تكريس هذه الأزمة.
واحدة من أكثر السرديّات شيوعاً هي لوم الأفراد وتحميلهم مسؤولية الأزمة البيئية.
تضغط هذه المقاربة بشكلٍ أساسي على الأفراد لمواجهة التغيّر المناخي شخصيّاً عبر تحسين أنماط معيشتهم وعاداتهم اليومية. تتّضح إذاً عبثيّة هذا المنطق: وكأنَّ بإغلاقنا حنفيّة المياه عندما نفرشي أسناننا، سنعوّض عن كلّ المياه التي تُهدَر لريّ ملاعب الجولف، والتي تتطلّب في الولايات المتحدة وحدها 10 مليار ليتر من المياه يوميّاً. من المضحك إذاً، وفي ظلّ هذه المعلومات، أن نتجاهل أنَّ المبادراة الفرديّة هنا لا تقترب حتّى من كميّة المياه المهدورة يوميّاً لأسبابٍ غير ضروريّة.
إنَّ إلقاء المسؤولية على عاتق الأفراد ليس فقط غير فعّال عمليّاً، ولكنّه يعتمد أيضاً منطقاً خاطئاً. يُشيْطَن الأفراد، وتحديداً الطبقة العاملة والفئات المهمّشة، بسبب أنماط حياتهم، بينما تتسبّبُ أبرز 100 شركة بأكثر من 70٪ من الانبعاثات العالميّة. على سبيل المثال، تتّهم بعض التيّارات الليبرالية المؤيّدة للنباتيّة الحصريّة (veganism) آكلي اللحوم برفع نسب انبعاثات الكربون. وتماشياً مع هذا المنطق، يؤنّب ليبراليّو «الطاقة الخضراء» السائقين على سيّاراتهم التي تعمل على الوقود بدلاً من السيّارات الكهربائية.
تتجاهل هذه السرديّات تماماً الدور الذي تلعبه الشركات متعدّدة الجنسيات ضدّ المصلحة الجماعية لزيادة أرباحها. من حيث أنماط الاستهلاك بسبب التنقّل مثلاً، ضعّفت شركات السيارات كـ«فورد» و«جنرال موتورز» خطوط النقل العام، والتي تُعتبر أكثر رفقاً بالبيئة، عبر التحريض ضدّها وشراء هذه الخطوط لإبطالها عن العمل.
إنَّ «فورد» و«جنرال موتورز» ليست لوحدها، فللشركات الكبرى تاريخٌ مجحف بحقّ البيئة نسبةً للدمار والضرر الذي تسبّبت به. فقد ضغطت شركات النفط، مثل «إكسون موبيل»، لإيقاف البحوث التي موّلتها الحكومة لدراسة التغيّر المناخي وآثار انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون في الستّينات، والتي كان بإمكانها لو استُكملت أن تمدّنا بعقودٍ كاملة من الوقت الإضافي لتجنّب الأضرار وحماية كوكب الأرض. إضافةً إلى ذلك، يرفع سوق الوجبات السريعة مثلاً من كلفة البدائل الصحية والمحلية والعضوية، خصوصاً بالنسبة للطبقة العاملة. تشتّت هذه السرديّات إذاً الانتباه عن قطاعات الإنتاج والشركات التي تتسبّب بشكلٍ أساسي برفع نسب الاستهلاك والانبعاثات، ومثالٌ على ذلك، إدراج شركة النفط البريطانية لمفهوم «البصمات الكربونيّة» الذي يرتكز مجدّداً على المساهمات الفردية في تفاقم الأزمة البيئية بدلاً من الإنتاج الصناعي.
توزيع الخسائر والمسؤوليات
إذا اطّلعنا على حجم اللوم الذي ينوب الأفراد مقارنةً بالضرر الذي تروّج له الشركات والقطاعات الصناعية الكبرى، يتّضح أنَّ توزيع الخسائر لا يتناسب مع توزيع المسؤوليات. يتضرّر صغار الكادحين بنسبٍ كبيرة من التغيّر المناخي، بينما يبقى كبار الصناعيين أكثر الفئات تحصيناً ضدّ هذه التداعيات. تهاجم هذه السرديّات أفراد الطبقة العاملة وتوبّخهم من أجل اتّباع أنماط حياةٍ «أكثر ملائمةً للبيئة»، والتي تمّ تسليعها أيضاً (كإعادة تدوير النفايات والاعتماد على الأغذية العضوية والسيّارات الكهربائية)، بينما يموّل المليارديرات برامج فضائية تنتج أكثر من 300 طن من ثاني أكسيد الكربون في كلِّ عملية إطلاق. تنتج رحلةٌ فضائيةٌ واحدة (11 دقيقة) على سبيل المثال، أكثر من 75 طن من ثاني أكسيد الكربون لكلِّ راكب، وهو أكثر من ما ينفقه الفرد خلال حياته بأكملها. هذه الشركات ربحيّة بصلبها، فليس لديها أي نيّة بخفض وتيرة الإنتاج مثلما لا تمتلك الدوافع لتحسين ظروف عمّالها.
لقد تغيّر بالفعل وجه كوكبنا، وإذا أردنا أن ننقذ مستقبل الجنس البشري، فلا يمكننا أن نضيّع المزيد من الوقت على التكنولوجيا «الرائدة» التي تعتمد بشكلٍ أساسي على الربح. لن تعكس الطحالب آكلة البلاستيك، أو مبادرات الشركات لتحفيز المسؤولية الاجتماعية، أو محطّات عزل الكربون، الضرر الناجم عن التغيّر المناخي، ولن تخفّض من أعبائه. ليس من الضروري فقط أن ننتقد مساهمة الشركات الكبرى بزيادة نسبة الانبعاثات العالميّة، بل دوافعها الخاصّة أيضاً، خصوصاً مع انتشار خطاب «المسؤولية الفرديّة». تصبح الأولويّة هنا للناشطين البيئيين والمعنيّين في القضايا البيئية تغيير هذه السرديّة السائدة.
يكمن السبيل الوحيد لمقاومةٍ بديلة في تحويل اللّوم بعيداً عن كبش المحرقة، أي المستهلكين الأفراد، إلى الجناة الحقيقيين، أي أرباب الإنتاج. ليس تغيير عاداتنا اليوميّة هو الحل لإنقاذ كوكب الأرض، بل مواجهة أساليب الإنتاج الرأسمالية.