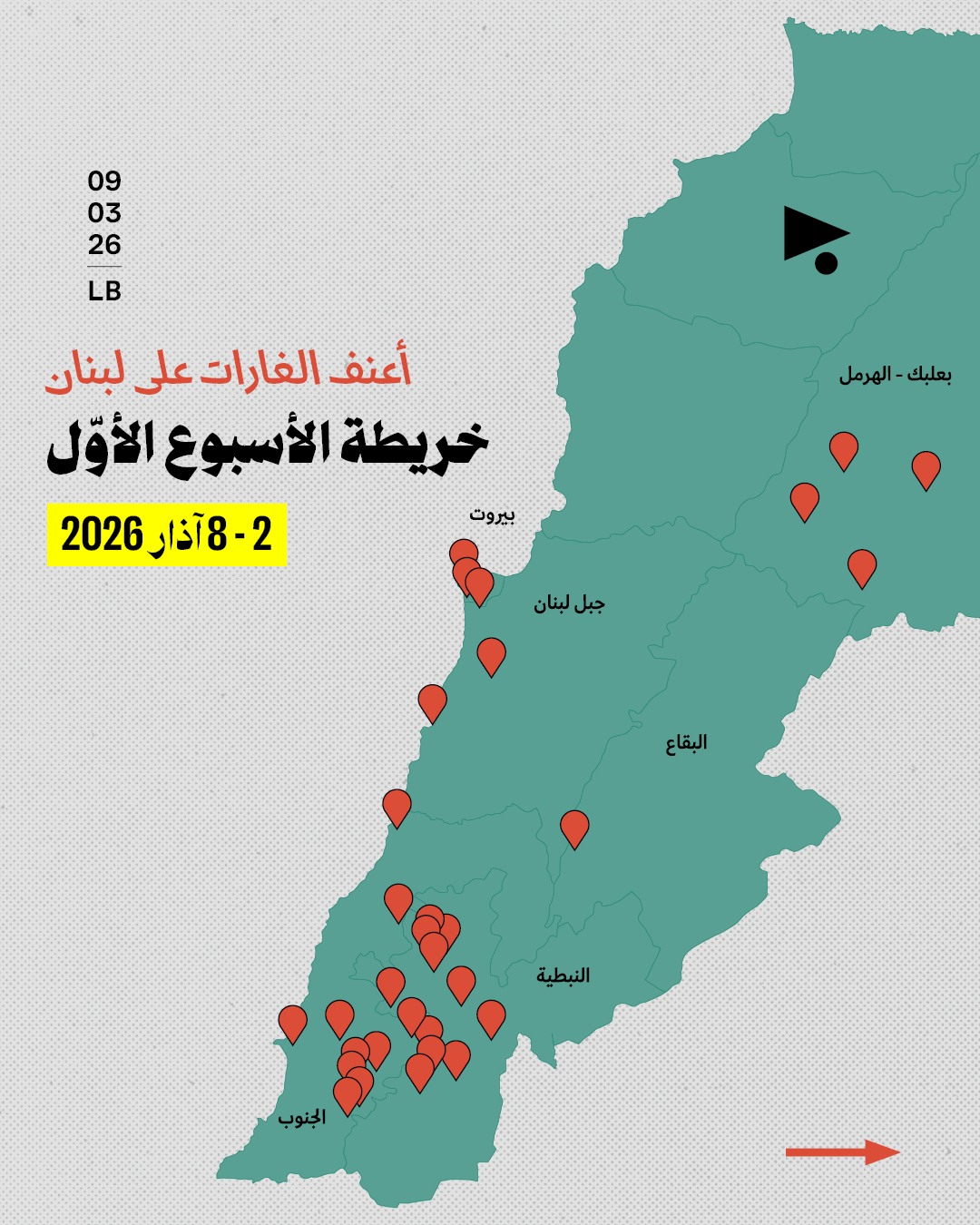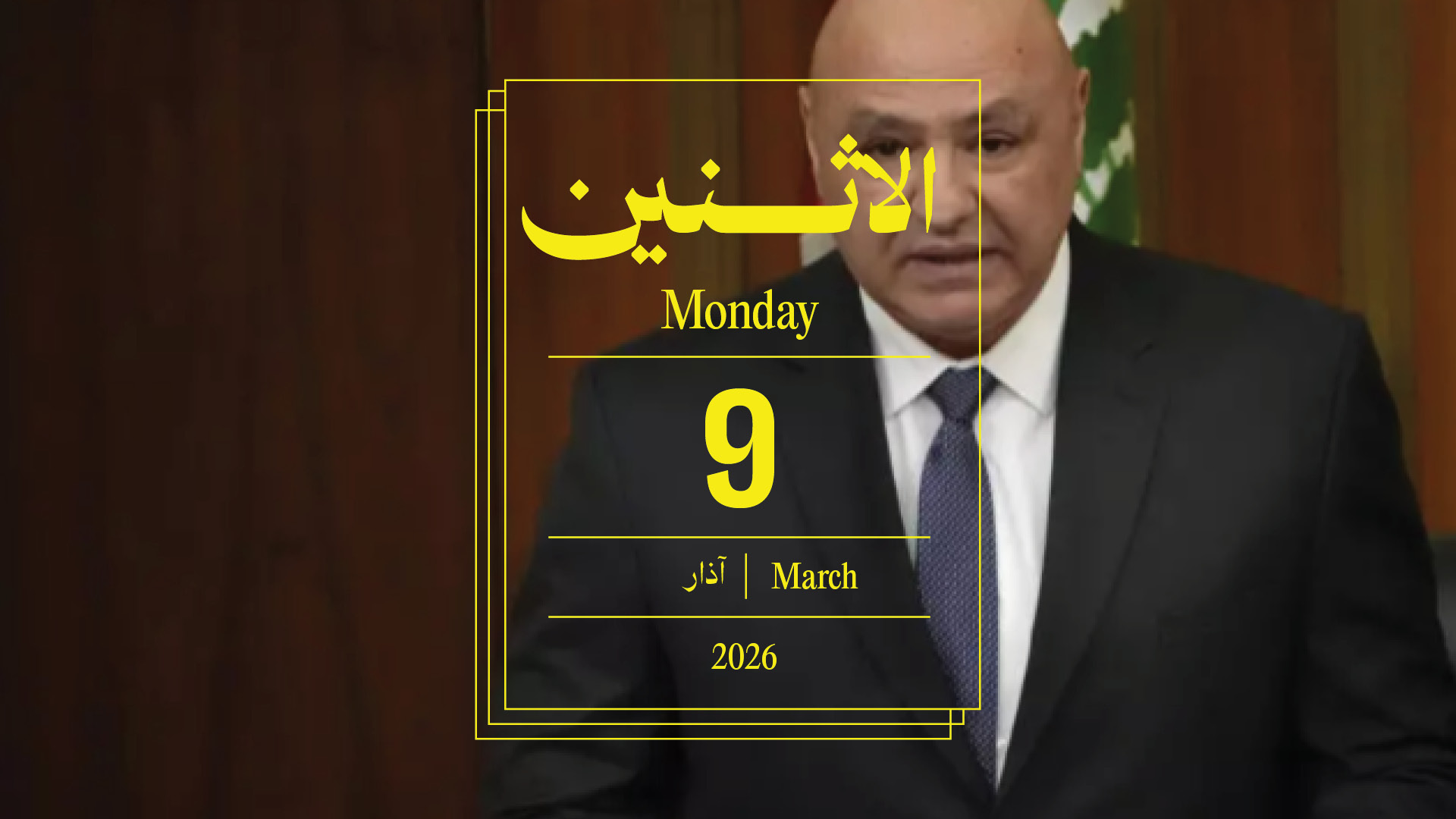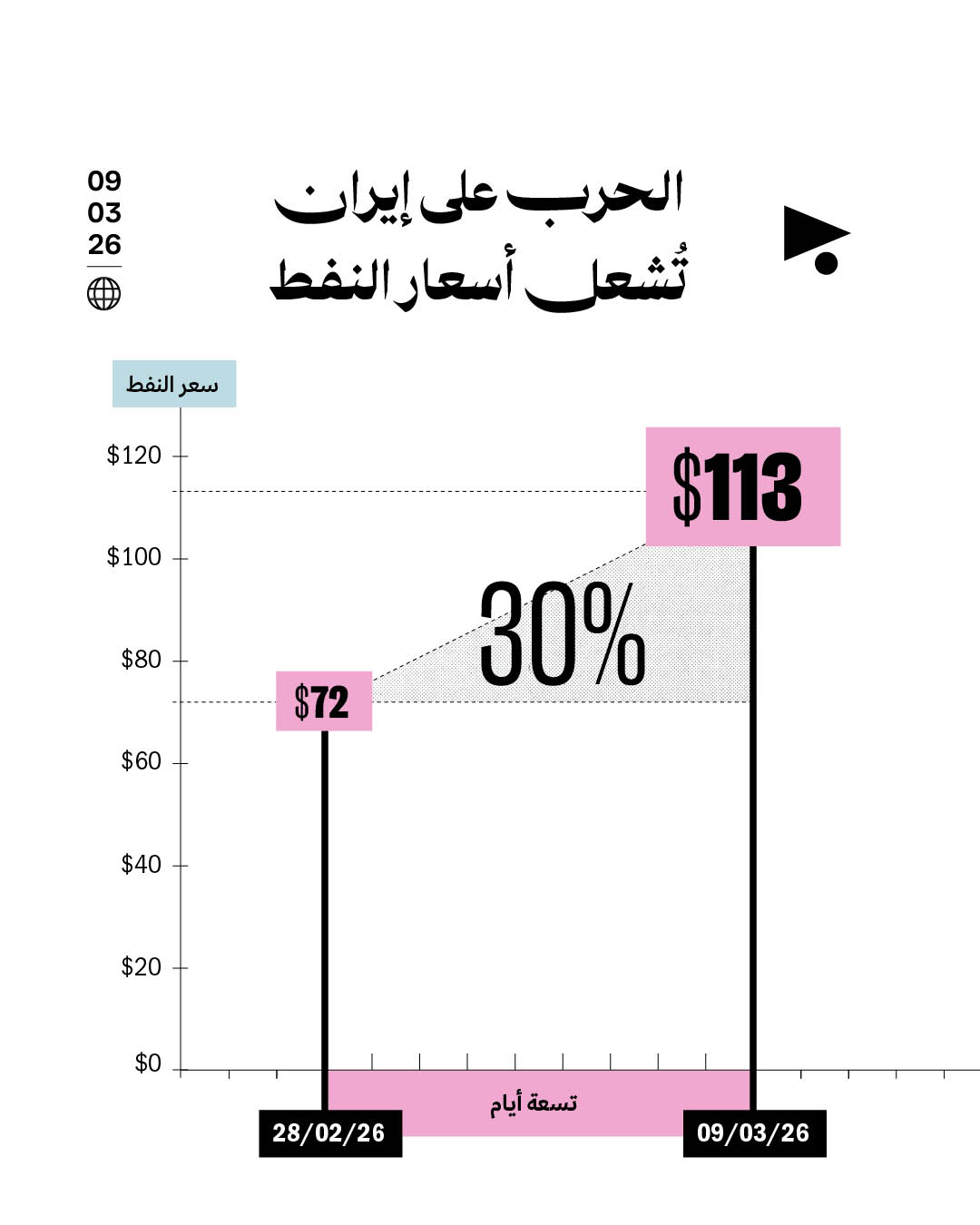انتهت الحرب منذ 28 يوماً فقط. ومع ذلك فقد تلاشت بسرعة من الخطاب العام. لا يزال ثمّة كلام عن إعادة الإعمار المُرتقَبة، وتعدادٌ يوميّ لخروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن في ما عدا ذلك يندُر ذكرُ الحرب في الصحف ونشرات الأخبار التلفزيونيّة. كأنّنا لسنا مجتمعاً خرج لتوّه من حرب استمرّت أكثر من سنة، وكان الشهران الأخيران منها مدمِّرَين ودمويَّين.
الأمر نفسه يمكن ملاحظته في الأحاديث بين الأفراد. قبل بضعة أيّام، أمضيْتُ خمس ساعات برفقة ثلاثة من أصدقائي. ذهبنا إلى مطعم في الجبل. بالكاد أتينا على ذكر الحرب. فقط ملاحظات قليلة عابرة، كقولي إنّني حلمت البارحة بأنّ الحرب عادت، أو إشارة أحد هؤلاء الأصدقاء إلى أنّه لا يزال يفزع من الأصوات القويّة، كإغلاق الباب بعنف. ربما كانت هناك ملاحظتان أخريان أيضاً، لا أذكرهما الآن. فقط لا غير. خمس ساعات أمضيناها معاً ولم نمنح الحرب سوى دقائق معدودة من وقتنا.
الأمر عينه ينطبق أيضاً على ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي: غياب شبه تامّ للحرب، كأنّها لم تحصل قطّ.
صحيحٌ أنّ حدثاً مهولاً وقع بعد أقل من أسبوعين من وقف إطلاق النار: السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد– وهو حدث لم يكن أحد يتوقّعه، ولا شكّ في أنّ تداعياته على لبنان ستكون كثيرة وهائلة، فلا عجب، إذاً، أن يسترعي كامل اهتمامنا ويُلهِب مشاعرنا. لكن هل يكفي هذا لتفسير خروج الحرب من نطاق اهتماماتنا بهذه السرعة القياسيّة؟ وهل خرجت فعلاً؟
في بيروت العاصمة، لا أثر للحرب اليوم. غادرها النازحون بين ليلة وضحاها، فاختفت زحمة البشر والسيارات كأنّما بسحر ساحر. وها هي المدينة تستعدّ الآن لعيدَيّ الميلاد ورأس السنة. لا شيء حسيّاً أو ملموساً يُشير إلى أنّه كان ثمّة حرب. كأنّها كانت مجرد سرّاب تلاشى. وإذا لم تذهب إلى ضاحية بيروت الجنوبيّة أو إلى جنوب لبنان لرؤية الدمار بعينيك، فإنّك تستطيع الادّعاء أنّها كانت فعلاً مجرّد سراب. فأنت لم ترَ الدمار أصلاً إلّا على شاشتَي التلفزيون والهاتف. كان، إلى حدٍّ ما، دماراً افتراضيّاً. كان دماراً صوَريّاً، ترافقه أحياناً أصوات انفجارات في معظمها بعيدة.
هل مَن لم تصبْهم الحربُ بكارثة أو فجيعة تعافوا منها بهذه السرعة المدهشة؟ أمّ أنّهم قرّروا ببساطة نسيانها أو تناسيها؟ أم أنّ ما عاشوه خلالها كان عاديّاً وطبيعيّاً إلى حدّ كبير، فلم تكن هناك حاجة، أصلاً، للتعافي منه ولا لنسيانه؟
ربّما أصبحت الحروب محفورةً في حمضنا النووي، نحن شعوب المشرق العربي ومجتمعاته، لكثرة ما توالت علينا في تاريخنا الحديث. وربّما غدونا كائنات لا ترى في السلم غير فاصل هشّ بين حربَين، ليس لأنّنا نهوى القتال، بل لأنّ قسوة العيش في هذه المنطقة من العالم علّمتنا أن نقسوَ على أنفسنا، لنكون دوماً مُستعدِّين للأسوأ الذي لا قدرة لنا على تجنّبه. لقد ألفنا هذه القسوة، وألفنا العنف أيضاً– عنف الحروب المتفجّر، وعنف السلم المتغلغل في كلّ بنى مجتمعاتنا– حتّى صرنا نهضم الحروب بأسهل ممّا تفعله معظم الشعوب.
لا يعني هذا أنّنا لا نتأثّر بالحروب، بل أنّنا تأثَّرنا بها مراراً وتكراراً في الماضي، حتّى باتت كلّ حرب جديدة لا تترك فينا سوى أثر طفيف نسبيّاً. ونحن في هذا نشبه طفلاً مُعنَّفاً لم يعرف يوماً من والدَيه سوى الضرب المبرح. لا شكّ في أنّ الضرب اليوميّ ترك في هذا الطفل تصدّعات نفسيّة وروحيّة قد لا تُشفى أبداً، لكن ما يعنيه هذا أيضاً أنّ كلّ تعنيف جديد يتعرّض له لا يكاد يترك أثراً يُذكر مقارنة بآثارِ سنوات التعنيف التي عاشها.
ومثل هذا الطفل الذي يجهل سببَ تعنيفه ولا يعرف سبيلاً لإيقاف الضربات، نشعر نحن أيضاً بالعجز: عجز عن فهم غايات هذه الحروب وأهدافها، وعن الحؤول دون تكرارها. إنّها قدرٌ محتوم يجب التسليم به، إنّها أحد الأسس التي تُشكِّل هويتنا الجماعيّة، إنّها جزء لا يتجزّأ من عالمنا، نحن سكّان هذه المنطقة التي لَطّخت أرواحَنا بقسوتها.