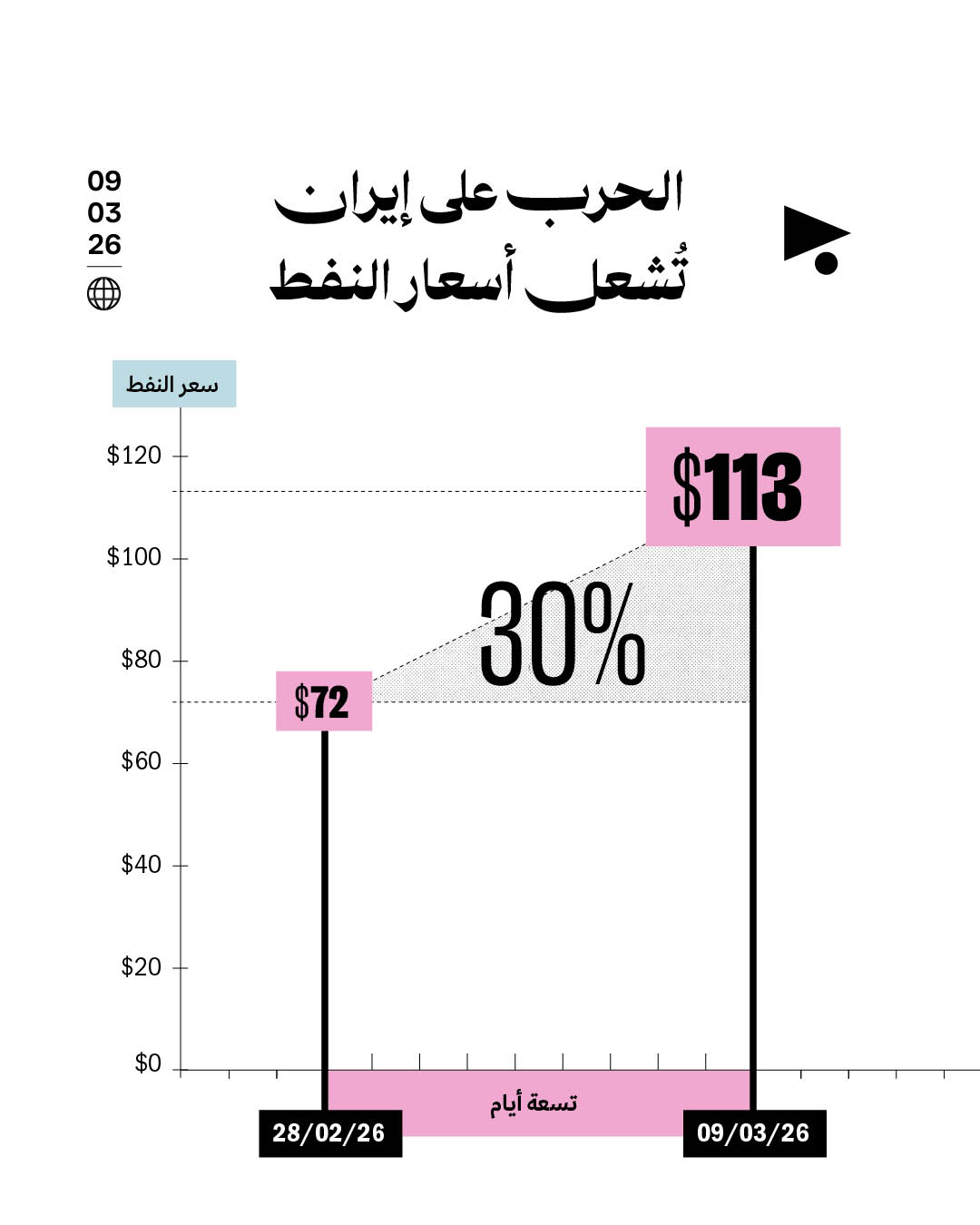طعمة جبن حامضة في فمي، رائحة عفن تفوح من جسدي. عشر سنوات مرّت، حاولت خلالها اختزال المعتقل بكونه رائحةً وطعمًا. أمّا الألم النفسي والجسدي، فكما قال لي المعالج النفسي مرّةً، عليَّ التصالح معهما وتجاوزهما. لا أعرف حتى الآن كيف يمكن للإنسان التصالح مع مضمون الإهانة والذلّ. فكرة التقبُّل للناجين من معتقلات نظام الأسد تظهر بمجرد خروجهم أحياءً من المعتقل؛ جملة مثل «انكتب لك عمر جديد» تجعل من النجاة فعل ولادة. كل الذين وُلِدوا مثلي ثانيةً يعلمون أنّ هذا العمر الجديد الذي انكتب هو عمر مَوْتُور، والرجل المَوْتُور هو من قُتِل له قريب ولا قدرة له على أخذ ثأره. يُعتبَر الثأر أوّل خطوة لتفكيك العلاقة مع المعتقل، خطوة مبنيّة على غموض تشوبه الأسئلة.
استطاع نظام الأسد بناء قبضته الأمنية من خلال طمس معالم المصير. وهذا لا يتّضح فقط في البنية الاقتصادية والربحية التي جمعها نظام الأسد من محاولات طرح الأسئلة من ذوي المعتقلين، والتي وصلت إلى 900 مليون دولار، بل يشمل أيضًا علاقة جسد الموقوف مع نفسه ومع البيئة المكانية داخل المعتقل، حيث يتحوّل الجسد إلى كتلة خارج الزمان والمكان، محكومة بالعتمة والصمت. جسد لا يرى ولا يجب أن يشعر بأنه قد يُرى، ليشعر دائمًا بأنه قابل للانتهاك والتفتيت، ليكون باستمرار مسلوبًا من ماضيه، في برزخ لا شكل له خارج إطار التعذيب.

هذا الممرّ ضمن فرع الأمن السياسي في دمشق، اكتشفته مثلكم لأول مرة على الرغم من اعتقالي لشهرين تقريبًا في الزنزانة الثانية من جهة اليسار. ثلاث خطوات كبيرة ومسرعة نحو اليمين، توجد غرفة «الشَّبْح» بعد بلاطة موشحة ببقعة سوداء كبيرة ودائرية، ضمن موزع ممرات آخر لا أعرف كيف أو أين قد ينتهي. هكذا عرفت المعتقل، اكتشفته بعد الخطوات والبقع السوداء على البلاطات الممحوّة، وأنا أعبرها مُطَمَّش/مُعَصَّب العينين، محنيّ الظهر، عيناي تختلسان النظر نحو البلاطات وهي تعدّها.
ليس من السهل تكثيف بيئة المعتقل بكلّ هذا الوضوح الذي تُظهره الصورة اليوم. لم أتخيّل كلّ هذا التبسيط للممرّ وأبواب الزنازين المفتوحة على مصراعيها، لتتجاوز صور المعتقلات، وهي فارغة، الحدس لدى المعتقلين، إذ تعيد اكتشاف علاقة أكثر تعقيدًا ضمن محاولات ترجمة التجربة عبر الصور. وهذا يختلف عن الشارع، عن نقاط الحواجز والتفتيش، أو الأبنية الحكومية. إنها صور لمكان لا نعرفه ولم نكن نجرؤ على النظر إليه من الخارج، ولكننا اختبرنا قسوة المرور من خلاله. أضع الصورة أمامي في محاولة لتفكيك المكان وإعادة تجميعه مجددًا، وكأن الصورة وسيلة لتوثيق التجربة أو رفضها. وفي الحالتين، تكون الصور التي التُقطت للمعتقلات من الداخل شيئًا يتجاوز الذاكرة؛ لأن الصور لا تستعيد ما حدث في المعتقل فقط، بل تُظهر الفراغ الذي تركه عناصر النظام بعد هروبهم من المكان.

أن يفقد الإنسان إدراكه لنفسه لا يحدث فقط بتراكم جولات التعذيب، بل أيضًا بنزع الصفة الإنسانية عنه. في المعتقل، أنت شيء، وهذا الشيء الذي صرت إليه قابل للانتهاك والتعرية. في الزاوية اليمنى من هذه الصورة، تمّت تعريتي تمامًا لحظة دخولي إلى المعتقل. طُلب مني أن أخلع ثيابي كلها. كانت قطع الثياب تنهال واحدة تلو الأخرى، وعندما أصبحت عاريًا تمامًا أمام الحارسين، طلبا مني النزول والصعود أكثر من مرة بوضعية القرفصاء «للتأكد أنّي لا أخفي أي شيء داخل جسدي». وحين وقفت لآخر مرة، اقترب مني أحد الحراس وفاجأني بركلة قوية على خصيتي. سقطت أرضاً وأنا أحتضن كلّ مواضع الألم، ليتمّ جرّي إلى الزنزانة، حيث انتميت إلى كتلة أجساد أكبر.
على كل حال، الوحشيّة في الصورة لا تكمن فقط في هذا الانتهاك القاسي للأجساد، بل في التناقض: من يملك براءة الاعتناء بالنباتات الخضراء الموجودة على يمين الصورة هو ذاته من يقف وراء البقع الرمادية الداكنة الناتجة عن «الشَّبْح» المستمر للمعتقلين. أدوات تعليق أجساد المعتقلين، التي لا تترك أقدامهم تلامس الأرض، واضحة في صدر الصورة. لا تترك هذه التفاصيل مجالًا للتفكير بالمساحات الفارغة في الصورة، حيث يبدو كل شيء هناك كثيفًا وضيّقًا، ولا يتعدّى مدى إحساسك بإطلاق تنهيدة واحدة إضافية.

في هذه الصورة، يبدو الموت كشيء بعيد وضائع. ضياع الموت هنا جزء أساسي من المشهد، إذ تبدو جميع احتمالاته حاضرة، إلا أن إيجاده يبدو مستحيلًا. حتى اليوم، لا أملك تصوّرًا هندسيًا لغرفة التعذيب، إلا أن الظلام الدامس على يمين الصورة يذكرني بشيء أعمق من الألم. بعد أربع ساعات من التعذيب و«الشبح»، يصير الموت عذبًا. فكرة أن تحتضنه برقة وتختفي معه تنطوي على جسارة تكفي لتجاوز الألم. وهذا ليس تجميلًا للموت، بل تكثيف لمضمون النجاة، خاصةً عندما تصل إلى الساعة العاشرة وأنت لا تعرف متى ستنتهي دورة الألم. كأنما الحياة فكرة قديمة وبالية، غير صالحة للاستخدام مجددًا. وكل ما يمكنك التفكير به هو خدر جسدك وهو يتمدّد. لطالما تخيّلتُ في غرفة التعذيب أنّ المكان ضيّق وكأنّ جسدي بات أكبر منّي، خاصّةً أنّني لا أرى وجه مَن يعذّبني، ولا أعرف من هم أولئك الذين يسمعون صوت صراخي. إلا أنني، بالصراخ، عرفت أن التعبير الأقسى للوحشية يكمن في المجهول: أن تترك الإنسان يواجه مصيره في العتمة من دون أن يعرف من أي جهة قد تأتيه الصفعة القادمة.
بعد يومين من «الشبح»، رأيت أبي وهو يحاول إنزالي من على الجدار. كان مطمئنًّا حنونًا، احتضنني بعد أن فكّ أصفاد يديّ، وطلب مني أن أتبعه للخروج من المعتقل. رأيت غابة كثيفة بشجر عالٍ. كنت أركض فيها ليلًا بينما الحراس يطاردونني كظلال كثيرة. رأيت بيتي، وجدتي، وأخي. وبين كل رؤيا وأخرى، كان دلو الماء البارد يأخذني إلى عالم جديد.
صورة الجسد المتدلّي التي يمكن تخيلها في الصورة لا تكفي، لأن رؤية الجسد بعيون السجان لا تشبه علاقة الموقوف مع اللحظة التي يصير فيها الجسد عبئًا ثقيلًا على صاحبه. أما المساحة الوحيدة التي يمكن الإيمان بها في الصورة، فتتمثّل في اللاوعي، في الهلوسة التي يتركها العقل الباطن كملامح أولية وضبابية. هناك تكمن الصورة الحقيقية، في ما حاول الخيال استعادته من شدّة الوهن.
أخيرًا، حاولت الكاميرات استعادة السردية، لكنها استغلتها. مئات الصور والتقارير حول معتقلات نظام الأسد انتشرت، لكن رؤيتنا لتلك الصور واحتفاظنا بها لا يعني أننا استعدنا الوسيط الذي يمكن من خلاله تفكيك مفهوم الوحشية، خاصة أن المعتقلات لا تزال قائمة، ما دامت هناك آلاف الحالات من المخفيين والمغيبين قسرًا. كأنّ كسر رهبة صور المعتقلات يتحقّق فقط من خلال المحاسبة العادلة للمتورّطين. هذا هو جزء من كل صورة نراها اليوم، حيث النهاية لا تكمن في مجرد استعادة المعتقلات بصريًّا، بل في محاولة تفكيك أدواتها وآلية عملها، للوصول إلى إجابات شاملة لطالما حُرمنا من معرفتها.