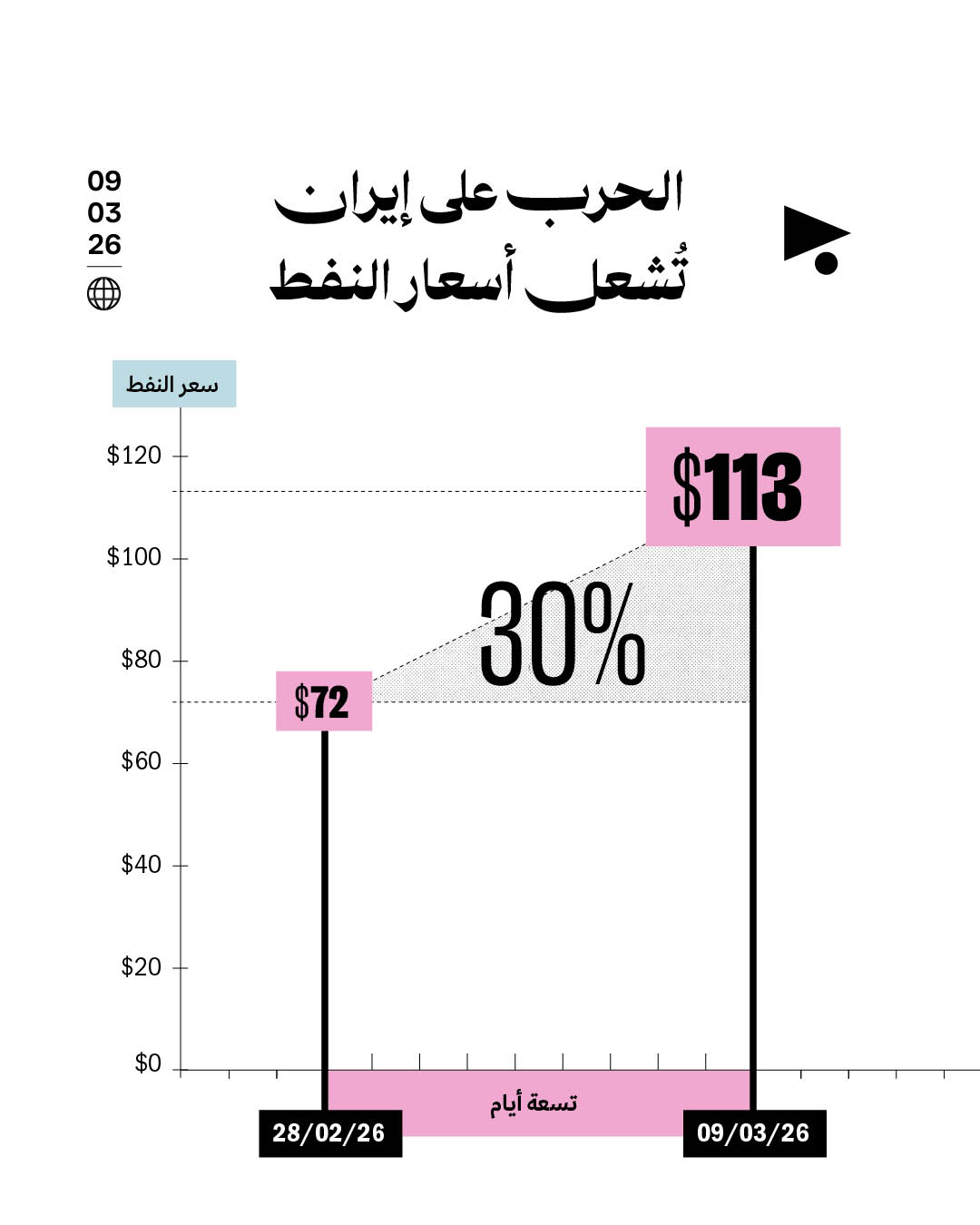لبنان من دون آل الأسد
يشكّل حدث سقوط الأسد نقطة مفصلية ليس في تاريخ سوريا وحسب، بل في المنطقة ككلّ. فقد كان لحكم الأسد انعكاسات تفوق حدوده، خاصّةً في لبنان الذي تداخل تاريخه السياسي مع تاريخ حكم الأسد منذ بدايته. فمن السنوات الأولى للحرب ودخول قوّات «الردع» إلى لبنان، مروراً بـ«عهد الوصاية» الذي دام 15 سنة ومسلسل الاغتيالات والمجازر الذي رافق هذه العلاقة، وصولًا إلى «الثورة السورية»، لا يمكن فصل السياسة في لبنان في آخر نصف قرن عن السياسة في سوريا.
لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، بات هناك إمكانية لسياسة خارج شبح حزب البعث، مع ما يتطلّبه ذلك من مراجعات ومحاسبة ذاتيّة في لبنان.
انطلاقًا من هذه العلاقة الحميمة بين النظامَيْن، لا بدّ، بعد الاحتفال بسقوط الأسد، من لحظة محاسبة داخلية، تبدأ من تخاذل النظام اللبناني مع حكم الأسد والعنصرية الجامعة تجاه السوريين، كمدخل لإعادة ابتكار سياسة تحرّرية تنطلق من أفق أرحب، يلحظ ترابط المصالح والتحدّيات بين الشعوب خارج نظريات الوحدة والانصهار والسيطرة.
النظام اللبناني صنيعة النظام السوري
رغم الفروقات الجوهرية بين النظامَيْن، تحوّل النظام اللبناني بعد الحرب الأهلية إلى إحدى أذرع النظام البعثي، تحت سيطرة مسؤولي الأجهزة الاستخباراتية السورية. تخرّجت أكثرية الطبقة السياسية الحالية من مرحلة التبعية هذه، وشكّلت على مدار السنوات سندًا لسياسات الأسد. فنجح حكم البعث في تحويل لبنان وممثّليه السياسيّين إلى امتداد لشبكات نفوذ البعث وسجونه، ولم تسلم أي مؤسسة من هذا التآكل البعثي لمعناها.
لم تتحوّل هذه العلاقة جوهريًا مع صعود الاعتراض الداخلي ضد حكم الأسد، بدءاً من عام 2005. فقد تبرّع طرف إلى «شكر سوريا» وحافظ على نفوذها تحت دواعي مقاومة. تحوّل هذا الشكر إلى مشاركة في الحرب السورية ابتداءً من عام 2012، مع تدخّل حزب الله إلى جانب النظام، والتضحية بالآلاف من شبابه بغية الحفاظ عليه.
أما سياسات الحكومات المتعاقبة حيال النزوح السوري، بعد عام 2015، فشكّلت امتدادًا لسياسات دمشق، مع تَبَنٍّ رسميّ ضمنيّ لنظريات النظام حيال النازحين. فقبل أن يسقط الأسد وتبدأ موجة استنكار سجونه، كانت الحكومة اللبنانية تحاول فرض عودة قسريّة للنازحين، وكانت القوى الأمنية تطاردهم والبلديات تمنعهم من التجوّل. وما زال هذا التواطؤ قائمًا بعد سقوط الأسد، مع الكلام المتزايد عن استضافة بعض المطلوبين لجرائم حرب وحمايتهم من المحاسبة.
والآن وبعد سقوط الأسد، والبدء بعملية المحاسبة والمصالحة والانتقال السياسي في سوريا، علينا الاعتراف بمسؤولية نظامنا اللبناني في تدعيم حكم الأسد واستمرار حكمه الدموي لأكثر من 13 سنة، بعد انطلاق الثورة.
العنصريّة الجامعة
ما سمح بتماهي النظام اللبناني مع النظام السوري في المرحلة الأخيرة، رغم الخلافات السياسية، هو العنصرية الجامعة حيال النازحين السوريين، والتي تخطّت خطوط التماس السياسية لتصبح نقطة وفاق وطني. لم تكن أزمة النزوح مسؤولية النازحين كما يريد النظام وأتباعه من الإعلاميين تصويرها، بل مسؤولية النظامين السوري واللبناني، اللذين أنتجا وساهما في استمرار حكم الأسد وقمعه.
فمن دعم حزب الله للأسد، والذي أدّى إلى إطالة الحرب، إلى تماهي الحكومات مع خطاب العودة القسرية للنازحين، وصولًا إلى تحويل لبنان إلى ما يشبه السجن لمئات الآلاف من النازحين، كانت العنصرية الصفة المشتركة لأكثرية القوى السياسية، عنصرية كانت تنفجر دوريًا بحفلات من العنف ضدّ السوريين.
يمكن لمحطة كالـ«أم. تي. في»، والقوى السياسية التي تمثّلها، أن تحتفل بسقوط الأسد وتفتح «الشامبانيا» وتوزّع «البقلاوة» وتطلق «المفرقعات» ابتهاجًا بالثورة الشعبية التي أطاحت بالديكتاتور. لكنّ هذه المحطة كانت رائدة على مدار السنوات الأخيرة ببثّ أقبح خطابات العنصرية تجاه السوريين، وكرّست نفسها لمحاربة خطر «اللجوء». كان هناك من يحب «الثورة السورية» لكنّه يكره السوريين، كما كان بالماضي هناك من يدعم القضية الفلسطينية لكنّه يكره الفلسطينيين.
في لحظة انهيار الأسد، لا بدّ من التذكير بأنّ العنصرية تجاه الشعب السوري هي من ميزات هذا النظام القمعي، ومن تماهى مع هذه العنصرية، عليه مراجعة ذاته قبل فتح الشمبانيا.
الممانعة القاتلة
لم تكن العنصرية الخطاب الوحيد الذي ساهم في إسكات السوريين على مدار السنوات الأخيرة. ثمّة خطاب آخر برّر قمعهم بإسم القضية الفلسطينية، ليحوّل مآسيهم إلى ثمن مقبول دفاعًا عن «أنظمة الممانعة». فكان الدفاع عن نظام الأسد مختلفًا عن سائر الأنظمة العربية، إذ جاء مدعومًا بـ«شرعية المقاومة»، رغم تاريخ آل الأسد المعادي للقوى السياسية الفلسطينية وقمعه لها ومهادنته للعدو الإسرائيلي. فأن يدمّر الجيش الإسرائيلي القدرات الجويّة والبحرية والصاروخية للجيش السوري في لحظة سقوط الأسد ليس إلّا دليلًا على أنّ وجود الأسد كان ضمانة لإسرائيل بأنّ هذه القدرات لن تُستعمَل ضدّها.
لم تكن شبكة دفاع آل الأسد مجرّد أنظمة وميليشيات، بل أيضًا شبكة من المثقفين والإعلاميين والقوى اليسارية حول العالم، رأت في الأسد «مقاومًا» و«رأس حربة في مواجهة الإمبرياليّة العالميّة»، وكرّست قدراتها على مدار السنوات الأخيرة لتكذيب كل التقارير عن القمع والبطش والقتل. هذا التكذيب لم يكن هامشيًا، بل قدّم الشرط الضروري لعملية «نسيان» سوريا لإطلاق يد الأسد في قمع شعبه.
ربّما كان حزب الله الطرف السياسي الأكثر استعمالًا لهذا الخطاب «الممانع»، بالإضافة إلى المشاركة بتطييف النزاع. وبقي الحزب يُكابر على وقائع القتل والتعذيب، بالإضافة إلى المشاركة بها في بعض الأحيان. وما زال الحزب نفسه يُكابر على هذه الوقائع وعلى دوره فيها، في تعاطيه مع نتائج الحرب الأخيرة.
في لحظة سقوط الممانعة ومقاربتها لمفهوم مقاومة إسرائيل، حان الوقت لمواجهة هذا الخطاب ودوره في تبرير الأنظمة القمعية التي شكّل النظام الأسدي أحد أسوأ تجلّياتها.
أُفُق سياسيّ جديد
للعديد ممّن عايش حُكم الأسد في لبنان، يأتي سقوطه كفرصة للدفع بسياسة لبنانية مستقلّة عن التطورات عند الجار الكبير. ولمن عانى من التدخلات السورية، يبدو هذا مفهومًا. ولا بدّ أنّه بعد عقود من أطماع نظام الأسد الإقليمية وسيطرته على الساحة اللبنانية، هناك حاجة لإعادة بعض التوازن في العلاقة بين الحقلَيْن السياسيَّيْن.
لكنّ هذه اللفتة إلى الداخل اللبناني بعد سنوات من النظر إلى دمشق لتلقّي التوجيهات، لا تنفي الترابط بين المجتمعات والتحدّيات المشتركة والحاجة إلى «تكاتف» ديمقراطي عابر الحدود. فلا يمكن لنظام ديمقراطي أن يستمرّ في محيط غير ديموقراطي، كما لا يمكن مواجهة عدد من التحديًات خارج بعض التضامن والتنسيق والتكاتف.
سقوط الأسد يفتح المجال لسياسة ذات أفق أوسع من حدودنا الوطنية، سياسة تبتعد عن أي رغبة وحدويّة أو محاولات انصهارية أو مشاريع سيطرة، سياسة مشتركة لا تقوم على التنسيق الأمني بين أنظمة، بل على التطلعات المشتركة بين الشعوب ومصالحهم المتقاطعة ومخاوفهم المشروعة. بين لبنان وسوريا، ولكن فلسطين أيضًا، ثمّة روابط وتطلّعات مشتركة، لا ينبغي التخلّي عنها مع سقوط أنظمة ومحاور حوّلت «المشترك» إلى قنوات لهيمنة أحادية.
انهيار نظام البعث فرصة لإعادة فتح الأفق السياسي نحو تطلّعات سياسية مشتركة وديمقراطية وتعددية، كان حكم الأسد قد قمعها في سجونه القُطرية.
الثورة السوريّة، لبنانيّاً
قد يبدو هذا الكلام طوبويًا للبعض، لكنّ هناك تجربة عن هذا التشارك الديمقراطي العابر للحدود، والبعيد كل البعد عن نظريات الوحدة والانصهار، وهو تجربة «الثورة السورية» في لبنان. فقد شكّل هذا الحدث «غير اللبناني» للعديد من الأجيال الذين عايشوه نقطة تحوّل في وعيهم السياسي، أجبرتهم على الكسر مع العديد من الموروثات السياسية. فباتت «الثورة السورية» حدثًا لبنانيًا، وفتحت أفقًا جديدًا لكثيرين، بعيدًا عن خطوط التماس المحلية.
لم يكن هذا نتيجة لنزوح فكرة الثورة إلى لبنان وحسب، بل أيضًا لنزوح الآلاف ممّن حملوها، ووجدوا في بيروت ملاذًا آمنًا، قبل أن تتحوّل إلى سجن مسيَّج بحيطان العنصرية. انخرط هؤلاء بحياة مدينتهم الجديدة، بنوا علاقات اجتماعية، أغنوا من استقبلهم، وشكّلوا الردّ الأكثر فعالية لسنوات الاحتلال البعثي. والأهم، ساندونا في صراعاتنا مع نظامنا وشاركوا في ثورتنا، «ثورتنا» أو «ثورتهم»، حتى اختلطت الثورات ببعضها بعضاً. في لحظة بات الإجماع اللبناني يريد تحميل النزوح السوري مسؤولية كل مشاكل البلد، علينا الاعتراف أنّ هذا النزوح قدّم الكثير لمن عايشه.
«الثورة السورية، لبنانيًا» نموذج عن سياسة مشتركة، ذات تطلعات ديمقراطية، سمحت لكل من شارك بها أن يجد مسافة صغيرة من الودّ على تخوم هذين البلدين، تنقذنا من السجون المحلية والمشاريع الانصهارية، وتشكّل الرد الوحيد في وجه أي نظام، قديم أو مستجدّ.
لهؤلاء الذين أتوا يومًا إلى لبنان مع ثورتهم، كلّ الحب والامتنان.