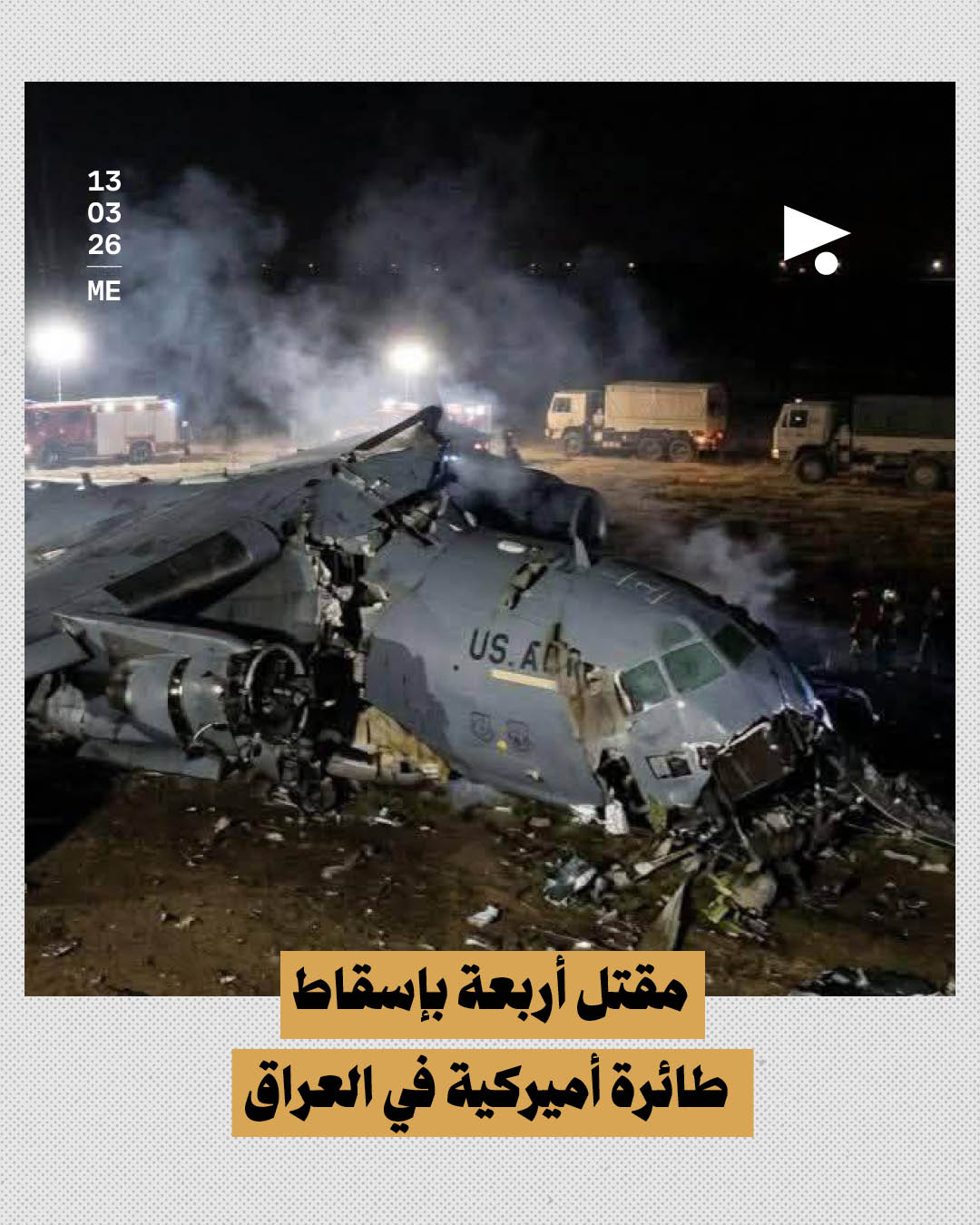على إثر جريمة القتل المروّعة في بعقلين يوم الثلاثاء، والتي أودت بحياة عشر ضحايا، منال حرفوش وستّة سوريّين (أربعة عمّال وطفلين) وثلاثة من اللبنانيّين، تسابق المسؤولون على الإدلاء بشهاداتهم. فرجّح رئيس البلدية عبد الله الغصيني أن يكون الجاني يمرّ بحالة عصبية نتيجة فقدانه لعمله وتردّي الأوضاع الاقتصادية في لبنان وظهور فيروس كورونا المستجدّ الذي زاد الطين بلّة، خصوصاً مع التزام الحجر المنزلي.
لقد قُتلت منال أوّلاً. وما دامت القتيلة من النساء، فإنّ أوّل ما علينا القيام به هو التفكير في ما يدور في ذهن قاتلهنّ الذي لا بدّ أنّه مركّب لدرجة تستحقّ التحرّي عنه لا عن ملابسات الجريمة.
قاتل النساء ثمين جدّاً ويستدعي اهتمامنا كلّنا. لذلك، سنتوقّف عنده هنا، تبعًا للقاعدة، وبدلًا من أن نفكّر في طبق بتري العامر بآفات بشرية وبنيوية، من ذكورية وعنصرية وتبرير للعنف والقتل والإفلات من العقاب وتفشّي الأسلحة، سوف نفكّر في الكورونا. هي أبقت الرجل في بيته، فزادت من همومه وعصبيّته. حرام. ثمّ سوف نُدعى إلى طقس تاريخيّ هو حفلة اللطم على مصير الرجل المسكين الذي لا بدّ أنّه يعيش حالة توتّر عصيبة دفعته إلى قتل امرأة وبضعة سوريّين، ع صحّة السلامة، ونمضي. آه. عذرًا. سبقني عبد الله الغصيني إلى التفكير في كلّ ذلك، فلم آتِ بجديد.
ثمّ جاء النائب مروان حمادة ليقول إنّ عدداً من الضحايا راحوا أبرياء، طبعاً ليست منال حرفوش بينهم.
تكفي الشائعات، ويكفي أن تكون إحدى الضحايا امرأة والباقون عمّالاً سوريّين لتتحرّك الخلايا الرماديّة في عقول المحلّلين، وتظهر الصورة واضحة: لا بدّ أنّها جريمة «شرف» أو «ثأر».
عمليّة حسابيّة بسيطة: رجلٌ يقتل امرأة، فهو يدافع عن «الشرف». منال، عاصي أو حرفوش، تبادليّا: تُقتَل النساء مرّتين، متى يُقتلْن، ومتى أُحيي «شرف» قاتليهنّ. وإن تخّت لغة القانون عن جرائم «الشرف»، فإنّها تحول دون عدالة فعليّة باعتبار «الشغف» عنصرًا مخفِّفًا للمسؤوليّة، كأنّها بلدغة فرنسيّة تحوّل الـ«ر» إلى «غ» وتتستّر على الجرائم نفسها: القتل.
أمّا لو كانت الجريمة «ثأرًا»، وهو الافتراض الآخر الذي وضعه حماده ليلة الجريمة، فالقاتل يثأر لنفسه من العمّال السوريّين، فيكون الأبرياء الذين قصدهم حمادة هم اللبنانيّين. علاوة على أنّ منطق الثأر القائم على العين بالعين قد قايض جرحًا مزعومًا في مشاعر المجرم بعمليّة قتل، فإنّه تجاوز قانون حمورابي لا كيفيّاً فحسب، بل كمّيّا أيضاً، فحصد تسعة أرواح. ذلك أنّ الحقد الذي وجّهه المجرم لم يستهدف شخصًا بعينه، إنّما أيّ شخص سوريّ اعترض طريقه. ذلك الحقد قديم، تغذّى من خطابات الدولة.
يعلم السياسيون والمسؤولون أنّهم وجّهوا الجريمة قبل أن تُولد في ذهن القاتل وتُنفَّذ بيده.
فسارعوا إلى طمأنتنا أنّهم سيقومون بدفن العمّال السوريّين، وأنّنا «إخوة». يعلمون أنّهم متواطئون، لأنّ المجرمين يفلتون من العقاب دائمًا، ويعرفون الجرائم المحصّنة التي لا يحاسَب عليها بل قد تبرَّر.
تنشر البلديات لافتات تستهدف السوريّين، «إخواننا»، لتلزمهم بترك المناطق، وتمنع عنهم الاستئجار، وتحبسهم يوميّا لساعات عديدة في ورشات البناء والغرف المرتجلة وأحياء التنك التي لا يغادرونها سوى للعمل، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للحجر الصحّي كوسيلةٍ للإقصاء. لأّنّ هذه هي الحاجة الوحيدة لهم في هذا البلد: العمل. ومتى استنفدوه، باتوا زائدين عن الحاجة. وإن تجرّأوا على أيّ فعل غيره، يعاقبون. لماذا يتجوّل سوريّ بعد الثامنة أو قبلها في قرية لبنانية ما؟ مريب.
أسئلة إنكاريّة سامّة تُطرح، تراهن على نشر الريبة ودغدغة الكره الباطنيّ للمستضعفين، ومعها أجوبتها الجاهزة: فلنخوِّن النساء والسوريّين والعمّال اليدويّين والمياومين. فلنبرّر قتلهم. ثمّ لا ننسى أن نكتب على قبورهم أنّنا إخوة.