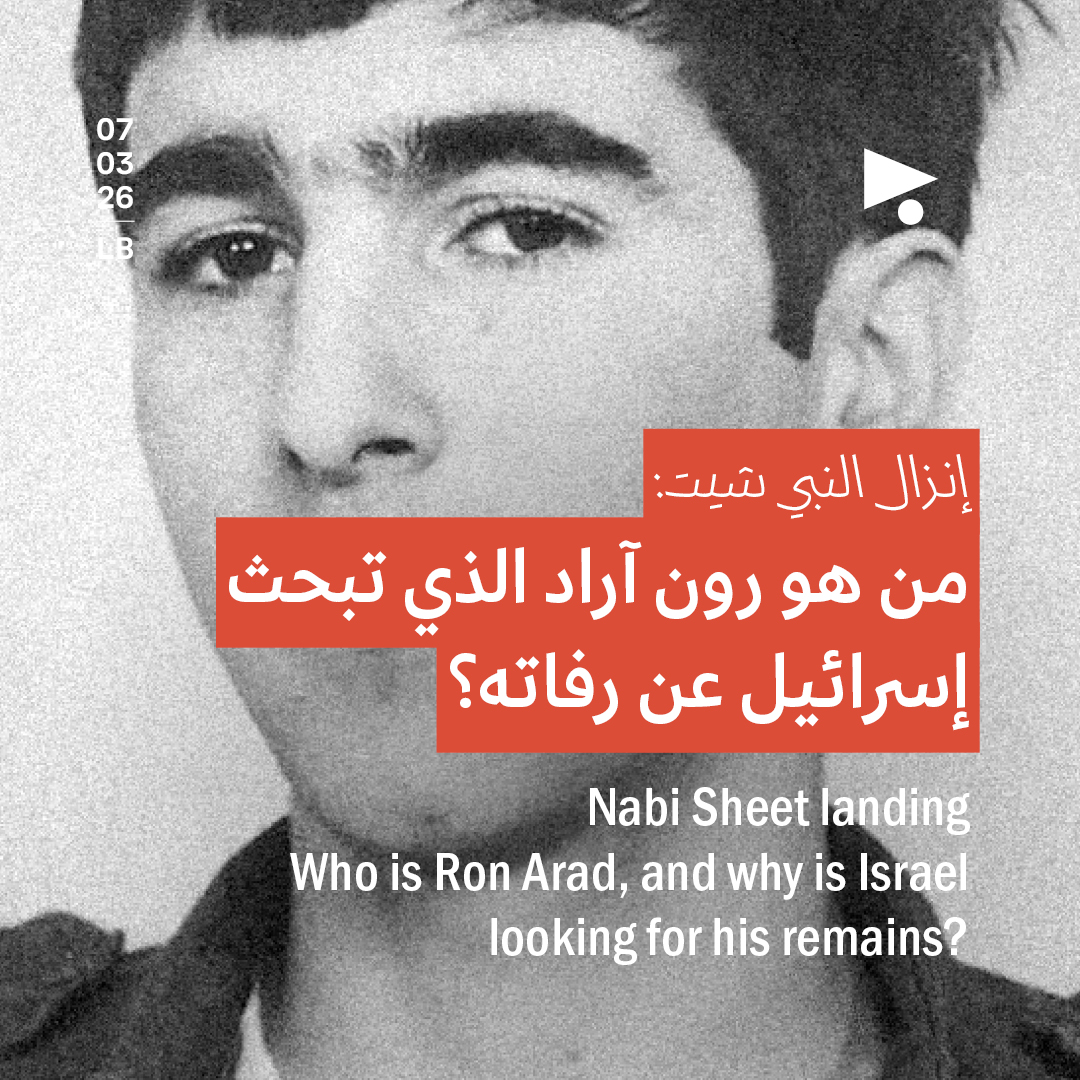كان ينبغي على هذا المقال أن يتناول فيلم جوكر. فعندما شاهدتُه قبل ثلاثة أسابيع، ذهلني بالرغم مِن عيوبه الكثيرة. عجزت بدايةً عن تصديق ما رأيته: فيلم تجاريّ هوليوودي يدعو إلى قتل الأغنياء، أو أقلّه يُوَلِّد رغبةَ قتلهم لدى المُشاهد. ولم أفهم كيف غفل معظم النّقاد عمّا رأيته أنا واضحاً ساطعاً وضوحَ الشمسِ وسطوعها، وهو أنّ هذا الفيلم يُدين النيوليبرالية والرأسمالية المُتوحشة على نحوٍ صريح ٍمُباشر، وإن بشيءٍ من التبسيطيّة تُشبه تلك التي كانت تتّسم بها البروباغندا الستالينيّة.
لكنّ بعض أصدقائي ممّن شاهدوا الفيلمَ لم يروا فيه بتاتاً ما رأيته أنا، فأخذْتُ أرتاب مِن نفسي، ولم أعد مدركاً ما إذا كانت قراءتي تلك صائبةً، أمّ سطحيّة وساذجة. لذا قصدت وزوجتي "أسواقَ بيروت" لمشاهدة الفيلم مرّة ثانية، مُرجئاً قرار الكتابة أم العدول عنها إلى ما بعد العرض.
غادرنا الصالة حوالي الساعة الثامنة، وكانت رُؤًى دمويّةٌ قد استحوذت على ذهني: وجدت نفسي مُتمنِّياً ظهورَ جوكرٍ لبناني يقود ثورةً غوغائيّةً، ويبقر خلالها بطون فاحشي الثراء، أولئك الذين لن يتأثّروا بالضرائب الاعتباطية التي كان اتُّخِذ القرار بفرضها قبل ساعات قليلة فقط. ومع ذلك، كنتُ لا أزال متردِّداً في كتابة المقال خشية أن يبدو تحليلي للفيلم شديد السذاجة.
خلال عودتنا مشياً إلى المنزل، أبصرتُ وزوجتي آليات عسكرية، وعناصر من مكافحة الشغب، وبعض المُتظاهرين، ولم نُدرِك ما الذي كان يحدث إلّا بعد وصولنا البيتَ واطّلاعنا على آخر الأنباء. كان ذلك في 17 تشرين الأوّل الجاري. وفي اليوم التالي، في المُظاهرة الممتدّة مِن ساحة رياض الصلح إلى ساحة الشهداء، وفيما كنتُ سائراً بين الحشود ولا أزال حائراً في أمري، لا أستطيع عقد العزم على الكتابة ولا على عدمها، لمحت مُتظاهراً وجهه مطليّ على نسق الجوكر، فاختلط الخيال بالواقع وسَقَطَ مقالي. سقط لأنّ هواماتي المُتعلقة بالفيلم، والتي رغبتُ في تقريبها قليلاً مِن الواقع عن طريق كتابتها، قدّ تحقّقت أمام عينيّ.
كان الأمر أشبه بمعجزة صغيرة. وفي اليوم التالي، أيّ نهار السبت، أيقنت أن ما يحصل في لبنان هو معجزة كبيرة كانت، قبل أسبوع واحد، عصيّة على الخيال. وذلك ليس لأنّ الناس خرجت مؤقّتاً عن طوائفها، ولا لأنها شتمت زعامات مُقدَّسة ومزَّقت صورها، ولا لأنها عبّرت، ساخطةً، عن برمها بنظام المحاصصة الطائفي المولِّد للنهب والفساد، ولا لأن المظاهرات لم تقتصر على العاصمة بلّ عمّت معظم أنحاء البلد. فالمعجزة الحقيقيّة هي أنّ الانتفاضة هذه غَلَبَ عليها طابعٌ طبقيّ. في جوهرها، هي بالتأكيد ليست انتفاضة بقايا الطبقة الوسطى (ومجتمعها المدني) على السلطة السياسية، وإنما انتفاضة الأكثر فقراً وتهميشاً على الطبقة الأوليغارشية التي تحكم لبنان. فالشيعيّ الذي يشتم نبيه ورندا برّي لا يشتمهما وحدهما فقط، بل يشتم أيضاً ما يرمزان إليه: فاحشي الثراء الذين تُخاط السياسات الاقتصادية على مقاسهم، وأغلبهم لم يَتَبوَّأ يوماً منصباً سياسيّاً.
لطالما شابَ شيءٌ مِن الالتباس علاقتي بالفكر اليساري: يجذبني عاطفيّاً، فأحاول، ذهنيا،ً أنّ أُنَفِّر نفسي منه (مُستعيناً أحياناً باشمئزازي مِن الصوابيّة السياسية). لكن، بعد يومَين أو ثلاثة مِن بدء هذه الانتفاضة، وجدتني أشعر وأفكّر تلقائيّاً كيساري، ومن دون أدنى امتعاضٍ مِن نفسي. وجدتني، أيضاً، أكنّ احتقاراً غريزيّاً لكلّ مَن يخشى على وجه الثورة الحضاري ويتبرّم من أعمال الشغب وقطع الطرقات وكثرة الشتائم وكثافة الدرّاجات الناريّة وانتشار مُدخِّني الآراكيل على الأرصفة؛ فمن يريد المُحافظة على هذا الوجه الحضاري إنّما يسعى، مِن غير دراية ربّما، إلى مصادرة الانتفاضة عبر مَحْو وجهها ليرسم مكانه وجهاً آخر هو وجه الطبقة الوسطى التي ينتمي إليها. وأخيراً، وجدتني أفكِّر أن هذه الانتفاضة قد تصبح ثورة فقط في حال بقي طابعها الطبقي هو الغالب.